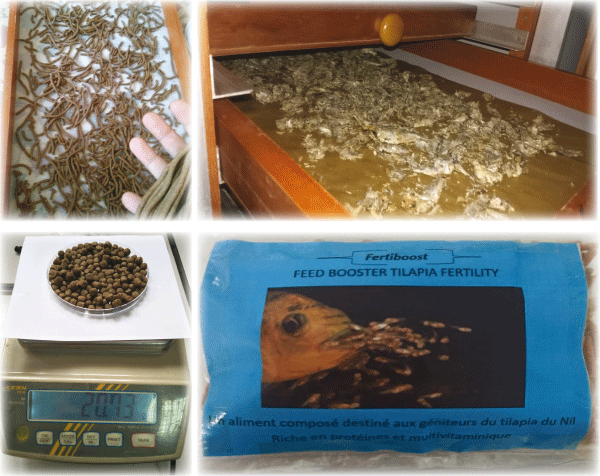
* تحصلنا على نتائج إيجابية تسمح باستبدال المواد المستوردة
أنشأت أستاذة وباحثة بالمركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات قاعدة بيانات بالمواد المحلية التي يمكن استعمالها في إنتاج أعلاف الأسماك، ضمن مشروع يتم العمل فيه كذلك على تثمين مواد مختلفة لتشكيل تركيبات أعلاف لمختلف مراحل نمو الأسماك، إذ تؤكد للنّصر على أهمية الاهتمام بصناعة الأعلاف عبر مواد متوفرة محليا لاستدامتها وتعزيز نجاح مشاريع الاستزراع السمكي.

وتعمل الأستاذة والمختصة في علوم البيئة المائية وتربية المائيات، فايزة عليوش، على مشروع بحثي يخص استخدام التقنيات الحيوية الغذائية في إنتاج الأعلاف، حيث ذكرت في حديث لها مع النّصر أنّه يتم بالاعتماد على تثمين المنتجات الزراعية والمائية ومخلفاتها وتأثيرها على نمو، صحة وجودة الأسماك المستزرعة، سواء أسماك المياه العذبة كالبلطي، القرموط والشبوط، أو الأخرى البحرية على غرار سمك الدنيس والقاروص، اللذان يعدّان أهم الأسماك البحرية المستزرعة بالجزائر، بالإضافة إلى تشكيل تركيبات أعلاف لمختلف مراحل نمو السمك بمراعاة الاحتياجات الغذائية لكل مرحل ونوع سمكي.
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ المشروع كذلك في جزء ثان منه يتضمّن إنشاء قاعدة بيانات لمختلف المواد المتوفرة محليا ودراسة تأثيرها على الأسماك، بغية إنشاء برنامج خاص بتشكيل الأعلاف الخاصة بهذه الأخيرة، على اعتبار تضيف، عليوش، أنّ لكل مرحلة استزراع احتياجاتها وأهدافها، ففيما يخص أمهات الأسماك على سبيل المثال تم القيام بالتركيز على تحسين الخصوبة وتوفير أعلاف تساعد على تقوية وتعزيز مناعة الأسماك في هذه المرحلة، بينما عند التسمين وما قبلها تمّ التركيز على صحة الأسماك ونموّها وكذا الاحتياجات من البروتين، أما فيما يتعلّق بمرحلة اليرقات فكان التركيز على تحسين حالتها لتكون دون عاهة وتسريع نموّها، كما يُهتم في كل من هذه المراحل بتأثير الأعلاف على جودة المياه.
وتقول ذات المتحدّثة إنّ عدّة نتائج إيجابية تمّ الحصول عليها، بحيث مكّنت من استبدال المواد المستوردة بأخرى متوفرة محليا، إذ تعد المستوردة مرتفعة الثمن وقد يتأخر استلامها، ما يؤثر على تغذية الأسماك وانخفاض نوعيتها خاصة من ناحية الفيتامينات، بالأخص استبدال مسحوق السمك الذي أصبح موضوع بحث يشغل الباحثين دوليا، سواء كانت مصادر للبروتين حيوانية أو نباتية، إذ هناك من منع تصدير مسحوق السمك واستيراده لأسباب صحية في جائحة جنون البقر ما ألزم التفكير في حلول بديلة خاصة وأنّ البروتينات من أهم الجزيئات في غذاء السمك.كما أنّ للنتائج إيجابيات أخرى تتمثل في ضمان استمرارية ونجاح مشروع الاستزراع السمكي بضمان توفّر المواد وعليه توفّر الأعلاف على مدار السنة، التخفيف من الاستيراد وتشجيع الاستثمار في هذا المجال وعليه تحقيق الاكتفاء الذاتي، فوائد أخرى تخص الجانب البيئي من خلال استخدام مخلفات مصانع تعليب الأسماك لتصنيع مسحوق السمك ما يؤدي إلى الحفاظ على البيئة البحرية، على اعتبار أنّ هذه المصانع تواجه مشكلة في التخلص من هذه المخلفات وتدفع ضرائب للقضاء عليها ورميها في البحر.
الاستزراع السمكي مصدر الإنتاج
وتحدّثت، عليوش، عن إقرار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في آخر إحصائياتها لسنة 2024 عن تفوّق الاستزراع السمكي في إنتاج الحيوانات المائية مقارنة بالصيد الطبيعي، لأول مرة في التاريخ بنسبة 51 بالمائة، ما يعني أنّ الاستزراع السمكي أصبح المصدر العالمي لإنتاج الأسماك، كما يحافظ على الثروة الطبيعية والتوازن البيوحيوي، غير أنّه يواجه تحديات تتعلّق خصوصا بصناعة الأعلاف، التي تمثّل نسبة ما بين 50 و80 بالمائة من تكاليف مشاريع الاستزراع السمكي بحسب خبراء في القطاع، استنادا لنوع السمك ونظام الاستزراع المتبع.
فأسماك المياه العذبة كمثال احتياجاتها الغذائية أقل مقارنة بالأسماك البحرية وعليه تكاليف أعلاف أقل، كذلك أسعار أعلاف اليرقات أغلى من الخاصة بالأصبعيات، وكلها ترتبط بتركيبة الأعلاف بالأخص من البروتينات الحيوانية، إذ لها علاقة وطيدة باستخدام مسحوق الأسماك الذي أصبح يشكّل عائقا أمام مصانع صناعة الأعلاف، زيادة على الآلات المستخدمة في صناعتها التي تؤثر على خاصية الطفو (العلف الطافي والغاطس)، وعليه فالأعلاف دورها مهم في إنجاح الاستزراع السمكي بتوفير تركيبات بجودة تلبي احتياجات الأسماك حسب مرحلة النمو، باستخدام مواد محلية تضمن استدامة المشروع. وتؤثر الأعلاف أيضا على جودة المياه مثلما قالت، وبالتالي على صحة الأسماك، عبر خصائصها الفيزيائية ونوعيتها الميكروبيولوجية، إذ أنّ الأعلاف غير المتينة والثابتة تتحلل بسرعة فلا تستفيد منها الأسماك، كما تلوّث المياه فينجر عن ذلك خسائر سمكية وفي المياه ما يرفع من تكاليف المشروع، ذات الأمر للأعلاف التي لم تصنع وفق معايير جودة ميكروبيولوجية، حيث تؤدي إلى نفوق الأسماك وإلزامية إفراغ الأحواض وتجديدها واستخدام مضادات حيوية. وعملت، عليوش، خلال سنوات سابقة على استخدام نبات «الكينوا» في أعلاف الأسماك، باعتباره محصولا استراتيجيا متعدّد الاستخدامات والفوائد وقيمته الغذائية عالية، إذ تحوز النبتة على نسبة عالية من البروتين، الفيتامينات، الأملاح المعدنية والأحماض الأمينية، غنية كذلك بالدهون على غرار أوميقا 3 و6 وتساعد على هضم الأعلاف بشكل جيّد، فضلا على تحمله الجفاف والملوحة، حيث اهتمت بالتعريف بالنبتة والعمل على تثمين مخلفاتها وأيضا دراسة مدى تأثير مادة «الصابونين» على صحة الأسماك.
ولفتت المتحدّثة إلى أنّ الأعلاف المصنعة من نبات «الكينوا» كانت منافسة لنظيرتها المصنعة من مسحوق السمك، كما لم تؤثر سلبا على صحة الأسماك، والملاحظ هو زيادة الخصوبة عندها والنمو بشكل متجانس، مع ذلك توصي، عليوش، باستخدام نبات «الكينوا» كمضاف للأعلاف على اعتبار سعره الباهظ، كذلك عدم وجود فائض في إنتاجه لتفادي منافسة الاستهلاك البشري الموجّه بالأخص لمرضى «السيلياك»، أما بالنسبة لاستخدام مخلفات النبتة فساهم في تقليص سعر العلف من خلال تثمين مخلفاتها في أعلاف البلطي حيث تباع بأسعار رمزية.
من الضروري تشجيع السوق المحلي
وتهدف المختصة إلى العمل مع الشريك الاقتصادي لدراسة جودة الأعلاف المصنعة وتقديم حلول لتحسينها، ذلك أنّ الاهتمام بمجالها ضروري لمشاريع الاستزراع السمكي، إذ يرتبط بوفرة الأعلاف واستدامتها، فجائحة «كورونا» أثرت على قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بحيث كان من الضروري تشجيع السوق المحلي لصناعة الأعلاف واستخدام مواد محلية ذات قيمة غذائية عالية وأسعار مقبولة، غير أنّ مصانع الأعلاف محدودة على المستوى الوطني. وترى ذات المتحدّثة أنّ الجزائر تزخر بثروات طبيعية وبدائل للمواد المستخدمة على الصعيد الدولي، وتثمينها في المجال يساهم في تطوير إنتاجها وتحقيق الاقتصاد الدائري، سواء موارد مائية وزراعية وأيضا نباتات مائية كـ»الأزولا» وعدس الماء اللذان يستخدمان كأعلاف للدواجن والماشية، إذ أعطت نتائج استخدام هذين المادتين نتائج جيدة فيما يخص تحسين جودة المياه، إذ تقوم باستغلال المواد الأزوتية الناتجة عن بقايا الأعلاف في الماء ومخلفات الأسماك كمواد غذائية لنموها، فيما استخدمت النبتتان في تركيبات أعلاف كمصادر للبروتين النباتي وكذلك كخام، لكن لم تعطيان نتائج جيدة، لذلك توصي، عليوش، باستخدامهما كمضافات، وتشجّع على استغلال وزراعة الطحالب بشكليها الدقيقة والكبيرة، كما تؤكد الحرص على تفادي استخدام المضادات الحيوية والمضافات الاصطناعية.وعرّجت، عليوش، للحديث عن الأسماك في المياه العذبة، قائلة إن تربيتها في الجزائر يرفع من نسبة استهلاك الأسماك، كذلك الحد من استغلال الثروات البحرية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كما نوّهت بفوائدها وقيمها الغذائية، حيث تنافس أحسن الأسماك استزراعا، فضلا على الحفاظ عن الأسماك القارية وتوازن النظام البيئي القاري، لافتة أنّ الجزائر تصدر أسماك المياه العذبة، حيث تعتبر أسماك البلطي، القرموط والشبوط أهم أسماك المياه العذبة المستزرعة محليا، إذ يؤدي هذا النوع من الاستزراع إلى تشجيع الصناعات التحويلية.
وتنوّه بأهمية التعاون بين المختصين في مختلف الميادين لاستخدام أحسن وتبادل المعلومات، فضلا عن اهتمام أكبر من قبل الباحثين حتى البياطرة، بالتركيز على استخدام النباتات الطبية لتحسين مناعة الأسماك والعلاج ضد بعض الأوبئة، كما أنّ الذكاء الاصطناعي مجال مهم في توفير برامج مثلا لحساب نسب تركيبات المواد، كذلك مختصو الميكانيك لصناعة أجهزة توزيع الأعلاف وغيرها من الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير المجال، إذ أكدت إيداع طلب الحصول على براءتي اختراع لمشروعي مؤسسة ناشئة واحد في استخدام مادة حيوانية كمصدر للبروتين عوض مسحوق السمك وآخر لتحسين تصبغ الأسماك، إذ تمّ ابتكار لون لا يضر بالأسماك لاعتبار مواده الطبيعية. إسلام قيدوم

تجارب غير تقليدية تخدم البيئة والتنمية المحلية
المـــــزارع .. وجـــه رائــج للسياحـــة المستدامــة في الجزائـــر
يساهم البحث المتزايد عن تجارب سفر وسياحة تجمع بين المتعة والاستدامة، في رواج المزارع التي تجذب اليوم عديد الأفراد والعائلات، لتخرج بذلك من الصورة النمطية لكونها مصدر إنتاج زراعي، وتتحول إلى فضاء للترفيه يجمع بين الأنشطة الفلاحية والسياحية، ويقدم تجربة تفاعلية تتيح للزوار الاقتراب من الطبيعة بشكل أكبر.

تحظى مزارع عديدة في الجزائر، باهتمام متزايد هذه السنة، خصوصا من قبل عشاق الطبيعة والراغبين في الابتعاد عن صخب المدينة وهوائها الملوث، إذ يشكل الوعي البيئي عنصرا أساسيا في كل ذلك، بداية بالأماكن الطبيعية البعيدة عن ملوثات الجو، إلى جانب المميزات الخاصة التي توفرها هذه المزارع في مجال الغذاء بفضل ما تقترحه على زوارها من منتوجات عضوية طازجة، فغالبا ما تتوفر على محلات تابعة لها تبيع منتجات خاصة بالمزرعة من أجبان وكل مشتقات الحليب، وحتى العسل الطبيعي والخضر والفواكه التي تنتجها الأشجار المثمرة أيضا، بما يتيح للسائح إمكانية الاطلاع على مصدر غذائه وأهمية الزراعة المستدامة.
مزيج بين السياحة والفلاحة
وتصنع تلك المزارع الطبيعية البسيطة الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لها بقوة، خصوصا وأنها مختلفة من حيث هندستها وتجهيز مرافقها المهيأة لاستقبال الزوار، وهو ما أحدث الفرق من حيث الإقبال الكبير عليها سواء من طرف العائلات، أو مجموعات الأصدقاء، أو حتى تحولها إلى عنوان رئيسي لخرجات رياض الأطفال والمدارس والأنشطة الجماعية لبعض المؤسسات، وهو ما وقفنا عليه بمزرعة بولاية تيبازة، ذاع صيتها بشكل كبير هذه السنة بالنظر إلى جودة المرافق والخدمات التي تقدمها للزوار، وهي شهرة لا تقل عن الانتشار الذي تحققه مزرعة أخرى بغرداية و ثالثة ببومرداس، وأخرى رابعة بقسنطينة.
أخبرنا أحد عمال المزرعة، خلال زيارتنا لها مؤخرا، أنهم أخضعوا المكان لأشغال توسعة وتهيئة، بحيث يتوفر اليوم، على كل ما يحتاجه الزائر من أماكن للترفيه والتعلم، مشيرا إلى أنه يقصد بالتعلم اكتساب بعض الحيل الزراعية و معرفة طرق التعامل مع النبات والحيوان.
كما تتوفر المزرعة كذلك، على محلات لبيع منتجات طبيعية تنتج محليا، تكون متاحة للسياح والزوار بنوعية جيدة وأسعار تنافسية، وتشجع على استهلاك كل ما هو طبيعي أو «بيو». وكلها مقومات يرى محدثنا، بأنها تساهم في رفع نسبة الزوار من سنة إلى أخرى مضيفا، أن المزرعة قبلة للزوار دوما خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، أو العطل المدرسية التي أكد أنها تشكل فترات الذروة من حيث الإقبال.
استثمار مغر
صادفنا خلال جولتنا في المزرعة، العديد من الأشخاص من ولايات أخرى وقد اتضح لنا ذلك من خلال تعدد اللهجات المحلية، تقربنا من إحدى السيدات، فقالت إنها جاءت من وادي سوف في رحلة سياحة إلى الجزائر العاصمة، ولأنها سمعت الكثير عن المزرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اختارت العائلة أن تكون تيبازة من بين محطاتها الرئيسية.
وعبرت المتحدثة، عن سعادتها بالتجربة،وقالت إنها ثقافة جيدة تروج للاستدامة وحب الطبيعة، وتجعلنا أكثر وعيا بمخاطر ما قد نخسره في حال لم ننتبه إلى تحديات كوكبنا.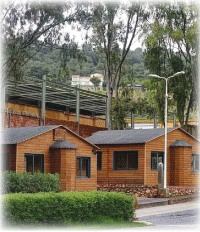
وفي ذات السياق، أكد العامل بالمزرعة أنهم يستقبلون زوارا من مختلف ولايات الوطن خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يعتبره مشجعا لمواصلة العمل وتطوير النشاط بما يخدم الزائر والبيئة.
مزرعة تيبازة، ليست إلا عينة من تلك المزارع التي يتزايد عددها من يوم لآخر في بلادنا، بعد أن لقيت المبادرة رواجا في أوساط العديد من الأفراد وشجعتهم على السياحة الداخلية، وذلك بحسب ما تظهره تلك الإعلانات لمزارع من مختلف ولايات الوطن، خاصة بمنطقة الهضاب العليا، وهي مزارع يروج لها مؤثرون يقدمون صورة عامة عن هذه الأماكن، التي تتوفر كذلك على غرف للمبيت أو بيوت خشبية وأشجار مثمرة، وحظائر للحيوانات مع مسابح، ويمكن الاستفادة من خدماتها بأسعار متفاوتة حسب ميزانية الفرد أو العائلة.
وقد علمنا من أصحاب المزرعة المتواجدة بتيبازة، أن هذا النشاط الزراعي السياحي، يسمح بتوفير مصدر دخل إضافي للفلاحين وللمالكين بما يدعم ويعزز الاقتصاد المحلي، في وقت تساعد فيه الأنشطة المختلفة المقترحة على الزوار، في تثقيفهم حول أهمية الحفاظ على البيئة وقيمة الزراعة المستدامة، وتقدم خيارات جديدة للسياح الباحثين عن تجارب غير تقليدية.
إ.زياري
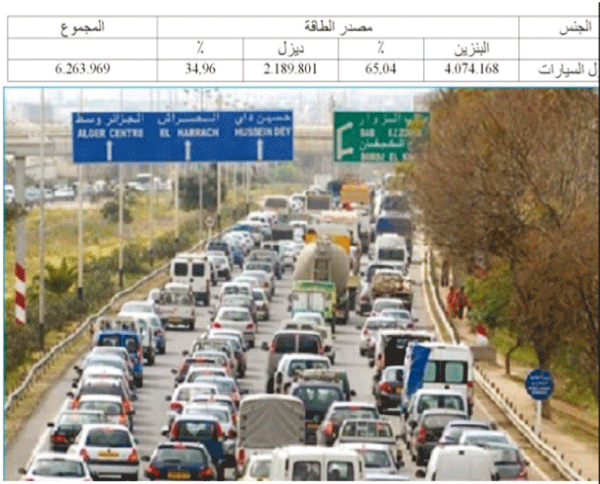
طاقات غير نظيفة وصناعات تهدد الكوكب
99 بالمئة من سكان العالم يتنفسون هواء ملوثا
تشير بيانات لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن 99 بالمئة من سكان العالم يتنفسون هواء ملوثا، من مسبباته الاعتماد المطلق على الطاقات الغير نظيفة، والصناعات الكبرى، زيادة على ما تفرزه النفايات من غازات سامة، وكلها عوامل تتسبب حسب الخبراء، في الانتشار الرهيب للأمراض وزيادة معدلات الموت، وسط دعوات لاعتماد بدائل نظيفة وحلول ذكية تعتبر فعالة في تنظيف الهواء.
يصنف تلوث الهواء ضمن قائمة المخاطر البيئية الكبرى على الصحة والتي يعاني منها كل سكان الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، وحتى البلدان المتطورة المرتفعة الدخل، بحيث تشير أرقام منظمة الصحة العالمية إلى أن تلوث الهواء في المدن والقرى يتسبب في وفاة 4.2 مليون حالة مبكرة سنويا، وذلك نتيجة للإصابة بالأمراض القلبية الوعائية وأمراض الجهاز التنفسي، وأنواع مختلفة من السرطان يتقدمها سرطان الرئة.
موت عالمي جماعي
ويكشف تقرير لمنظمة الصحة العالمية، أن ما يقارب 68 بالمئة من حالات الوفاة المبكرة الناتجة عن تلوث الهواء الخارجي، سجلت في العام 2019 بسبب الإصابة بمرض القلب الإقفاري والسكتة الدماغية، وأن 14 بالمئة من هذه الوفيات نجمت عن الإصابة بمرض الرئة الانسدادي المزمن، بينما نجمت 14 بالمئة عن عدوى الجهاز التنفسي السفلي الحادة، و4 بالمئة المتبقية نتجت عن سرطانات الرئة. وعلى الرغم من أن كل بدان العالم تتقاسم خطر الهواء الملوث، إلا أن سكان البلدان التي تكون منخفضة ومتوسطة الدخل، يتحملون العبء الأكبر الناتج عن تلوث الهواء الخارجي، بحيث تشير الأرقام إلى أن 89 بالمئة من أصل 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة تسجل في هذه المناطق، علما أن أعلى نسب الوفيات والتضرر ترصد في إقليمي جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ.
مبادئ عالمية و توجيهية لا يعترف بها
وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد فرضت مبادئ توجيهية عالمية لنوعية الهواء، وفق إرشادات عامة بشأن العتبات والحدود القصوى لملوثات الهواء الرئيسية التي تشكل مخاطر صحية، إلا أنها تبقى مجرد توجيهات لا يتم الاعتراف بها ولا اعتمادها من قبل البلدان المصنعة، رغم أن هذه المبادئ التوجيهية وسيط لتعزيز الانتقال التدريجي من مستويات التركيز المرتفعة إلى مستويات أدنى.ويصنف الخبراء تلوث الهواء إلى نوعين، تلوث الهواء المحيط وهو تلوث خارجي، وتلوث الهواء داخل المنزل ويسمى تلوث الهواء الداخلي، علما أن التلوث الخارجي يصنف كأكبر مشاكل الصحة البيئية التي تلحق أضرارا جسمية بكل سكان المعمورة دون استثناء.
وتشكل الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء أخطر الملوثات، والمتمثلة في خليط من القطرات الصلبة والسائلة التي تحوي جزيئات أكبر حجما مصدرها حبوب اللقاح ورذاذ البحر والغبار المحمول بواسطة الرياح الناجم عن التآكل، ومساحات الأراضي الزراعية، وطرق وعمليات التعدين،ويمكن أن تأتي هذه الجسيمات من مصادر أولية مثل حرق الوقود في مرافق توليد الطاقة أو المصانع المركبات، ومصادر ثانوية مثل التفاعلات الكيميائية بين الغازات. ويحمل الهواء الملوث أيضا، مكونات أخرى تعتبر خطيرة للغاية، منها ثاني أكسيد النيتروجين، وهو غاز ناتج عن احتراق الوقود بأنواعه في بعض العمليات مثل تلك المستخدمة في الأفران، ومواقد الغاز، والنقل والصناعة، وتوليد الطاقة، إلى جانب ثاني أكسيد الكبريت، وهو غاز آخر ينتج أساسا عن احتراق الوقود الأحفوري بأنواعه بأغراض التدفئة المنزلية والصناعات وتوليد الطاقة، وكذا غاز الأوزون الموجود في طبقات الجو السفلى، و الناتج عن تفاعل كيميائي لغاز مثل ثاني أكسيد النيتروجين بوجود ضوء الشمس، وهي الملوثات التي تثبت أثرها الصحي المباشر على الإنسان خاصة الجسيمات الدقيقة العالقة ثم ثاني أوكسيد النيتروجين، وغاز الأوزون الذي يعتبر عاملا رئيسيا للإصابة بالربو أو لتدهور حالته.
الخبيرة في الطاقات المتجددة الدكتورة كريمة قادة تواتي
مخاطر نتخطاها بالتكنولوجيا والحلول الذكية
أرجعت الخبيرة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، الدكتورة كريمة قادة تواتي، تلوث الهواء والتلوث البيئي للاستغلال الخاطئ وغير العقلاني للطاقات الطبيعية، إضافة لاستغلال الطاقات الأحفورية كالبترول والكربون، ما يلوث البيئة والهواء بفعل إفراز غازات سامة وخطيرة جدا.
وأكدت الخبيرة، أن المواد الكيميائية التي يولدها هذا الاستغلال للطاقات تنتشر عبر الهواء الذي نتنفسه، وبالتالي تأثر سلبا علينا بفعل المواد الكيميائية الخطيرة جدا المسببة للأمراض القاتلة.
وأضافت الدكتورة قادة تواتي، أن الصناعات تشكل عاملا رئيسيا في تلوث الهواء، وذلك نتيجة الطرق المعتمدة في الصناعة التحويلية،التي تنتج نفايات سامة تؤثر بالدرجة الأولى على صحة الإنسان.ودعت الخبيرة، إلى ضرورة مراجعة بعض الممارسات الصناعية عبر اعتماد طرق صحية أكثر، يمكن أن تتيحها التكنولوجيا المتطورة في الصناعة، والتخلي عن الطرق التقليدية المسببة لأعلى نسب التلوث خاصة الآلات القديمة، مشددة على أهمية تبني طرق حديثة في التصنيع للتقليل من انبعاثات الغازات السامة. وأشارت أيضا، إلى النفايات التي اعتبرتها عبئا كبيرا على الكوكب بسبب الغازات السامة، خاصة البلاستيك الذي يتطلب مئات السنوات للتحلل في الطبيعة، ودعت إلى ضرورة التحول نحو الاقتصاد التدويري الذي يجب أن يدرج في الاستراتيجيات الكبرى للتصنيع، وذلك بالنظر إلى فوائده الكبيرة في تقليص حجم النفايات، كما يوفر ثروة ومناصب جديدة، بما يرسخ للاستدامة، ويشكل ثروة اقتصادية كبيرة للبلاد، ويقلل كذلك من الملوثات
و الأضرار ويحمي الإنسان.
إيمان زياري

تجدهم في كل مكان، في الشوارع و الساحات العامة، و مواقع الجمع و بالمفارغ العمومية يبحثون عن مصدر الرزق بين أكوام النفايات، هكذا هم أو كما يعتقد أغلب الناس، لكنهم في الحقيقة هم يؤسسون لاقتصاد أخضر مستديم بطريقتهم الخاصة، دون انتظار توجيه أو مساعدة. ما يصبون إليه فقط هو سوق واعدة تحفزهم و تشجعهم على الاستمرار و التطور، و خوض تجربة فتية كما كانت الجزائر في حاجة إليها قبل سنوات مضت عندما كانت تلك النفايات الثمينة تذهب هدرا بالردم في المفارغ و الرمي العشوائي في الطبيعة و الأودية و البحر و حقول الزراعة، ملحقة أضرارا اقتصادية و بيئية و صحية ظل الناس غير مدركين لها عقودا طويلة من الزمن قبل أن يكتشفوا الناس تحت تأثير الحاجة و ربما باستفاقة ضمير بأن ما يرمى هدرا و عبثا هو في الحقيقة كنز و مصدر رزق لا ينضب.
إنهم جامعو النفايات الذين يعملون على تطهير المدن و الطبيعة من البلاستيك والحديد، والخشب و الأواني المنزلية والكارتون والعجلات المطاطية والبطاريات و التجهيزات الإلكترونية المعطلة، و المدافئ و مواقد الطهي و كل ما انتهى و لم يعد يصلح للاستعمال.
يجمعون كل شيء يمكن إعادة تدويره و تحويله الى منتج جديد يفيد الناس في حياتهم اليومية، يزدادون عددا كل يوم، نشاطهم يتعاظم و يتوسع، حتى أن بعضهم لم يعد يجد ما يجمعه إذا تأخر عن موعد رمي النفايات المنزلية و التجارية.
و في الوقت الحالي يبدو الكثير من هؤلاء الجامعين غير مهتمين بالجانب التنظيمي للمهنة، و لا بالمخاطر المحدقة بهم، كل ما يهم هو أن يجدوا من يشتري بضاعتهم و يدفع الثمن الآخذ في الارتفاع باستمرار، فكلما نمت شركات الفرز و الاسترجاع و التدوير، يزداد الطلب على النفايات، و ترتفع أسعارها، خاصة النفايات الثمينة كالحديد و النحاس و البلاستيك و التجهيزات الالكترونية.
و تعمل الهيئات الوطنية الرسمية على تنظيم هذه المهنة الخضراء، و من ثم سوق النفايات و بعث صناعة وطنية مستديمة تعتمد على المواد الأولية الناتجة عن إعادة التدوير وفق تقنيات متطورة يشهدها العالم في السنوات الأخيرة في إطار جهود حماية الكوكب و خفض البصمة الأيكولوجية للبشر الذي سيحتاجون عدة كواكب مماثلة لكوكب الأرض حتى يشبعوا حاجاتهم إذا استمر استهلاكهم على ما هو عليه اليوم.
الجزائر تتجه نحو تنظيم سوق النفايات
يقول كريم ومان، خبير البيئة الجزائري و المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنفايات بأن جامعي النفايات في الجزائر لهم دورهم أساسي لربط منتجي النفايات بمنشآت إعادة التدوير، حيث . تقوم شركات إدارة النفايات بجمع وفرز النفايات المنزلية والصناعية قبل بيعها إلى مصانع إعادة التدوير، مضيفا في تقرير جديد له، حصلت النصر على نسخة منه، بأن الجزائر شهدت في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا بمجال إعادة التدوير، وقد تعززت هذه الديناميكية بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال مجلس الوزراء المنعقد في 30 أبريل 2024 عندما كلف عدة قطاعات بينها الداخلية و البيئة بإعداد خارطة طريق، تحت إشراف الوزير الأول لإضفاء مزيد من الحيوية على أنشطة الجمع و إعادة التدوير في الجزائر.
ومع تنامي الوعي الاجتماعي و الاقتصادي يقول كريم ومان، أصبح من الضروري التعامل بجدية مع مسألة تسعير النفايات القابلة لإعادة التدوير، فالمشكلة حسب اعتقاده، لا تكمن فقط في كيفية إعادة تدوير هذه النفايات، بل أيضا في كيفية تحديد أسعارها بطريقة منظمة وشفافة وبالتالي يعد إنشاء آلية وطنية مرجعية لأسعار النفايات في الجزائر، خطوة مهمة و حيوية نحو تعزيز الشفافية وتحقيق ديناميكية فعالة في السوق، حيث تعتبر أسعار النفايات القابلة لإعادة التدوير عنصرا أساسيا في تنمية سوق النفايات الواعدة.
و حسب خبير البيئة فإن الجزائر تواجه حاليًا تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث تفتقر حاليا إلى نظام موحد لتوثيق هذه الأسعار، مما يؤدي إلى فروق كبيرة قد تثبط المستثمرين و الجامعين، مضيفا بأن هذه الفروق قد تؤدي إلى خلق مناخ من عدم الثقة، الأمر الذي يعيق تطور هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
و يرى كريم ومان بأن إنشاء آلية وطنية لتحديد أسعار مرجعية للنفايات سيساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات، حيث يتيح وجود مرجع دقيق و واضح لهذه الأسعار، للجهات الفاعلة اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يعزز الثقة بين الأطراف المعنية.
فعلى سبيل المثال، يضيف خبير البيئة الجزائري في تقريره، يمكن أن تساهم هذه الآلية في الحد من فرص الاحتيال و الاحتكار، حيث ستصبح الأسعار متاحة و واضحة للجميع.و علاوة على ذلك، يمكن أن يساهم إنشاء نظام موحد لتحديد الأسعار في خلق ديناميكية فعالة في السوق، فمن خلال توفير معلومات دقيقة عن الأسعار، سيكون بإمكان الجهات الفاعلة تقييم الفرص المتاحة بشكل أفضل، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع و تشجيع الجهات الفاعلة على الانخراط، والمشاركة في البرامج الوطنية لإعادة التدوير .
مفهوم وطريقة عمل سوق النفايات
و يقدم كريم ومان سوق النفايات على انه نظام اقتصادي منظم يتفاعل فيه مختلف الفاعلين لتبادل النفايات، التي تعتبر مواد أولية ثانوية، ويستند هذا السوق إلى مبدأ العرض والطلب حيث تتأثر الأسعار بعوامل مثل توافر المواد وتكاليف المعالجة وطلب المستخدمين النهائيين.
و تعتمد سوق النفايات على عدة أطراف أساسية فاعلة و هي منتجو النفايات، ويمثلون بشكل أساسي الصناعيين والمستهلكين. فعلى سبيل المثال، في قطاع صناعة الأغذية تنتج الشركات نفايات بلاستيكية من مواد التعبئة والتغليف، ويمكن جمع هذه النفايات وبيعها إلى منشآت إعادة التدوير، مما يساهم في سلسلة التثمين، كما تلعب الأسر دورا رئيسيا في فرز النفايات، مما يسهل توجيهها إلى مراكز إعادة التدوير.
كما يعد جامعو النفايات حلقة مهمة و همزة وصل بين أطراف العملية برمتها، من المنتج إلى مراكز الفرز و مصانع إعادة التدوير التي تحول النفايات الى مواد خام تستخدم في تصنيع منتجات جديدة.
و يعد سوق النفايات بمثابة نظام ديناميكي يسهل المعاملات التجارية بين منتجي أو حائزي النفايات و معالجيها، ويساهم هذا السوق في الإدارة البيئية السليمة للنفايات، وخلق أنشطة الاسترجاع والتثمين، مما يوفر فرص عمل دائمة.
مهنة خضراء مستديمة
و في الدول الرائدة، تصنف مهنة جمع النفايات من بين المهن الخضراء المستديمة، لكن هناك عوامل عديدة محفزة على استمرار هذا النشاط المفيد للبيئة و الإنسان، بينها القيمة السوقية لهذه المواد، حيث يعتمد تقييم أسعار النفايات القابلة لإعادة التدوير على مجموعة من العوامل المترابطة التي تعكس ديناميكيات السوق وتكاليف المعالجة. و من بين أهم العوامل حسب خبير البيئة كريم ومان خصائص و طبيعة المواد القابلة لإعادة التدوير، سواء كانت هذه المواد عادية أو خطرة، تؤثر بشكل كبير على قيمتها، فبعض المواد تكون أكثر طلبا بسبب سهولة إعادة تدويرها و الطلب الكبير عليها، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
و هناك عامل جودة المواد الذي يلعب دورا حاسما في تحديد القيمة. فالمواد النظيفة والمفروزة بشكل جيد تكون ذات قيمة أكبر، و رغم تكلفتها العالية، فّإنها تحسن من ربحية إعادة التدوير من خلال جودة المواد. طلب السوق، و أسعار المواد الخام التقليدية، و القوانين و الحوافز العمومية، هي أيضا عوامل مهمة في استمرار نشاط الجمع و إعادة التدوير و تطور الأسعار و ديناميكية سوق النفايات الواعدة.
فريد.غ

باحثون يؤكدون على ضرورة مراعاة خصوصية كل منطقة
هذه أبرز تحديات التنمية المستدامة في الأقاليم الحساسة
ناقش مؤخرا، أساتذة وباحثون بجامعة قسنطينة3، أهم تحديات التهيئة والتعمير وآفاق التنمية المستدامة في الأقاليم الحساسة بالجزائر، وأكد المشاركون في الملتقى الوطني الأول حول الأقاليم الحساسة في الجزائر، على أهمية مراعاة هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة لكل منطقة وفقا لخصوصياتها.
وتطرق الباحثون، في اللقاء الذي نُظم بمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة قسنطينة 3 «صالح بوبنيدر»، إلى وجود استراتيجيات وطنية تهدف إلى حماية هذه الأقاليم تشمل برامج ومخططات لتطوير المناطق الساحلية والجبلية وغيرها من المناطق الحساسة.
عرف الملتقى الذي جاء بإشراف من مخبر الأقاليم الديناميكية الذكية والصامدة، بالتعاون مع فرقة البحث حول الأقاليم الحساسة والتنمية المستدامة والأمن، مشاركة واسعة تمثلت في أكثر من 26 مؤسسة، من بينها 22 جامعة، ومركزان للبحث العلمي، وشركاء اقتصاديون وعلميون، وسجلت خلال أول يومين من عمر الفعالية أكثر من 60 مداخلة تناولت موضوعات متنوعة تتعلق بالتحديات والحلول الخاصة بتنمية الأقاليم الحساسة.
وأكد رئيس قسم التقنيات الحضرية والبيئة ورئيس ملتقى «الأقاليم الحساسة بالجزائر»، الدكتور وليد مدور ، أن الحدث يعد الأول من نوعه، موضحا أن الفكرة جاءت استجابة لدراسة فرق البحث الخاصة التي ركزت على المناطق الحساسة في الجزائر، والتي تقسم إلى أربعة أصناف هي المناطق الساحلية، الجبلية، الحدودية، والصحراوية.
وأشار إلى أن هذه المناطق تعاني من التهميش ونقص الخدمات والمرافق الأساسية، مما يستدعي إدراجها ضمن خطط التهيئة الإقليمية الشاملة، كما تهدف بحسبه فكرة الملتقى إلى دراسة أسباب هذا التهميش، والعمل على إيجاد السبل الكفيلة بإدماج هذه المناطق في تنمية المجال الوطني، وأوضح المتحدث، أن أبرز التحديات البيئية والاجتماعية التي تواجه الأقاليم الحساسة في الجزائر تتعلق بالخصائص الطبيعية لهذه المناطق، والتي جعلتها عرضة للهشاشة.
ولفت مدور، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة ووضع شروط ملائمة لتنميتها، مشيرا إلى خصائص المناطق الساحلية واحتياجاتها، وكذلك طبيعة المناطق الجبلية التي تتميز بارتفاعاتها والمناطق الصحراوية التي تعاني من الجفاف، مؤكدا على أهمية مراعاة هذه التحديات وإيجاد حلول مناسبة لكل منطقة وفقا لخصوصياتها.
كما أشار في ذات السياق، إلى وجود استراتيجيات وطنية لحماية الأقاليم الحساسة، تشمل برامج ومخططات تهدف إلى تطوير المناطق الساحلية والجبلية، بالإضافة إلى صناديق خاصة بتهيئة هذه المناطق الهشة، وشدد على أهمية إشراك جميع الفاعلين، بما في ذلك العنصر البشري والمجتمع المدني، نظرا لدورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة لهذه المناطق.
وأشار، إلى الدور الكبير للبحث العلمي في تشخيص مشاكل الأقاليم الحساسة، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من التجارب الإفريقية والعالمية، ودراسة النتائج التي توصلت إليها الدول الأخرى بهدف تطبيقها في الجزائر، بما يسهم في تنمية هذه الأقاليم وتحقيق التنمية الشاملة.
من جهته، قدم الدكتور فؤاد بن غضبان، من معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة أم البواقي، مداخلة حول شبكة الخدمات كأحد البدائل لتهيئة المجالات الساحلية الحساسة بالجزائر، مع تطبيق عملي على ولاية الطارف، التي تعد ولاية حدودية تتميز بحساسيتها كونها ولاية فتية تشهد العديد من المشاريع التنموية. وأشار الدكتور، إلى أن أهمية هذا الموضوع تأتي من خصوصية ولاية الطارف التي تمتلك العديد من المقومات الطبيعية التي لم تتأثر بالتلوث حتى الآن، فالولاية لم تشهد تطورا صناعيا، وإنما تعتمد على أنشطة اقتصادية وفلاحية وسياحية، وتعرف الطارف بحسبه، بميزاتها الفريدة مثل الحظيرة الوطنية للقالة، والشريط الساحلي الممتد الذي يضم شواطئ متنوعة بين الرملية والصخرية، إضافة إلى الغابات والموارد المائية المختلفة، مثل الوديان، والبحيرات، والسدود، والحمامات المعدنية.
وأكد المتحدث، أن هذه الخصوصية الطبيعية تجعل من ولاية الطارف مجالا حساسا يتطلب شبكة خدمات متوازنة، يتم من خلالها تهيئة هذا المجال الولائي عبر اختيار مراكز الخدمات بشكل مدروس ومتوازن.
وأوضح، أن هذا يعني التركيز على المراكز أو المدن التي تحتضن الأنشطة الخدمية لتلبية احتياجات سكان الولاية، مع الحفاظ على مواردها الطبيعية وعدم التأثير سلبًا عليها، وأن مفهوم الاستدامة يمكن تحقيقه في مراكز الخدمات من خلال اختيار أمثل لتوزيعها بما يضمن تلبية الاحتياجات الحالية للسكان دون المساس بمقومات البيئة أو الإضرار بإمكانات الولاية الطبيعية.
وأشار الدكتور بن غضبان، إلى أن نتائج دراسته كشفت عن وجود خلل في البنية المكانية لشبكة الخدمات بالولاية، وهو ما استدعى تقديم مجموعة من التوصيات، تهدف إلى إعادة تشكيل البنية الخدماتية في ولاية الطارف، مع اقتراح صياغة تقسيم إداري جديد يساعد على تحقيق تنمية متوازنة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المنطقة الحساسة.
كما أوضحت مديرة مخبر الأقاليم الديناميكية الذكية والصامدة، الدكتورة عائشة جعفار، أن المخبر يعد جديد النشأة، حيث تم افتتاحه منذ عامين فقط، مؤكدة أن الفريق يسعى سنويا إلى تعزيز مكانته كمخبر بحث علمي متميز من خلال فضاء لتبادل الأفكار ودراسة الأقاليم بمختلف خصائصها. وأشارت، إلى أن اختيار موضوع دراسة المناطق الحساسة كان قرارا صعبا نظرا لتعقيد هذه الأقاليم وما تتطلبه من دراسات متعمقة، معبرة عن امتنانها لجهود الباحثين العاملين في المخبر الذين بذلوا جهودا كبيرة للإسهام في دراسة هذه المناطق وتقديم حلول للتحديات التي تواجهها.
لينة دلول
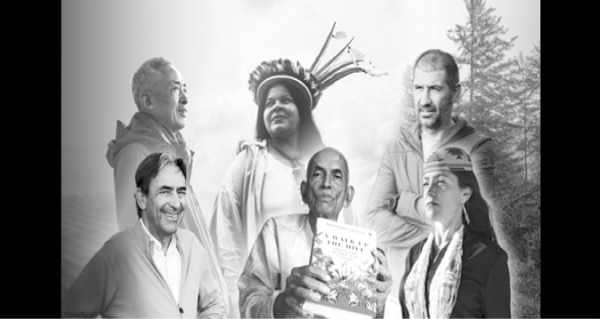
في مبادرة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
6 قادة بيئيين يتوجون بجائزة أبطال الأرض لعام 2024
أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عن أسماء 6 فائزين بجائزة أبطال الأرض لسنة 2024، نظير قيادتهم المميزة والحلول المستدامة التي قدموها لعلاج المشاكل التي يتخبط فيها الكوكب خاصة قضايا الجفاف والتصحر.
ومنحت الجائزة هذا لعام لـ6 قادة بيئيين هم صونيا غواخاخارا، وزيرة الشعوب الأصلية في البرازيل، التي منحت لها الجائزة في فئة السياسات والقيادة نظير دفاعها عن حقوق السكان الأصليين للبرازيل منذ أكثر من عقدين من الزمن، كما تحصلت الأمريكية آمي باورز كورداليس، على الجائزة في فئة الإلهام والعمل، تكريما لخبرتها القانونية وشغفها بإصلاح النظم الإيكولوجية لتأمين مستقبل أفضل لقبيلة يوروك، وحماية نهر كلامات في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحصلت مبادرة سيكم المصرية، مبادرة الزراعة المستدامة على الجائزة في فئة الرؤية الريادية، وذلك تكريما لما قدمته من مساعدات للمزارعين في مصر، من أجل التحول لزراعة أكثر استدامة بحلول عام 2025، والمساهمة في الترويج للزراعة الحيوية، ناهيك عن أعمال تحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى مشاريع زراعية مزدهرة.
كما منحت الجائزة أيضا، لغابرييل باون، في فئة الإلهام والعمل، وهو المدافع الروماني عن البيئة الذي ساهم بمبادرته في إنقاذ آلاف الهكتارات من التنوع البيولوجي الثمين في منطقة الكاربات منذ سنة 2009، إلى جانب العالم الصيني لو تشي، الذي فاز بالجائزة في فئة العلوم والابتكار تكريما لعمله في مجال العلوم والسياسات لثلاثة عقود لمساعدة الصينيين في عكس اتجاه تدهور الأراضي وتقليص مساحة صحاريها.
أما المتوج الأخير، فهو مادفاف غاردجيل، العالم الهندي في مجال البيئة والذي حصد الجائزة في فئة العمر، لما قدمه لعقود من الزمن لأجل حماية الناس والكوكب من خلال البحوث والمشاركة المجتمعية.
يذكر أن جائزة أبطال الأرض السنوية التي استحدثت سنة 2005، تعد أسمى جائزة تمنحها الأمم المتحدة في مجال البيئة، للرواد الذين يبذلون جهودا لحماية البشر وكوكب الأرض، لتكون قد منحت إلى غاية عام 2024، لـ122 ناشطا وقائدا بيئيا تكريما لعملهم المميز والملهم.
إ.زياري

أثبت طلبة باحثون جزائريون قدرتهم على الإبداع والابتكار من خلال مشاريع تخرج مميزة تركز على الحلول البيئية والتوجه نحو التنمية المستدامة، شاركوا بها في الطبعة الرابعة عشرة للصالون الوطني للابتكار، المنظم تحت شعار "الابتكار من أجل ريادة الأعمال"، تزامنا مع اليوم الوطني للابتكار، وحسب ما أكده المشاركون لـ"النصر" فإنهم يحملون روح الريادة من خلال سعيهم لابتكار حلول حديثة تخدم المجتمع وتعزز الاقتصاد الوطني، بما يفتح آفاقا واسعة لتطوير القطاعات الحيوية، بالاعتماد على أفكار إبداعية ومستدامة تدعم التوجه نحو اقتصاد أخضر ومستقبل أفضل.
روبورتاج لينة دلول
تميز الصالون الذي احتضنته مؤخرا، كلية الفنون والثقافة بجامعة قسنطينة 3 "صالح بوبنيدر"، بتنظيم من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، بالتعاون مع المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبتنسيق مع ولاية قسنطينة، بعرض مشاريع مبتكرة قدمها طلبة وباحثون من مختلف التخصصات، مع تركيز واضح على حلول صديقة للبيئة في مجالات الصحة، الزراعة، الصناعة، والبناء، ما يبرز اهتمامهم الكبير بتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة التحديات البيئية.
مبتكرات لتطوير الزراعة ومساعدة الفلاحين
يُعتبر مشروع وسيلة عطار، الطالبة المتخصصة في الحقوق والمتخرجة من كلية البيولوجيا، نموذجا مبتكرا لدعم الزراعة في الجزائر، بما يتماشى مع تطلعات الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي حسبما عبرت، إذ يتمحور حول تقديم حلين عمليين لتسهيل نشاط الفلاح و تقليل التكاليف وتحقيق إنتاجية عالية باستخدام تقنيات اقتصادية ومستدامة.
وأكدت المتحدثة، أن الفكرة الأساسية للمشروع تتمثل في تصميم شريط ورقي مبتكر يُستخدم في زراعة البذور، بالإضافة إلى تطوير آلة صناعية لتطبيق هذه التقنية على نطاق واسع.
والهدف من هذا الشريط بحسبها، هو تسهيل عملية الزراعة التقليدية وحماية البذور، وضمان إنتاج وفير بجودة عالية، متابعة بالقول :"عند وضع الشريط في التربة، يتحلل بشكل طبيعي ويغذي النباتات، كما أنه يساعد على الاحتفاظ بالماء وتنظيم أوقات السقي، مما يزيد من إنتاجية المحصول ويحافظ على جودة التربة".
وقالت بأنها، لم تكتف بالشريط فقط، بل عملت أيضا على تصميم آلة تزرع هذا الشريط بشكل آلي أسمتها "آلة الزرع والتسميد"، تجمع بين الدقة والكفاءة، و تعمل مع الجرارات الزراعية، وتحدد عمق الغرس والمسافات بين الصفوف كما أنها تحتوي على نظام لتعقيم التربة قبل وبعد الغرس، ما يقضي على الآفات والجراثيم التي تضر بالمحاصيل. وذكرت المتحدثة، أن مشروعها قابل للتطبيق على نطاق واسع، كما يمكن استخدامه في زراعة مختلف المحاصيل، مثل الفاصولياء و العدس والحمص، الطماطم، القمح، الشعير، الذرة، ودوار الشمس.
مشروع " GreenAl" لتدوير النفايات البلاستيكية في الملاعب
وفي ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم، يعمل الشابان عبد الرحمن بن يزار وسيف محمد أنيس، من جامعة قسنطينة 3، على رؤية مبتكرة لحل مشكلة النفايات البلاستيكية من خلال مشروعهما "GreenAl"، والذي يهدف إلى ضمان اقتصاد دائري يدمج الرياضة مع حماية البيئة.
وأوضح عبد الرحمن، أن المشروع جاء استجابة لمشكلة النفايات البلاستيكية المتفاقمة، خاصة في الجزائر حيث يتم تدوير أقل من 2 % من البلاستيك، لذلك وجدا في الرياضة وسيلة لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة إعادة التدوير. وأكد الشاب، أن الابتكار يكمن في تصميم جهاز لجمع زجاجات البلاستيكية في المنشآت والمجمعات الرياضية، مما يسهل لاحقا إعادة تدويرها واستخدامها في الصناعات المختلفة.
وأكد الطالب، بأن المشروع يركز على تعزيز التنمية المستدامة من خلال الاهتمام بالبعد البيئي، أي من خلال تقليل النفايات البلاستيكية وتحويلها إلى موارد قابلة لإعادة الاستخدام، وحماية البيئة من تأثيرات البلاستيك الضارة، مع تقليل تكاليف جمع النفايات ومعالجتها و توفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة، أما البعد الاجتماعي للمشروع فيتمثل في نشر الوعي البيئي وتعليم الأجيال الجديدة أهمية الحفاظ على البيئة. وأوضح المتحدث، أن مشروع "GreenAl" يتضمن تصميم نظام ذكي لجمع النفايات البلاستيكية، حيث يتم تثبيت جهاز مبتكر داخل المنشآت الرياضية لجمع الزجاجات البلاستيكية وفرزها، موضحا بأن الهدف منه تسهيل عملية الجمع والفرز باستخدام أجهزة ذكية متصلة بتطبيق يمكن التحكم فيه عن بعد، كما يتضمن تصميم تطبيق إلكتروني يسمح بمراقبة الجهاز وإدارته، مما يعزز الكفاءة ويقلل الهدر، علاوة على ذلك فإن الجهاز يقدم للشخص الذي يرمي مخلفاته البلاستيكية داخله، قسيمة تمكنه من اقتناء شيء ما من أحد الأكشاك.
وأشار عبد الرحمن، إلى أن المشروع يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل الإنتاج والاستهلاك المسؤول، فضلا عن مكافحة التغير المناخي و حماية النظم الإيكولوجية البرية.
موضحا، بأنه وزميله يتطلعان إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل قطاعات أخرى خارج الرياضة، و يصبح الابتكار جزءا من الحياة اليومية في الجزائر، مما يساهم في تقليل الاعتماد على البلاستيك وتحقيق اقتصاد دائري شامل.
مشروع لصيانة السيارات وتقليل التلوث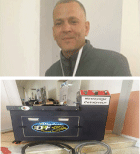
أكد المخترع طارق بعوش من ولاية البويرة، والحاصل على براءة اختراع عن مشروعه "Diadem Cleaning Services " الذي يقدم حلولا مبتكرة ومتطورة لصيانة السيارات، بأنه تم تأسيس هذه الشركة التي تعتمد على أحدث التقنيات لتنظيف "المحولات الحفازة" "catalyseurs" بهدف تحسين أداء المركبات وتعزيز استدامتها البيئية. وأوضح المتحدث، بأن "المحول الحفاز" يعد جزءا أساسيا في نظام عادم السيارة، حيث يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة عبر تحويل الغازات السامة إلى مكونات أقل خطرا، ومع مرور الوقت يتعرض المحول للتلف بسبب تراكم الكربون والرواسب، مما يؤدي إلى انخفاض في كفاءة المحرك، وزيادة استهلاك الوقود وارتفاع الانبعاثات الملوثة، لذلك فإن تنظيف المحول الحفاز بشكل منتظم يعد خطوة أساسية بحسبه، للحفاظ على أداء المحرك وتقليل التأثير البيئي.
وقال المتحدث، بأنه ابتكر كذلك جهاز تنظيف متطور يعتمد على تقنيات صديقة للبيئة، مما يضمن تنظيفا دقيقا وآمنا للمحولات الحفازة، وقد تم تصميم الآلة لتكون سهلة الاستخدام وآمنة على المكونات الميكانيكية، مع خصائص مميزة مثل تنظيف عالي الضغط لإزالة أصعب الرواسب، و مواد تنظيف غير سامة تحافظ على البيئة، مما يجعلها مناسبة لجميع تقنيي السيارات.
علاوة على ذلك، تقدم الشركة سائل تنظيف المحولات الحفازة، الذي يتميز بتركيبة مبتكرة قادرة على إزالة الكربون والرواسب، مما يساهم في تحسين أداء المحرك، وتقليل استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات الضارة.
وأوضح المتحدث، أن من فوائد التنظيف باستخدام المحلول، تحسين الأداء، استعادة كفاءة المحرك مما يعزز العزم ويقلل من استهلاك الوقود، تقليل الغازات الضارة الناتجة عن العادم، مما يسهم في الحفاظ على بيئة أنظف، و تقليل التآكل والتلف مما يقلل من الحاجة إلى عمليات استبدال مكلفة.
الري والتسميد الآلي لتحسين الإنتاج الزراعي
تُعد التكنولوجيا الحديثة ركيزة أساسية في تطوير الزراعة وتعزيز الإنتاجية، وهو ما يتجلى في مشروع "نظام الري والتسميد الآلي"، الذي ابتكرته الطالبتان ندى عمارنة، وإيناس منزوزا.
يهدف هذا النظام الذكي بحسبهما، إلى دعم الزراعة الدقيقة عبر قياس احتياجات النباتات من الرطوبة والمواد المغذية، ومن ثم ضبط كميات المياه والأسمدة تلقائيا لتلبية تلك الاحتياجات. وأوضحت عمارنة، أن النظام يساهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة مما يقلل من الهدر ويخفض التكاليف، كما يمكن المزارعين من إدارة النظام ومراقبته عبر موقع إلكتروني يعرض بيانات مباشرة حول حالة النباتات، مما يسهل اتخاذ القرارات، وكذا إرسال رسائل تنبيهية إلى هاتف المزارع في حالة الطوارئ، مثل حدوث أعطال أو تغييرات مفاجئة لضمان التدخل السريع.
وأوضحت المتحدثة، أن هذا الابتكار يشكل خطوة كبيرة نحو تحسين جودة الزراعة في الجزائر، لأن القطاع يواجه تحديات مرتبطة بشح المياه وصعوبة مراقبة الحقول الزراعية الكبيرة، إذ باستخدامه يمكن تحسين الإنتاجية الزراعية وتقليل الأعباء على المزارعين، ما يدعم تطور الزراعة المستدامة.
دفيئة زراعية ذكية ومستقلة
ابتكر الطالب زروق عثمان، من جامعة قسنطينة 1، تخصص "إلكتروـ تقني"، مشروعا مميزا يتمثل في "دفيئة زراعية ذكية ومستقلة" كبديل مستدام وفعال عن البيوت البلاستيكية التقليدية، يستهدف هذا الابتكار المستثمرين الراغبين في دخول المجال الزراعي، خصوصا زراعة المنتجات الفلاحية مثل الطماطم، حتى لو كانوا يفتقرون للخبرة الزراعية. وقال الطالب، إن للمشروع أنظمة متكاملة للتحكم البيئي، حيث تعمل الدفيئة على توفير بيئة مثالية للنباتات اعتمادا على نوع المحصول المختار عبر تطبيق هاتفي متخصص، يتيح اختيار نوع الطماطم أو غيرها، لتقوم الدفيئة تلقائيا بضبط المناخ الداخلي من حيث درجة الحرارة، والرطوبة، والضوء، ودرجة حموضة الماء (ph)، وتركيز العناصر الغذائية في مياه الري.
وقال المتحدث، بأن الدفيئة تتميز باستقلاليتها الكاملة في العمل بفضل استخدام الطاقة الشمسية، مما يجعلها صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، كما أكد بـأن المشروع يحتوي على نظام تشخيص يحدد الأعطال أو توقف الجهاز، مع إرسال إشعارات للمستخدم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف الطالب، أن فريق المشروع يعمل حاليا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتمكين الدفيئة من التعرف على أمراض النباتات واقتراح العلاجات المناسبة، مما يعزز من كفاءة الإنتاج ويقلل من الاعتماد على الخبرات الخارجية.
روبوت لكشف أمراض النباتات ومعالجتها
قدمت الطالبتان مارية أولاد الهدار وشرع الضاوية، من جامعة غرداية تخصص آلية وأنظمة، حلا مبتكرا يتمثل في مشروع "أغروبورت"، وهو روبوت ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الذكية. وبحسب الطالبة مارية، فإن الروبوت يعمل على مواجهة التحديات الزراعية الحديثة الكبيرة، خصوصا المتعلقة بأمراض النباتات والتي تؤدي إلى خسائر اقتصادية ضخمة وتهدد الزراعة المستدامة.
أوضحت مارية أولاد الهدار، أن فكرة المشروع جاءت نتيجة الصعوبات التي يواجهها المزارعون في التعامل مع أمراض النباتات، بالإضافة إلى الإرهاق الناتج عن المتابعة اليدوية. "ومن هنا كان هدف المشروع هو إيجاد حل ذكي وفعال لتخفيف العبء عن المزارعين وتحقيق الزراعة المستدامة" كما عبرت. وأكدت، أن من خصائص المشروع، التشخيص المبكر والتدخل السريع حيث يعتمد الروبوت على كاميرات متطورة مثبتة أسفل الجهاز، تقوم بمسح كل نبتة بدقة والتقاط صور لها، بعد ذلك يتم تحليل الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأمراض ونوعها، مع اقتراح العلاجات المناسبة. كما يوفر النظام منصة إلكترونية تعتمد على تحليل البيانات لتوقع الأمراض قبل ظهورها بناء على الظروف البيئية والمعطيات المجمعة. مضيفة، أن الروبوت يستطيع معالجة النباتات المصابة مباشرة في الميدان، ما يمنع انتشار المرض في باقي المحصول، كما يتم تحديد مكان الإصابة بدقة ويوفر للمزارع رؤية شاملة.
وأضافت المتحدثة، بأنه تم تطوير تطبيق يعمل مع الروبوت، يرسل إشعارات فورية للمزارع عند اكتشاف مشكلة أو مرض في المحصول، مع تحديد الموقع الدقيق للمنطقة المصابة، كما يتيح "غروبورت" بحسبها، أتمتة عمليات المراقبة والتشخيص والمعالجة، و يقلل من الجهد اليدوي ويوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بمكافحة الأمراض التقليدية.
المزرعة الذكية المتنقلة
يأتي مشروع " المزرعة الذكية المتنقلة "في ظل التطور التكنولوجي المتسارع والرغبة في تحقيق الزراعة المستدامة، كما أوضحته مبتكرتاه الطالبتين شيماء بومهراس، وزميلتها فضيلة دهاس من جامعة غرداية وهدفه الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا المتطورة.يمكن المبتكر بحسب بومهراس، من توفير حل زراعي ذكي ومريح للأفراد الذين يرغبون في زراعة المحاصيل الطازجة بسهولة، سواء داخل منازلهم أو في المساحات الخارجية.وقالت المتحدثة، إن من خصائص المشروع، أنه نظام يعتمد على تقنية الزراعة العمودية والهيدروبونيك، مما يتيح زراعة محاصيل متنوعة دون الحاجة للتربة، وكذا استخدام الإضاءة الاصطناعية لضمان نمو النباتات في أية بيئة، كما يحتوي على حساسات لقياس مستوى الماء، شدة التيار الكهربائي، وشدة الإضاءة لضمان بيئة مثالية للنباتات. ويتيح النظام تضيف المتحدثة، التحكم الذكي و ضبط الإضاءة و دورة المياه، فضلا عن تحديد درجة الحرارة حسب الحاجة، متابعة بالقول بأن التطبيق يوفر خيارين للاستخدام فالوضع الأوتوماتيكي يشغل النظام بشكل كامل دون تدخل المستخدم، أما الوضع اليدوي، فيتيح التحكم الكامل في النظام حسب رغبة المستخدم. وأضافت الطالبة، أن التطبيق يرسل إشعارات عند حدوث أي عطل، مما يسهل صيانة النظام، كما يتميز المشروع بتصميمه الأنيق الذي يتناسب مع مختلف الديكورات، مما يجعله مناسبا للاستخدام في المنازل، والشقق والمطاعم، والفنادق مع إمكانية التوسع بربط وحدات متعددة معا للحصول على إنتاج أكبر. وأوضحت، بأن النظام يساعد على ترشيد استهلاك الماء والطاقة، مما يجعله خيارا بيئيا مستداما، ويدعم زراعة الخضروات، الفواكه، والأعشاب، مع إمكانية الاستمتاع بالمحاصيل الطازجة على مدار العام.
ل- د
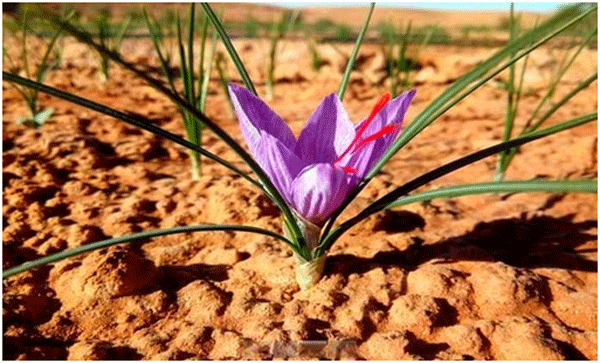
أحمد شرقي رئيس المجلس المهني للشعبة
النباتات العطرية و الأعشاب الطبية مصدر تنمية بتبسة
تعرف ولاية تبسة، وفرة في الأعشاب والنباتات العطرية ذات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الاستخدام العلاجي، مما شجع و حفز الكثيرين على ولوج مجال إنتاج المستخلصات والزيوت النباتية التي تستعمل في علاج بعض الحالات المرضية البسيطة أو ذات الاستعمالات التجميلية وشبه الصيدلانية، كونها صناعة هامة يمكنها أن تصنع الفارق في مجال الاستثمار محليا، سيما في ظل إقبال الشباب عليها.
نشاط يفتح شهية المستثمرين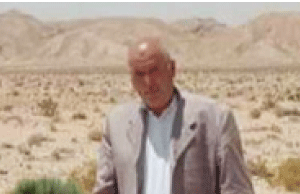
التقت النصر، بالسيد أحمد شرقي، رئيس المجلس المهني لشعبة النباتات الطبية والعطرية، والمهتم بإنتاج الزيوت العلاجية، وقد حدثنا عما تزخر به الولاية من الأعشاب والنباتات المفيدة، الأمر الذي شجعه على الاهتمام بهذه الشعبة، نظرا للطلب المتزايد عليها محليا ووطنيا وحتى دوليا.
يجمع محدثنا، النباتات العطرية و الطبية التي يستعملها في نشاطه من غابات الولاية، و ذلك بناء على رخصة من محافظة الغابات، و يقوم كمرحلة أولى بتصنيف هذه النباتات، ثم تحضيرها للتقطير و هي مرحلة التثمين كما عبر، لأن العشبة الطبيعية تتحول إلى زيت أساسي ذي قيمة اقتصادية، مضيفا أن عدد المهتمين بإنتاج الزيوت الطبيعية في الولاية ارتفع من مؤسستين إلى 12 مؤسسة، تقوم جميعها بتصنيع مختلف الزيوت.
إقبال على تربصات مهنية في المجال
وأوضح، أنه بحكم ترأسه للمجلس المهني المشترك لهذه الشعبة، فهو يسعى جاهدا للتعريف بها أكثر وجذب الشباب لهذا المجال، من خلال برمجة دورات تكوينية، و إبرام اتفاقيات مع مراكز التكوين المهني والتمهين بالبلديات، بما في ذلك بلدية الحمامات لتكوين الراغبين في الالتحاق بهذه الشعبة، علما أن مدة التكوين تقدر بـ 3 أشهر.
وأوضح المتحدث، أن البدايات اتسمت ببعض التخوف من تسجيل عزوف محتمل، لكن الواقع جاء مغايرا حيث التحق بالمركز 60 متربصا في هذا الاختصاص، وأكد المتربصون أنهم دخلوا الميدان عن قناعة تامة وحب لممارسة النشاط و الاستفادة منه في حياتهم العملية، سيما في ظل الإقبال الكبير على استعمال الزيوت الطبية والعطرية في العلاجات والاستعمالات المنزلية، مما يجعل الاهتمام بمجال إنتاج الزيوت خطوة إيجابية، يمكنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الطلب تضاعف في السنوات الأخيرة.
نحو إنشاء مشاتل لتوطين النباتات الطبية والعطرية
وأضاف محدثنا، أنه تم تنظيم عدة لقاءات لتثمين النباتات الطبية والعطرية التي تتوفر عليها الولاية، من خلال وضع استراتيجية محلية واعتماد خارطة طريق تضمن استمرارية استغلال هذه النباتات، والعمل على تشجيع وتوجيه ممتهني شعبة النباتات الطبية والعطرية بالولاية نحو توطين هذا النوع من النباتات خاصة المحمية منها، فضلا عن التركيز على إنشاء مشاتل خاصة بها، خصوصا على مستوى المناطق المتدهورة جراء حرائق الغابات، مع توجيه ممتهني الشعبة للتنظيم في إطار تعاونيات غابية ومؤسسات صغيرة ومتوسطة منها ما تملكها نساء.
مثمنا جهود السلطات المحلية التي تشجع على إنشاء خلايا تقنية دائمة متخصصة، تضم جميع الشركاء للعمل باستمرار من أجل ضبط خارطة طريق، من شأنها تطوير نشاط استغلال النباتات الطبية و العطرية حتى تكون مصدر ثروة مضافة للولاية.
خزان محلي هام من الأصناف عالية القيمة
وأشار السيد شرقي في حديثه، إلى أن ولاية تبسة، تعتبر الأكبر وطنيا في توفر أعشاب ذات قيمة عالية مثل " إكليل الجبل، والشيح الأبيض وعشبة القزّيح"، كما توجد ببئر العاتر على سبيل المثال، ثروة كبيرة من النباتات الطبية والعطرية المطلوبة في البحث العلمي مثل "الشيح والقزّيح، والكبّار، والرمث، والبطّوم، والفيجل" الذي يعد من أهم المواد الأولية المطلوبة في المخابر الوطنية والدولية، مؤكدا أن نبتة إكليل الجبل تنبت في 11 دولة في العالم فقط، منها الجزائر، وهي متوفرة بكميات معتبرة في ولايات تبسة، خنشلة، باتنة، تسمسيلت، تيارت، وعين تموشنت.
كما أعطى مثالا بعشبة الرّمث، المتواجدة في منطقة عقلة الشحم، ببلدية بئر العاتر بكثرة، وبعض مناطق صحراء الجزائر، أين تستعمل كغذاء للإبل، رغم أنها تنتج أحد أغلى الزيوت في العالم، نظرا لاستخداماته الأساسية في صناعة أنواع من العطور الفاخرة.
من جهة ثانية، توضح مصالح مديرية الفلاحية بالولاية، أنه يتم استغلال كمية هامة من النباتات الطبية والعطرية في السنوات الأخيرة، لاستخراج الزيوت الطبيعية والمياه المقطرة، التي تستخدم في مختلف المجالات الطبية والتجميل و شبه الصيدلانية، و أن هذا الرافد الاستثماري التحويلي مفيد لتحقيق التنمية المحلية، وتوفير مجالات تشغيل أوسع لفائدة العمال الموسميين الذين يقومون بجمع هذه النباتات واستخلاص الزيوت الطبيعية الخالية من المواد الكيميائية أو إضافات أخرى، فضلا عن الحصول على المياه المقطرة والمستخدمة في مجال العلاج بالأعشاب الطبية.
مع الإشارة، إلى أن كل 4 قناطير من نباتات "الإكليل، والشيح، أو الورد" وغيرها، تمكن المستثمرين في هذا المجال من استخلاص حوالي 1 لتر من الزيت الخام، زيادة على ما يناهز 10 إلى 20 لترا من الماء المقطر.
وقد تعززت هذه الشعبة في الولاية، بإنشاء المكتب الولائي للمجلس المهني المشترك لفرع النباتات الطبية والعطرية، الذي يعمل على تنظيمها ومراقبة نشاطها، ناهيك عن مرافقة المستثمرين، وتقديم كل الدعم لهم، مبرزا ضرورة تشجيع المستثمرين على التوجه نحو قطاع الغابات والعمل على استقطابهم، من خلال تقديم الدعم والتحفيز الضروريين بغية تطوير هذه الشعبة، خاصة وأن ولاية تبسة تضم مساحات هامة للنباتات الطبية والعطرية.
كما تعرف المنطقة، اهتماما بتنظيم دورات تكوينية في مجال تقطير النباتات الطبية والعطرية، سيما لفائدة المرأة الريفية، وتسهيل إجراءات حصولها على قروض لتجسيد مشاريع مصغرة، بغية تحسين ظروف معيشة سكان الأرياف، والمساهمة في استحداث مناصب شغل جديدة.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن علاقة سكان تبسة بعالم الأعشاب الطبية والعطرية قديمة، حيث اهتموا دائما باستخداماتها، بحسب ما أكده لنا ناشطون على مستوى واحد من بين أقدم المحلات المتخصصة في الولاية، والذي فتح أبوابه سنة 1892، ويعود لعائلة جلالي.
وحسب أصحاب المحل الواقع داخل السور البيزنطي بمدينة تبسة، بشارع فرانتز فانون، فإن المتجر مقصد للعديد من المواطنين من كل أرياف ومدن الولاية، الذين يستهلكون الأعشاب و مستخلصاتها بشكل مستمر، لأجل استخداماتها الطبية والعطرية التجميلية مثل "عطر الزاوي، المسك، الكحل، البخور"، كما يبيع المحل منتجات عطرية على غرار خلاصة النعناع، والفانيليا، والبرتقال.
عبد العزيز نصيب

أطلقتها مديرية البيئة لولاية الوادي
حملة لمراقبة وتشخيص وضعية المساحات الخضراء بمختلف البلديات
باشرت مطلع الأسبوع، مديرية البيئة في الوادي، حملة واسعة لمراقبة وتشخيص وضعية المساحات الخضراء المتواجدة بمختلف بلديات الولاية ومعاينتها ميدانيا لضبط تقييم شامل لحالة كل الموقع، بما يضمن المحافظة عليها والتدخل الميداني للتي بحاجة لتدخل.
وحسب مديرية البيئة، فإن مصالحها ممثلة في اللجنة الولائية لمراقبة المساحات الخضراء، شرعت خلال الأيام القليلة الماضية في حملة ميدانية لمراقبة كافة المساحات الخضراء المنجزة من على مستوى البلديات، حتى يتسنى لها تسجيل الوضعية الحالية لكل المساحات وتقييمها ومراقبة شبكة تزويدها بمياه السقي ومدى صلاحية البساط الأخضر، إلى جانب وضعية التهيئة الداخلية والخارجية التي تشكل الأرصفة، و السياج وأماكن جلوس قاصدي هذا النوع من الأماكن.
وأكدت مصالح البيئة على أهمية مساهمة المواطن في المحافظة على المساحات الخضراء والمعدات التابعة لها، على غرار الكراسي وشبكة المياه إلى جانب المحافظة على الأشجار المحيطة بكل بساط أخضر والأعمدة الخاصة بالإنارة، والمشاركة في حملات دورية للنظافة والتشجير، ناهيك عن التحلي بثقافة التبليغ عن أي حالة اعتداء على هذه المساحات التي تخدم الطابع الجمالي للمدينة.
كما دعت المصالح ذاتها، إلى الانخراط في العمل الجمعوي عن طريق تأسيس النوادي والجمعيات ذات الطابع البيئي لنشر ثقافة المحافظة على البيئة وغرس ثقافة التشجير بين شرائح المجتمع.
منصر البشير

أكد محمد صالح بولحليب، أستاذ بجامعة الإخوة منتوري قسنطينة 1، أن الجزائر تتجه بخطى إيجابية نحو مستقبل أخضر في مجال النقل، حيث يبدل الباحثون جهودا حثيثة لإيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي ومشتقات البترول، مشيرا إلى وجود أبحاث حول المشتقات البترولية كالزيوت النباتية والبطاريات الهيدروجينية كوقود أساسي مستقبلا.
سعيد العافر
المدن الذكية وتقنية النقل الحضري
وتحدث الأستاذ بكلية التكنولوجيا، محمد صالح بولحليب، خلال ملتقى وطني حول "هندسة النقل واللوجيستية والبيئة"، نظم نهاية الأسبوع الماضي من طرف جامعة منتوري بقسنطينة، عن مستقبل النقل في الجزائر والعالم في عام 2050، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية المتزايدة تتطلب حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات النقل، و في هذا السياق، تناول بشكل خاص "المدن الذكية"، وهي رؤية مستقبلية تهدف إلى تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة التي تشغل المساحات وتسبب التلوث البيئي والصوتي، حيث أشار إلى أن المدن الذكية تركز على استبدال المركبات الخاصة بوسائل النقل العامة، مثل المترو والترامواي، وهو ما سيعزز من كفاءة النقل الحضري ويقلل من التلوث.
وأشار بولحليب، إلى أن تكلفة إنشاء مشاريع النقل الجماعي تعد تحديا كبيرا، بالنظر للتكاليف الكبيرة لإنجاز البنية التحتية، حيث تبلغ تكلفة الكيلومتر الواحد من مشروع المترو حوالي 150 مليون دولار، ما يشكل ضغطا على الدول لتوفير التمويل اللازم، كما اقترح بدائل مثل حافلات النقل عالية الخدمة، بالإضافة إلى خدمة الترامواي التي تعد أقل تكلفة بمعدل 15 مليون دولار للكيلومتر، وفي ذات السياق، أوضح بأن الجزائر تواصل تنفيذ مشاريع الترامواي، حيث تمتلك خطوطا جاهزة تم تسليمها سابقا في الجزائر العاصمة، قسنطينة وهران وعدد من المدن الأخرى، و هناك 10 مشاريع جار تنفيذها حاليا، بما في ذلك مشاريع لتمديد الخطوط وفي هذا الإطار، ذكر أن ولاية قسنطينة ستشهد مشاريع لتوسيع الخط الحالي وتغطية الأقطاب العمرانية الحديثة.
الانتقال إلى القطارات عالية السرعة
وتعد السكك الحديدية عالية السرعة من أبرز وسائل النقل الحديثة التي تعتمدها الدول لتطوير شبكاتها وتحقيق نقلة نوعية في النقل بين المدن.
وتسعى الجزائر، لتطوير استراتيجياتها الخاصة عبر إنشاء خطوط سكك حديدية بسرعات تصل حاليا إلى 160 كيلومترا في الساعة، مع خطط مستقبلية للتوسع إلى 200 كيلومتر في الساعة، ومن أبرز المشاريع الحالية خط الجزائرـ وهران، إلى جانب خط ربط وهران بمغنية وسيدي بلعباس، بالإضافة إلى تمديد خط من الجزائر العاصمة إلى تمنراست خلال السنوات القادمة، مما يساعد على تحسين الربط بين المناطق الداخلية والساحلية وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أشار المتحدث إلى أنه ورغم الأهمية الكبيرة لهذه المشاريع فإن تكاليفها المرتفعة تمثل التحدي الأكبر، إذ تتطلب استثمارات ضخمة لبناء وصيانة البنية التحتية، مؤكدا أن الجزائر ملتزمة بتنفيذ خططها تدريجيا، حيث تسعى لتحقيق النقل السريع والمستدام.
نجاح تجربة تشغيل محركات الديزل باستخدام الزيوت النباتية
وتبدل الجزائر جهودا مكثفة لإيجاد حلول مستدامة لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي ومشتقات البترول، مع التركيز على البترول الطبيعي والهيدروجين الأخضر، وكشف ذات المصدر،عن وجود أبحاث تجرى في ولاية قسنطينة تخص تشغيل محركات الديزل باستخدام الزيوت النباتية، حيث أظهرت التجارب نجاح تشغيل محرك مصنع بوادي حميم بنسبة تصل إلى 50 بالمائة من هذا الوقود البديل، مما يظهر تقدم الجزائر في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالطيران، فأشار المتحدث إلى أن هناك خطط تناقش استبدال وقود الكيروسين التقليدي بوقود يعتمد على الزيوت النباتية، مع التوجه المستقبلي نحو استخدام محركات تعمل على الهيدروجين الأخضر أو البطاريات الهيدروجينية، كما يتوقع أن يصبح الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة مثل الكهرباء الشمسية وتقنية التحليل الكهربائي للماء، وقودا أساسيا بحلول العام 2050.
وأضاف، أن الجزائر تتعاون بشكل وثيق مع ألمانيا لتطوير هذه التكنولوجيا، حيث أبرمت عقودا لإنشاء شبكات أنابيب تمتد من الجزائر عبر سردينيا وإيطاليا وصولا إلى ألمانيا، لنقل الهيدروجين الأخضر، كما أشار إلى أنه وفي الآونة الأخيرة، تمت المطالبة بتمديد خط أنابيب إضافي يصل الجزائر بإسبانيا، كما أن هذه المشاريع تمثل فرصة استراتيجية للجزائر لتعزيز موقعها كمصدر عالمي للطاقة النظيفة، مع إمكانية تشغيل السيارات، الطائرات والغواصات باستخدام هذا الوقود المستدام.
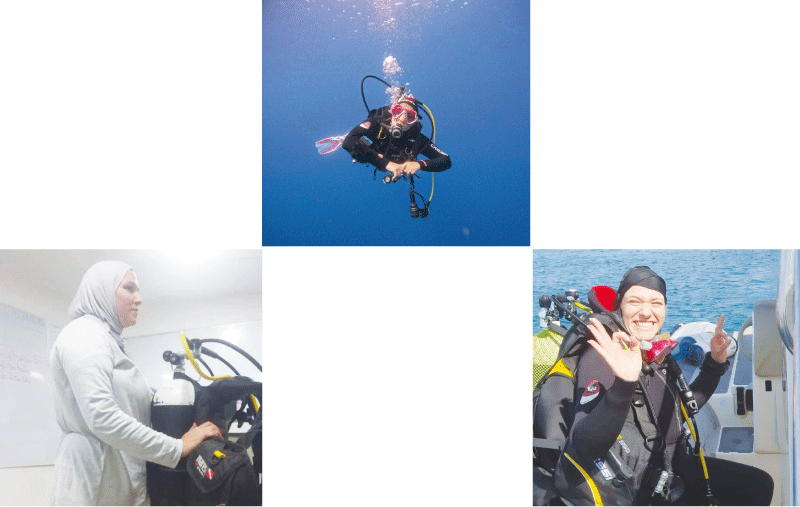
ميموني سعيدة ياسمين مهندسة في علم البحار وغطاسة
ثروات بحرية مذهلة يكتنزها الشريط الساحلي الجزائري
ياسمين ميموني، واحدة من الشابات اللواتي احترفن الغطس منذ ما يزيد عن 15 سنة، حبها لعالم البحار قادها لاختيار ميدان كان حينها حكرا على الرجال، والدراسة بالمدرسة العليا لعلم البحار وتهيئة الساحل بالعاصمة، أين تعلمت تقنيات الغطس المحترف واكتشفت عوالم البحر وسحر المحيطات، معززة تكوينها بالالتحاق بنادي المرجان للغطس بالعاصمة، لتكون أول شابة تلتحق به فاتحة بذلك باب الالتحاق للجنس اللطيف، معتبرة والدها أول من وضع خطواتها الأولى في هذا الميدان بعد أن لقنها مبادئ الرياضة، بتعلم السباحة في سن مبكرة، وممارسة كرة السلة، لتصبح اليوم من المدربات القلائل في الغطس، ومن الهواة المحترفين في تصوير قاع المحيطات، خاصة بالمواقع العذراء التي تكتنز، كما قالت ثروات بحرية مذهلة.
أسماء بوقرن
نشأتي في وسط رياضي كشفت مبكرا شغفي بالغطس
ياسمين ميموني، مهندسة دراسات في علم البحار وتهيئة الساحل ومدربة غطس بالجزائر العاصمة، متخرجة من المدرسة العليا لعلم البحار وتهيئة الساحل، تحدثت للنصر عن رحلتها نحو تحقيق حلم كبر معها، وقصتها مع عوالم البحار والمحيطات، قائلة بأن حبها للغطس وممارسة الرياضة لم يتأت بدراسة هذا التخصص وإنما راجع لنشأتها وسط أبوين يمارسان الرياضة، حيث كانت تلعب كرة السلة و تمارس السباحة منذ سنوات عمرها الأولى، ما جعلها تكتشف شغفها بالغطس مبكرا، وفي سنة اجتيازها شهادة البكالوريا زادت رغبتها في احتراف الغطس، خاصة بعد أن شاهدت في شريط إخباري وجود عدة شراكات مع جامعات كندية في مجال علم البحار والاحتباس الحراري، حيث كانت رفقة والدها وقتها، والذي اعتبر علم البحار من مهن المستقبل، ما جعلها تتحمس أكثر وتبذل جهدا لنيل الشهادة بتقدير جيد لدراسة التخصص، وهو ما تحقق لتبدأ بمجرد حصولها على البكالوريا رحلتها في البحث عن تخصصات في مجال علم البحار لتجمع بين هوايتها وتكوينها العلمي، فوجدت في المدرسة العليا لعلم البحار وتهيئة الساحل ما يحقق لها ذلك، فكان على رأس قائمة الخيارات، ليتم قبولها لتوفر كل الشروط فيها، وبعد انطلاق تكوينها بالمدرسة الذي دام خمس سنوات، اكتشفت أن طلبة المدرسة يخضعون خلال المسار الدراسي لتربص ميداني في الغطس، ما جعلها تتحمس أكثر ودفعها للبحث عن نادي متخصص في تعليم الغطس، لتباشر قصتها مع الغطس عندما كانت في السنة الثانية، وذلك سنة 2009.
نادي المرجان احتضنني كأول شابة تمتهن الغطس
وتعد الغطاسة ياسمين، أول المنخرطين في نادي المرجان للغطس بالعاصمة، معتبرة الوالد الداعم الأول لها وأول من عبد طريقها للإلتحاق بالنادي كما كان مرافقها الدائم إليه، حيث كانت البنت الوحيدة المنخرطة به، فاتحة بذلك الباب أمام شغوفات بالغطس واللواتي التحقن بسنة بعدها، وعن أول تجربة غطس، قالت بأنها لم تكن سهلة، ليس خوفا من الغوص في أعماق البحر وإنما لصعوبة تطبيق إحدى التقنيات، الناجمة عن ممارستها السباحة لسنوات، والمتمثلة في كيفية استعمال الأنف والفم في عملية التنفس، والتي تختلف تقنياتها عن تقنيات الغطس، ففي هذا الأخير يتم الاعتماد على الفم فقط في عملية التنفس دون استعمال الأنف، على خلاف السباحة التي يعتمد فيها على الأنف للتنفس، لكنها حاولت تخطي هذه العقبة بالتمرن المتواصل ومحاولة التعود على عدم استعمال الأنف، من خلال استعمال ملقاط لغلق الأنف لمدة معينة، مردفة بأنها غاصت على عمق 5 متر في أول تجربة بالعاصمة، لمدة 20 دقيقة، وتمت في ظروف جوية جيدة حيث كان الصفاء والدفء يطبع الجو، مع هدوء البحر ووضوح الرؤية في الأعماق، لتعيش لأول مرة تجربة رؤية الأسماك أمامها، بأحجام وألوان مختلفة.
تقول ياسمين بأنها كانت محظوظة للتعلم والتدرب على يد أمهر المدربين في نادي المرجان والذين وفروا كل الشروط الملائمة، التي لم تجعلها تشعر بكونها الفتاة الوحيدة بالمجموعة، وساعدها في التدرج في سلم رتب التخصص، من b1 إلى b3 ومن m1 إلى m3 وجعلها تلم بكل التقنيات وتحترف تطبيقها وتجيد تلقينها، وتبلغ رتبة مدرب محترف، وهي فترة توقفت خلالها لفترة وابتعدت عن الميدان، غير أن عشقها للبحر والغوص في عوالمه أعادها مجددا، مردفة بأن الإرادة أساس بلوغ المبتغى، والدليل قدوم سيدات بلغن العقد الخامس من العمر لتعلم الغوص، حيث خاضت التجربة سيدة في 64 سنة، والتي قررت تخطي عقبة الخوف وتحقيق حلمها، حيث كانت سعادتها لا توصف.
هذا ما يجب إتباعه لتجنب مخاطر الغطس
وعن الاحتياطات الواجب إتباعها لنجاح عملية الغطس وتجنب المخاطر، قالت بأنها ترتبط أساسا بالبرمجة المقيدة بطبيعة الفريق ومستواه، وتقوم أساسا على جملة من الشروط هي النوم الكافي ووضعية البحر، وهو شرط مهم جدا مرتبط بمدى وضوح الرؤية في الأعماق وهدوء البحر، فضلا عن مراقبة الوسائل والمعدات المعتمدة والتأكد من جاهزيتها، والاتفاق المسبق على نوع التقنية التي ستعتمد في الغطس، وتتغير بعض الشروط باختلاف مستوى الفريق، فالغوص مثلا مع فريق من المستوى الأول يتطلب شروطا معينة تتعلق أساسا بحالة البحر والذي يجب أن يكون هادئا للقيام بالتربص، أما في المستوى الثاني والثالث فيمكن الغوص عندما يكون البحر قليل الهيجان، وهذا يساعد في عملية التكوين ويضمن تحضيرا جيدا، لأن الغطاس يقع في وضعيات يكون فيها البحر هادئا عند الغطس وعند قرب موعد الخروج تتغير وضعيته، لهذا يجب، تضيف ياسمين، التحضير لكل الحالات، كما يجب وضع الفريق في حالة راحة مع تعزيز ثقة الأفراد بأنفسهم، وعن الأجواء التي تعشق الغوص فيها قالت بأنها تجد متعة الغطس عند تساقط الأمطار، المهم توفر الرؤية تحت الماء، معتبرة الغطس رياضة متكاملة وممتعة ومنبع الطاقة الإيجابية، خاصة وأنها تمارس ضمن مجموعة.
احترفت تصوير الكائنات البحرية وأطمح لفتح نادي لتعليم الغطس
وتختلف ميزة الغوص من جهة لأخرى عبر الشريط الساحلي الجزائري، حسب ياسمين، فعمق محيط العاصمة ليس ثريا جدا، مقارنة بشريط عين طاية وتيبازة الذي يزخر بالكائنات الحية والنباتات البحرية المتنوعة، كذلك الولايات الساحلية الشرقية، والغرب الجزائري، خاصة المواقع العذراء البعيدة عن الصيادين، فانبهار وإعجاب ياسمين بما يكتنزه البحر من كائنات حية جعلها تهوى توثيق كل ما تقع عليه عيناها، وممارسة شغفها في تصوير الحياة البحرية واحتراف هذه التقنية، مستغلة فرصة تدرب أحد المخرجين التلفزيونيين المعروفين عندها، في تعلم تقنيات التصوير الأساسية، والذي ساعدها كثيرا في تعلم خبايا الكاميرا سنة 2010، خاصة بعد تنظيم شابتين كانتا ضمن فريق الغطس وتعشقان التصوير الفوتوغرافي، تربصا للتصوير الفوتوغرافي البحري، على يد مختصين أجانب، حيث تعلمت تصوير المحيطات والكائنات الحية الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة باحترافية عالية.
وقالت، بأنها تعتمد على تقنيات علمية كذلك في التصوير البحري، لوضع الكائن الحي ضمن شروط راحة، مع تطبيق تقنيات التصوير، وتوفير الشروط اللازمة للأسماك، تبدأ بمقاومة الضغط وبتعويد الكائن المراد تصويره على وجودها مع استعمال معدل معين للتنفس لتجنب إخافته وضمان اطمئنانه، حيث هناك كائنات تحتاج لنحو 45 دقيقة للتأقلم والخروج من مخبأها للتمكن من تصويرها بزوايا مختلفة، مردفة بأن أجهزة تصوير الكائنات البحرية متوفرة غير أنها باهظة الثمن، وعن سبب عدم مشاركة صورها وفيديوهاتها متابعيها على مواقع التواصل أو تخصيص صفحة لذلك، قالت بأنها لا ترغب بذلك ولا في دخول الميدان الافتراضي، وتفضل ممارسة هذه الهواية للمتعة، كاشفة في ختام حديثها للنصر عن اعتزامها فتح ناد خاص لتعليم الغطس واستقبال كل الراغبين في عيش مغامرة الإبحار في قاع المحيطات والاستمتاع بكنوز الشريط الساحلي الجزائري المتنوع.

باحثة تطلق مشروعا رائدا
تستغل مخلفات معاصر الزيتون لصناعة مواد عازلة صديقة للبيئة
استغلت الباحثة في الطاقات المتجددة بالمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء في الجزائر، ماجدة موايسي، مخلفات معاصر الزيتون لصناعة مواد عازلة في البناء، صديقة للبيئة، وتساهم في تعزيز كفاءة الطاقة في البنايات.
إيمان زياري
ونجحت الباحثة التي تعمل أيضا بالتنسيق مع معهد "جوزيف ستيفان" للبحث العلمي بسلوفينيا، في تطوير فكرتها التي بدأت كمشروع لنهاية التخرج في ميدان تخصص الطاقات المتجددة بجامعة البليدة، لتحول ماجدة موايسي كل ذلك إلى مشروع بأبعاد أكبر وباسم "إيزوغرين"، سعت من خلاله لإخراج فكرتها إلى النور، خطوة مكنتها من إفتكاك الجائزة الأولى وطنيا خلال مسابقة تحدي المشاريع الإبتكارية في مجال البيئة في أسبوع المقاولاتية الخضراء، الذي أشرفت على تنظيمه الوكالة الوطنية للنفايات بإشراف من وزارة البيئة والطاقات المتجددة وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر المقام شهر ديسمبر 2022 بولاية سطيف.
إعادة تدوير النفايات العضوية
وتقول ماجدة أن تخصصها في مجال الطاقات المتجددة وجهها للبحث عن طرق من أجل إعادة تدوير النفايات العضوية الناتجة عن المعاصر والتي ترمى بشكل عشوائي في الغابات والوديان، مشكلة تهديدا للبيئة خاصة وأن نفايات الزيتون بعد العصر بما فيها النواة والبقايا لا يستغل منها سوى 20 بالمائة، فيما ترمى الـ80 بالمائة المتبقية عشوائيا في الطبيعة، بحيث تتحول المواد السائلة المتواجدة في الغشاء المحيط بالنواة إلى مواد سامة خطيرة، علما أن 1 لتر من هذه السوائل يلوث 600 لتر من مياه الوديان.
وعوضا عن رمي هذه النفايات بشكل عشوائي في الطبيعة، فكرت الشابة وسعت جاهدة لتطوير مشروعها البسيط ليصبح مشروعا بأبعاد كبيرة، كانت انطلاقته من مسابقة المديرية العامة للبحث العلمي بعد التخرج من الجامعة، أين فازت بالمرتبة الثالثة، لتوجه بعد ذلك إلى مركز البحث للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، أين تمكنت من تطوير مشروعها من خلال القيام بتجارب كثيرة أثبتت مطابقتها للمعايير الدولية، و بعد تجسيد الفكرة، تم وضع طلب براءة الاختراع، وإستفاد المشروع من علامة "لابل" كمشروع مبتكر من وزارة المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.
حلول اقتصادية وبيئية
وأضافت الباحثة، أن مشروعها وبالنظر لأهمية الحلول الاقتصادية والبيئية التي يقدمها، خضع لعمل مكثف، أين جرى تطوير المادة العازلة التي أنتجتها من نواة الزيتون تحت إشراف المركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، أين أجريت عمليات التركيب والاختبارات الأولى للألواح العازلة وذلك على مستوى المختبرات الوطنية لتعزيز الخصائص الفنية.
العمل على المشروع وتطويره لم يبق بحسب الباحثة على مستوى المركز الوطني، بل خضع لاختبارات أكبر في إطار تعاون خاص مع معهد "جوزيف ستيفان" بسلوفينيا، أين خضع لجملة من الاختبارات العلمية المتطورة، منها دراسة الخصائص الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية لتطوير المادة ودمجها مع مواد أخرى تزيد من فعاليتها، كما خضعت المادة لاختبار التوصيل الحراري وكثافة المادة، وذلك لتقييم فعاليتها في العزل الحراري.
صناعة محلية تدعم الاقتصاد الدائري
وعن مميزات الألواح العازلة التي تتم صناعتها من نواة الزيتون، أوضحت صاحبة المشروع ماجدة موايسي، أنها عبارة عن ألواح مصنعة جزائريا بمواد جزائرية لعزل البنايات حراريا وصوتيا، بحيث تشكل بديلا عن الألواح العازلة المستوردة، وقالت أن هذه الألواح تشكل نموذجا مثاليا للاقتصاد الدائري، فبالإضافة لكونها صديقة للبيئة، فهي تساعد في إقتصاد الطاقة من خلال التقليل من استخدام المكيفات والتدفئة بالمنازل، وبتقليص استهلاك الطاقة في المنازل يتقلص تلقائيا إنتاج الطاقة في محطات توليد الطاقة، ومنه تقليص إنتاج ثاني أكسيد الكربون الناتج عن ذلك.
أما عن تكلفة الإنتاج، فأوضحت موايسي أنها ستكون أقل مقارنة بأسعار المواد المستوردة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام الشركات الوطنية، ويخلق حركية بالمناطق التي تعرف بإنتاجها الوفير للزيتون وبمكان تواجد المعاصر، مضيفة أن المشروع يشكل مثالا مهما للمشاريع المبتكرة التي تعتمد على مخلفات عضوية، بما يعزز من الإبتكار في قطاع الفلاحة والبناء. وبعد حصول المشروع على براءة الاختراع، تواصل ماجدة السعي في مشروع يراهن عليه مركز البحث للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء، ليصبح قاعدة صناعية لمواد تستغل محليا وتنتظر دورها على قائمة المنتوج الجزائري الموجه للتصدير نحو الخارج قبل التفكير في مشاريع جديدة تدعم البيئة وتشكل قفزة نوعية في مجال الطاقات المتجددة بالجزائر.
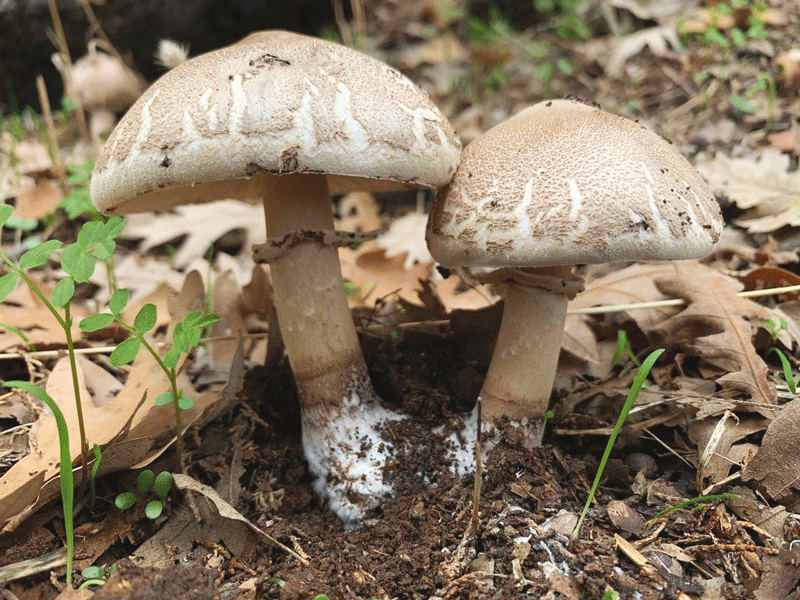
يعرف نشاط جمع الفطر البري وبيعه ازدهارا بالعديد من مناطق عنابة، حيث تحول مدخل مدينة برحال مثلا، إلى موقع هام لهذه التجارة الموسمية التي تستقطب شباب المنطقة في مثل هذا الوقت من السنة، خصوصا وأن الغلة وفيرة هذه السنة بعد أن تراجعت في فترات ماضية بفعل الجفاف.
وقد سمح الجو الخريفي الرطب بنمو هذا النوع من الفطر في التربة الخصبة بعد سنوات من الانقطاع الناجم عن الظروف المناخية، حيث ساعد الطقس المعتدل الممزوج بتهاطل معتبر للأمطار في نمو بعض أنواع الفطر، التي تزدهر بكثرة في المناطق المنخفضة وأخرى بالمرتفعات، حيث تحولت جبال الإيدوغ بسرايدي، هذه الأيام، حسب ما وقفت عليه النصر، إلى فضاء مفتوح لهواة جمع الفطر مع انتعاش الطبيعة، والتساقط الغزير للأمطار في فترات متفرقة بعنابة و ضواحيها.
حقوله تزدهر بجبال الإيدوغ
ويزد الإقبال على جني الفطر أو كما يطلق عليه محليا باللحم البري واستهلاكه، في فصل الخريف نظرا لقيمته الغذائية العالية، وكذا طعمه الطبيعي المميز، لكن عملية قطفه تتطلب دراية كافية من هواة جمع "الفقاع" بأنواعه لأنهم وحدهم قادرون على تحديد الأصناف القابلة للأكل وغير السامة، خصوصا وأن الفطر ينمو بشكل طبيعي وعشوائي عند سفوح جبال الإيدوغ، ولا يمكن لمن لا يملك خلفية عن أنواعه أن يفرق بينها و يتجنب النوع السام الذي قد يكون خطيرا ويتسبب في مضاعفات صحية معقدة جدا.
أثناء تواجدنا عند المدخل الغربي لمدينة برحال، وتحديدا على الطريق المحاذية للمنطقة الصناعية، لفت انتباهنا شباب يعرضون سلالا ودلاء تحتوي على كميات جيدة من الفطر البري الأبيض كروي الشكل من الأعلى، وقد لاحظنا لأن هذه التجارة نشطة جدا على امتداد الطريق خصوصا وأن عدد الباعة كان يتضاعف كلما تقدمنا أكثر، لدرجة أن سلالهم كانت تنتشر على طول كيلومترين كاملين.
وقد لاحظنا كذلك، بأن زبائن هؤلاء الباعة كثر، فالسيارات كانت تتوقف تباعا على حواف الطريق، وكان الناس مهتمين بتفحص الفطر والسؤال عن أسعاره وشراء كميات منه، وقد لفتنا بعض من كانوا عائدين إلى سياراتهم بأكثر من سلة واحدة من الفطر الطازج.
اقتربنا من أحد الباعة للسؤال عن طبيعة النشاط، فقال بأنه يشتغل في التجارة الموسمية، وأن الموسم حاليا يرتكز على بيع الفطر، الذي أوضح لنا بأنه يقطفه من المحمية الطبيعية فزارة.
أكد محدثنا، بأن النوع الذي يبيعه من الفطر لم يتوفر بهذا الشكل الكبير منذ سنوات بسبب الجفاف وتراجع مياه البحيرة، وبفضل تساقط الأمطار خلال أشهر سبتمبر أكتوبر ونوفمبر، نما مجددا وبكميات وفيرة جدا لأن نموه يرتبط بارتفاع درجة الرطوبة، والاستفادة من الأسمدة الطبيعية الناتجة على موت الأعشاب وتحولها.
وأضاف البائع المتجول، بأنه يجمع الفطر في هذه الفترة لكسب مصروفه مشيرا إلى وجود إقبال من الأشخاص الذين يعرفون كيفية استهلاكه وطهيه، كما يستفسرون حول النوع أيضا، لأن بعض الأنواع الموجودة في الطبيعة سامة، أما بخصوص الأسعار فأوضح لنا، بأنها مناسبة جدا وتتراوح بين 800 و 1000 دج للسلة الصغيرة.
تجارة ومتعة في أعالي سرايدي
في بلدية سرايدي تختلف الأجواء و تتسم بالمتعة، حيث تنخرط مجموعات في خرجات للغابات المجاورة للبحت عن الفطر، يتقدمهم رئيس البلدية علي راشدي، الذي يعد أبرز هواة جمع الفطر، وقد نشر عبر حسابه الرسمي صور لخرجة شارك فيها للبحث عن الفطر بغابة بوزيزي، أين تنمو أنواع مختلف من الفطر بالنظر إلى الطبيعة الجبلية الغابية للمنطقة التي تحتضنها جبال الإيدوغ، ما يمنحها خصائص مناخية تجعلها بيئة مناسبة جدا لنمو أجود أنواع الفطر البري.
و تتمتع الغابة المذكورة بسخاء أشجار البلوط التي تنمو في التربة الغضارية في المنحدرات، ويقول بعض هواة جمع الفطر الذين تحدثنا إليهم، إنه بعد غزارة الأمطار الأخيرة ثم عودة الجو الصحو و دفء أشعة الشمس، واعتدال معدل الرطوبة نمت براعم الفطريات بسرعة وبشكل كثيف، كما أنها سرعان ما نضجت وصارت قابلة للأكل في يومين فقط.
وأوضحوا لنا، أن نموها يكون سريعا إذا توفرت الظروف الملائمة كما يمكن قطف فطر " الڤرسال" حسب التسمية المحلية، من نفس شجرة البلوط عدة مرات، وأحيانا يلجأ المهتمون بهذا الفطر، إلى رش البراعم بالماء عند توقف هطول المطر حتى تعود للنمو من جديد، مع تغطيتها بمادة البلاستيك لأجل توفير الرطوبة اللازمة لمساعدتها على التشكل و ليتضاعف حجمها.
أما الأنواع الأخرى التي تنمو في التربة والتي تسمى "تمغليش" فيضيف محدثونا، بأنها لا يمكن أن تسقى كونها تنمو طبيعيا عند هطول مطر لفترة قصيرة، تأتي بعده الشمس على فترات متقطعة.
غلة تضم بعضا من أفضل أنواع الفطر
وعن أفضل الأنواع من ناحية الطعم، يشير الشباب الذين التقيناهم بغابة بوزيزي، بأن فطر "الڤرسال" يعد الأحسن من حيث الذوق، كونه ينمو في شجر البلوط، ويكون سميكا وعند طهيه قليا أو عن طريق الشواء مباشرة يصبح ألذ خصوصا إذار أضيفت له بعض البهرات المناسبة، وعلقوا بأن الفطر الجيد لا يختلف من حيت اللذة عن شريحة لحم، ويفرز الماء و لا يتفتت، عكس أنواع الفطر الأخرى سواء البرية أو التي يتم استزراعها والتي عادة ما تكون جافة ولا يمكن استطعامها إلا عند طهيها مع مواد أخرى كمقبلات أو سلطة.
ويشير محمد، وهو واحد من هواة جمع الفطر بالمنطقة، إلى أنه و مرافقيه اكتسبوا خبرة في كيفية التفريق بين الفطر الصالح للأكل والأنواع السامة، كما ورثوا بعض الأسرار عن رجال المنطقة الذين كانوا في زمن مضى ينشطون في مجال جمع وبيع ما تجود به الغابة من خيرات، حيث قدموا لهم نصائح تساعدهم على التمييز بين الفطر الصالح للأكل والسام عن طريق بعض الخصائص من اللون، فالفطر السام يكون عادة ذا لون قاتم من الأسفل أو يتخذ لونا أخر، أما الفطر الصالح للأكل فيكون أبيض اللون من الجهتين، ومع هذا يضيف محدثنا، لا يمكن لأي شخص لا يملك الخبرة والدراية الكافية التفريق بينهما بشكل كامل و اختيار ما هو صالح للاستهلاك وذلك ما يجعل عملية الجني صعبة لأن الخطأ قد ينتهي بالوقوع في متاعب بسبب النوع السام.
تحذيرات
ينتشر بسرايدي أيضا، بيع الفطر على قارعة الطريق، ويعتمد الشباب على هذه الغلة الطبيعية لتوفير مدخول جيد من تجارة موسمية لا تكلف الكثير و تدر ما يكفي لسد بعض الاحتياجات، و يعتمد الباعة المتجولون على طريقتين لعرض المحصول، إما عن طريق سلال بوزن كيلوغرام أو أكثر، أو من خلال عرض الفطر على غصن الريحان ليباع على شكل سيخ.
وقد أكد لنا باعة قابلناهم خلال استطلاعنا، أن للفطر البري الذي ينمو بسرايدي زبائن كثرا، يحجزون طلبيات لدى هواة جمعه للظفر بكمية كبيرة منه لما له من فوائد صحية، كما يفضله البعض على الفطر المُعلب الذي تدخل في إنتاجه مواد عضوية غير طبيعية، كما ينمو اصطناعيا في مستودعات.
ورغم الفوائد الصحية للفطر البري، يحذر الأطباء من استهلاكه دون دراية بنوعه، حيث أشار أطباء من المدينة أن ازدهار تجارته هذه الأيام، دفع ببعض الشباب إلى استغلال الوضع لعرض أنواع سامة، وهو ما انتهى بزبائن إلى مصلحة السموم بمستشفى عنابة، التي استقبلت عدة حالات تتعلق بتسمم أشخاص جراء استهلاك الفطر السام، ما تسبب لهم في مضاعفات خطيرة بلغت حد الإصابة بعجز كبدي حاد.
حسين دريدح
لحماية الأرواح في الدول النامية
اتفاق على مضاعفة التمويل في ختام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ
أنهت هذا الأسبوع، الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب29 " الذي احتضنته باكو بأذربيجان، رحلة المفاوضات واللقاءات باتفاق جماعي يقضي بضمان تمويل جديد لمساعدة البلدان النامية على حماية شعوبها واقتصادياتها من تأثيرات الكوارث المناخية، شريطة الوفاء بهذه الالتزامات لحماية الأرواح.
وجاء الاتفاق خلال فعاليات ختام أعمال المؤتمر الذي جمع قرابة 200 دولة في باكو، بعد مفاوضات مكثفة وعمل تحضيري استغرق سنوات، أين أنهى المشاركون والمتفاوضون أشغالهم بقرارات تقضي بمضاعفة التمويل المقدم للدول النامية وذلك بمعدل ثلاث مرات، أي رفعه من الهدف السابق المقدر بـ100 مليار دولار أمريكي سنويا، إلى 300 مليار دولار أمريكي سنويا بحلول العام 2035، مع ضمان جهود جميع الأطراف الفاعلة للعمل معا من أجل زيادة التمويل لصالح الدول النامية، من المصادر العامة والخاصة، بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويا بحلول عام 2035.
بوليصة تأمين تنتظر الوفاء بالوعود
وقال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، سيمون ستيل في ختام القمة:" لقد كان التقدم الذي أحرزناه في باكو صعب المنال... يعد هذا الهدف المالي الجديد بمثابة بوليصة تأمين للإنسانية، وسط تفاقم التأثيرات المناخية التي تضرب كل دولة، ولكن مثل أي بوصيلة تأمين فهي لا تعمل إلا إذا تم دفع الأقساط بالكامل وفي الوقت المحدد، يجب الوفاء بالوعود لحماية مليارات الأرواح".
واعتبر، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحافظ على نمو طفرة الطاقة النظيفة، مما يساعد جميع البلدان على المشاركة في فوائدها الضخمة، مشيرا في ذلك إلى توفير المزيد من الوظائف، إلى جانب تحقيق نمو أٌقوى وطاقة أرخص وأنظف للجميع.
وتأتي اتفاقية التمويل في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في الوقت الذي تصبح فيه خطط المناخ الوطنية الأٌقوى (المساهمات المحددة وطنيا) مستحقة من جميع البلدان العام المقبل، بحيث يجب أن تغطي خطط المناخ الجديدة هذه جميع الغازات المسببة للاحتباس الحراري وجميع القطاعات، للحفاظ على حد الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية في متناول اليد.
قرارات لم تخدم الجميع وإنجازات مهمة في تاريخ المؤتمر
وبحسب بيان صادر عن هيئة الأمم المتحدة، فإن هدف التمويل الجديد في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، يستند إلى خطوات كبيرة إلى الأمام في مجال العمل المناخي العالمي في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي وافق على صندوق تاريخي للخسائر والأضرار، ومؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي قدم هو الآخر اتفاقا عالميا للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بسرعة وعدالة، ومضاعفة الطاقة المتجدد ثلاث مرات مع تعزيز القدرة على التكيف مع المناخ.
وأقر المتحدث، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في باكو لم يلب توقعات جميع الأطراف، وأكد أنه لا تزال هنالك حاجة إلى المزيد من العمل في العام المقبل بشأن العديد من القضايا الحاسمة، وقال "لم تحصل أي دولة على كل ما تريده، ونحن نغادر باكو مع جبل من العمل الذي يتعين علينا القيام به"، وأردف "قد لا تكون القضايا الأخرى العديدة التي نحتاج إلى إحراز تقدم فيها عناوين رئيسية ولكنها شريان حياة لمليارات البشر، لذا فهذا ليس وقتا للتفاخر بالنصر، فنحن بحاجة إلى تحديد أنظارنا ومضاعفة جهودنا على الطريق إلى بيليم".
وقد سجل مؤتمر المناخ كوب 29 جملة من الإنجازات التي اعتبرت رئيسية بالنظر لتأثيرها المباشر على البشرية والكوكب، وفي مقدمتها تحقيق تقدم كبير فيما يتعلق بأسواق الكربون، وتحقيق التكيف بإنشاء برنامج دعم لتنفيذ خطط التكيف الوطنية لصالح البلدان الأٌقل نموا، مع الاتفاق على قرار بشأن النوع الاجتماعي وتغير المناخ، وتوسيع نطاق التعاون المعزز بين الأطراف والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إلى جانب انضمام المجتمع المدني والمنظمات دون الوطنية والشركات والشعوب الأصلية والشباب والعمل الخيري والمنظمات الدولية إلى قادة العالم في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون لتبادل الأفكار والحلول وبناء الشركات والتحالفات لخدمة وإنقاذ الكوكب.
إيمان زياري

شارك في تطويره مهندس بيئي من جامعة ورقلة
مشروع لإدارة النفايات الزراعية في المناطق الريفية
طوّر دكتور ومهندس في الهندسة البيئية من جامعة قاصدي مرباح بولاية ورقلة رفقة عدد من المختصين من جامعات خارجية مشروعا لمعالجة النفايات الزراعية في المناطق الريفية، إذ يستهدف بلورة إطار عمل شامل لإدارة هذه الأخيرة بشكل مستدام، مع تعزيز القيمة المضافة من النواحي الاقتصادية، البيئية والاجتماعية، معتبرا أنّ الجزائر تحوز على إمكانيات كبيرة لاستغلال الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة المتجدّدة.
وحاز مؤخرا المشروع الذي يحمل عنوان "الإدارة المستدامة للنفايات الزراعية في المناطق الريفية: خارطة طريق للاقتصاد الدائري والمعمل الحي" على جائزة أفضل مشروع بحثي مشترك بين جامعات عربية ودولية المقدّمة من قبل جامعة الأمير محمد بن فهد السعودية.
وقال المهندس والدكتور من جامعة قاصدي مرباح، هشام سيبوكر، عن المشروع الذي شارك في إعداده إنّه يعدّ ثمرة جهد لعدد من المختصين، فبالإضافة إلى شخصه فقد ضمّ كذلك 3 أعضاء آخرين يمثّلون كلا من الجامعة البريطانية في مصر وجامعتي "شقراء" بالمملكة العربية السعودية و"لينكولن" ببريطانيا، وأوضح المتحدّث أنّ العمل كان تشاركيا وتوافقيا بين مختلف الأعضاء خلال فترة إعداد المقترح المقدّم للمشاركة في المسابقة، مؤكدا أنّه سيتم الشروع في تجسيد المشروع على أرض الواقع، وفق مخطّط عمل أعدّ مسبقا.
ولفت، سيبوكر، أنّ المشروع يعتمد على عدّة محاور تتمثّل في التنمية المستدامة، اللوجستيات العكسية، إدارة النفايات وسلسلة التوريد، كذلك إعادة التدوير والاستخدام، ناهيك عن التقنيات الذكية، وأردف ذات المتحدّث أنّ العملية تشمل أيضا إنشاء مختبرات حية للاقتصاد الدائري بكل دولة مشاركة، بالتعاون مع الحكومة، قطاع الصناعة، الجامعات والمجتمعات المحلية.
ويهدف المشروع المطوّر إلى بلورة إطار عمل شامل لإدارة النفايات الزراعية بطريقة مستدامة، إذ يركّز على تحقيق أعلى قيمة ممكنة من المواد الخام وتقليل التكاليف الإجمالية، كما يسعى إلى تعزيز القيمة المضافة على المستويات الاقتصادية، البيئية والاجتماعية ويضيف المهندس، سيبوكر، أنّ المشروع يدعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يتماشى مع الرؤى الاستراتيجية المستقبلية لسنة 2030 بالنسبة للدول المشاركة، من بينها الجزائر، ذلك أنّ المشروع يراعي بحسب المتحدّث خصوصية جميع المناطق الريفية سواء بالجزائر، مصر أو السعودية، بغرض الوصول إلى وضع خارطة طريق تسمح بتسيير مستدام للنفايات الزراعية بالمناطق الريفية.
ويرى "سيبوكر" أنّ الجزائر تمتلك إمكانيات هائلة للاستفادة من الكتلة الحيوية كمصدر للطاقة المتجدّدة، مع زخم متزايد لتعزيز الطاقات النظيفة وكفاءة الطاقة، إذ تظهر الإحصائيات حسب المتحدّث أنّ البلاد تنتج حوالي 3.7 مليون طن من مكافئ النفط من الكتلة الحيوية القادمة من الغابات، كذلك 1.33 مليون طن سنويا من مكافئ النفط من النفايات الزراعية والحضرية، غير أنّه لم يتم استغلال هذه الموارد بشكل كاف.
ويضيف المتحدّث أنّ النفايات الصلبة تمثّل مصدرا كبيرا آخر للطاقة المتجدّدة بالجزائر، بحيث يصل إنتاج النفايات البلدية الصلبة إلى 11 مليون طن سنويا، زيادة إلى كميات كبيرة من النفايات الصناعية تقدّر بـ 2.5 مليون طن والنفايات الخطرة التي تبلغ 325 ألف طن سنويا، فيما تصل النفايات الطبية إلى 125 ألف طن خلال العام، هذا ما يوفّر فرصة كبيرة لتحويل هذه المخلفات إلى طاقة نظيفة.
وأوضح محدّثنا أنّ السياسات وخاصة اللوائح الصادرة عن وزارة الطاقة والمناجم تسعى إلى تعزيز الربط بين قطاعي الزراعة والطاقة، مما يسرّع من وتيرة استخدام الكتلة الحيوية، إذ يمثّل هذا التوجّه حسب "سيبوكر" خطوة اسراتيجية لتحفيز تطوير الطاقة المتجدّدة بالجزائر وتحقيق فوائد بيئية واقتصادية على المدى الطويل.
ولفت المتحدّث أنّ عملية إدارة النفايات الصلبة في الجزائر تظهر تحديات كبيرة، على اعتبار أنّ التخلّص منها يعتمد بشكل أساسي على أساليب غير مستدامة، بحيث يتم التعامل مع 97 بالمائة من النفايات المنتجة من خلال إحدى الطرق التي تشتمل على المكبات المفتوحة التي تستوعب حوالي 57 بالمائة من النفايات، الحرق في الهواء الطلق حيث يتم حرق 30 بالمائة من النفايات بمكبات غير مراقبة مما يسبّب تلوثا بيئيا، أما المكبات والمدافن الخاضعة للرقابة حسب ذات المتحدّث فلا تزيد عن 10 بالمائة، إذ تعتبر نسبة محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات الفعلية.
وتحدّث كذلك "سيبوكر" عن أنّ نسب الاسترداد وتثمين النفايات لا تزال ضئيلة، فإعادة التدوير تمثّل 2 بالمائة من النفايات، فيما لا يتجاوز التسميد 1 بالمائة بالرّغم من الإمكانيات الكبيرة للنفايات العضوية، وأردف المتحدّث أنّ تحسين إدارة النفايات في الجزائر يتطلّب التركيز على فهم تركيبها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية، كذلك تبني استراتيجيات شاملة تضم عمليات إعادة التدوير، التسميد واستخدام تقنيات حديثة لتقليل الاعتماد على الحرق والمكبات المفتوحة.
إسلام. ق

يأتي شهر نوفمبر بثقل عمل مناخي، تجسده ثلاث قمم عالية كبيرة للعمل على إنقاذ الكوكب وحل الأزمات بداية بـ «كوب29» من تاريخ 11 إلى غاية ـ22 من نوفمبر، وقمة «أبيك» لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادي، فضلا عن اجتماعين بالبرازيل لقادة مجموعة العشرين، لوضع رؤية جديدة مشتركة لحل القضايا الراهنة وتحقيق التوازن بين حماية الكوكب وإعادة بناء الاقتصاد.
مفاوضات شائكة في «كوب29»
بعد مرور أكثر من أسبوع من المفاوضات الطويلة والشائكة بين الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين للمناخ «كوب29»، لم يتمكن المشاركون بعد من تحديد هدف جماعي لمواجهة جملة المشاكل والأزمات التي تواجه الكوكب، وسط تحذيرات أممية من خطورة الوضع، فقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة في افتتاح الفعالية «من أن الوقت ليس في صالح القضية»، قائلا: «إن الصوت الذي تسمعونه هو صوت دقات الساعة، نحن في العد التنازلي الأخير للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، والوقت ليس في صالحنا».
واعتبر المتحدث، أن الوقت ليس في صالح العالم، مشيرا في ذلك إلى حجم التغيرات والتأثيرات التي تم تسجيلها خلال سنة 2024 والتي قال بخصوصها: « إن العام الجاري هو الأكثر حرارة على الإطلاق»، مؤكدا أنه لا يوجد بلد بمأمن عما أسماه بالدمار المناخي، الذي يتراوح بين الأعاصير وغليان البحار، إضافة إلى الجفاف الذي يدمر المحاصيل الزراعية، معتبرا أن تأثيرها يزيد التغير المناخي الذي سببه الإنسان.
فجوة التمويل تهدد البشرية
الأمين العام للأمم المتحدة عدد في كلمته 3 أولويات للعمل المناخي حول العالم، مؤكدا أنه :»يجب ألا تغادر البلدان النامية باكو خالية الوفاض»، حاثا على التركيز على ضرورة إجراء تخفيضات طارئة لانبعاثات بما مقداره 9 بالمائة كل عام، وصولا إلى 43 بالمائة من مستويات سنة 2019 إلى غاية سنة 2030، وكذا بذل المزيد من الجهد لحماية الناس مما أسماه «ويلات أزمة المناخ»، معلنا أن الفجوة بين احتياجات التكيف والتمويل يمكن أن تصل إلى 359 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، معتبرا أن كل دولار يتأخر عن الميزانية العمومية للعملية، تهديد لأرواح تزهق ومحاصيل تفقد وتنمية يحرم منها الأشخاص.
أما عن الأولوية الثالثة، فحددها غوتيريس، في هدم الحواجز أمام التمويل المتعلق بالمناخ، وذلك عبر الاتفاق على هدف تمويل جديد يتضمن زيادة كبيرة في التمويل العام الميسر، ومن خلال الاستفادة من مصادر تمويل مبتكرة، ووضع إطار عمل لزيادة إمكانية الوصول والشفافية والمساءلة وتعزيز قدرة الإقراض لبنوك التنمية متعددة الأطراف الأكبر والأكثر جرأة.
وحذر، من خطر التقاعس فيما يتعلق بعملية التمويل، قائلا :»يجب على العالم أن يدفع، وإلا تدفع البشرية الثمن»، وأردف «يجب أن تسترشدوا أنتم وحكوماتكم بحقيقة واضحة: تمويل المناخ ليس صدقة.العمل المناخي ليس اختيارا، إنه أمر حتمي».
أما الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، فعلق: «إن تأثيرات المناخ تقتطع ما يصل إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من البلدان»، بما يؤكد أن الكوارث الناجمة عن المناخ تؤدي إلى ارتفاع التكاليف على الأسر والشركات.
ودعا، قادة الدول المشاركين في القمة للإتحاد واتخاذ إجراءات جماعية سريعة قائلا: «دعونا لا نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى، إن تمويل المناخ هو تأمين عالمي ضد التضخم، وينبغي أن تكون التكاليف المناخية الباهظة هي العدو رقم 01».
التشغيل الكامل لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار
وفيما يتعلق بصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، دعمت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، التشغيل الكامل للصندوق، بما يمكن من البدء في صرف الأموال التي تشتد الحاجة إليها والتي طال انتظارها في أقرب وقت ممكن.
كما تم التوقيع على اتفاقية الوصي واتفاقية استضافة الأمانة بين مجلس إدارة الصندوق للاستجابة للخسائر والأضرار والبنك الدولي، فضلا عن اتفاقية البلد المضيف لمجلس إدارة الصندوق، بجمهورية الفلبين، لتشكل كل هذه الإنجازات نقطة انطلاق للصندوق في إطار تمويل المشاريع عام 2025.
كما أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون أمس كذلك، حوارا سنويا جديدا رفيع المستوى بشأن التنسيق والتكامل لترتيبات التمويل للاستجابة للخسائر والأضرار، والذي سيجمع أصحاب المصلحة من داخل وخارج عملية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وقد تطرق قادة الدول والحكومات في «كوب 29»، لعدة مواضيع في مقدمتها الحاجة إلى رفع الطموحات فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف من خلال المساهمات المحددة وطنيا، وخطط التكيف الوطنية، وكذا إستراتيجيات التنمية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، وتمكين العمل مع الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن المناخ، وغيرها من وسائل التنفيذ والدعم.
ضغوطات ومواجهات بين الدول الغنية والنامية
ولا تزال المواجهات تتصاعد بين الدول النامية والدول الغنية بباكو، أين تطالب الدول النامية والأكثر تضررا من تغيرات المناخ ومما تسببت فيه الدول الغنية الكبرى، بتخصيص 1.3 تريليون دولار سنويا لتمويل مكافحة تغير المناخ، الذي يمتد إلى غاية سنة 2030، وقد قال سكرتير الأمم المتحدة للمناخ سايمون ستيل،إن الطريق ما تزال طويلة بالرغم من أن الجميع يدركون تماما أن التحديات التي يواجهها العالم جادة.
وقد عرقل عدم التوصل لاتفاق فيما بين المتفاوضين، ضبط الشكل النهائي لخطة التمويل، بحيث لا تزال مسودة النص المعروضة على المؤتمر تحمل خيارات مفتوحة، في ظل استمرار ضغط الدول النامية على الدول الغنية لدفع ما عليها، خوفا من أي تقاعس من شأنه أن يعيق عملية الحل التي يراهن عليها المشاركون من الطرفين، خاصة وأن الدول النامية تطالب بتخصيص أكبر جزء من التمويل لصالحها.
وفي انتظار ما ستفرزه قمة المناخ «كوب29»، تتجه الأنظار إلى قمة مجموعة العشرين، علها تجد منفذا للطريق الذي سد في باكو، والتمكن من التوصل لحلول للمسائل المالية العالقة التي تشكل النقطة الحاسمة في قمم العالم الثلاث.
إيمان زياري

خبيرة السياسات البيئية والتنمية المستدامة الدكتورة منال سخري
ضمان التمويل المناخي مرهون بالالتزام والعالم ينتظر قرارات جادة
حذرت الخبيرة في السياسات البيئية والتنمية المستدامة، الدكتورة منال سخري، من خطر التهاون في التعامل مع قضايا البيئة والمناخ الراهنة، واعتبرت عدم الاستجابة لنداءات المنظمات وعدم الخروج بقرارات صارمة وعملية من قمة المناخ كوب29، كفيلا بمفاقمة أزمة كوكب الأرض، داعية لإيجاد حلول عملية للتعامل مع النفايات الإلكترونية عبر تشريعات بيئية دولية ملزمة، مؤكدة على توفر الالتزام وتغليب المصلحة العامة لضمان تمويل فعلي لضريبة التكيف المناخي، كما تحدثت عن مواضيع أخرى طرحت في كوب 29 بأذربيجان.
النصر: في قمة قادة العالم للعمل المناخي كوب 29 دعوة عالمية لإعادة تدوير 70 بالمائة من النفايات العضوية، إلى أي مدى يمكن تجسيد ذلك بالنظر للفروق بين الدول؟
الدكتورة منال سخري: الدعوة لتدوير 70 بالمائة من النفايات العضوية خطة وهدف طموح، إلا أن ذلك يصطدم بإشكالية التفاوت فيما بين الدول المتقدمة والمتخلفة، لأن الأمر يتعلق بالبنية التحتية وبمدى الاستثمار في هذا القطاع، ومدى فعالية الاقتصاد الدائري في هذه الدول، لاسيما الدول النامية.
ربما تقترب الدول الغنية من هذا الهدف بالنظر لبنيتها التحتية، لكن السائرة في طريق النمو ستصطدم بالفروق سواء من حيث السياسات والتشريعات المنظمة، أومدى وجود وعي بيئي بهذه المجتمعات وأمور أخرى خاصة التحدي اللوجيستيكي في هذا الشأن، وكلها عوامل تصعب من تحقيق الهدف بهذه الدول.
كشف تقرير مهم في المؤتمر، عن التخلص من 62 مليون طن من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية سنة 2022 مع توقعات بارتفاع النسبة بمقدار الثلث سنة 2030، أي دور للمنظمات العالمية في الحد من التأثيرات السلبية للنفايات الإلكترونية؟
لما نتحدث عن النفايات الإلكترونية، فنحن نتحدث عما ينجر عنها مباشرة، وعما يعرف بالتلوث الصامت أو التلوث الإلكتروني، وبالتالي فإن خفض هذه النفايات المرشحة للارتفاع من الأمور الملحة، خاصة عندما نتحدث عن المخلفات السامة كالزئبق والذي يتواجد بكثرة في الأجهزة الإلكترونية، وإن لم تتم معالجته بشكل صحيح، فهذا سيؤدي إلى تسربه في البيئة وتلوث المياه والتربية، وذلك يؤدي فيما بعد لتهديد الأمن البيئي و صحة الإنسان والحيوان.
المطلوب اليوم، هو الدفع بعجلة الابتكار والتكنولوجيا وتبني الحلول الفعالة على المستوى البيئي من جهة، وتلك التي تكون ذات أثر بيئي سليم كذلك، وهذا الأمر الذي يتطلب تشريعات بيئية دولية فعالة وملزمة على المستوى الدولي ككل، وهو ما يدفع لترسيخ تقنيات مستدامة للتعامل مع النفايات الإلكترونية.
تحذير أممي آخر عرفته الفعالية، وتمحور حول خطر ارتفاع درجة حرارة الكوكب فوق 1.5، هل تتوقعين استجابة دولية للعمل على خفض الحرارة، أم أن المعطيات تنبؤنا بكوارث أكبر مستقبلا في حال لم تلق هذه الدعوات ردودا؟
التحذير الصريح الذي أطلقه غوتيريس، بشأن درجة حرارة الأرض يعكس القلق الدولي المتزايد، وقد عبر صراحة في تصريح سابق عن الخطر المحدق بكوكب الأرض، وأعتقد أن الاستجابة ليست بإطلاق التحذيرات، بل يجب أن تكون لدينا إرادة سياسية وأمن مجتمعي دولي يجب أن يتماشى مع الالتزام واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيض الانبعاثات والتخفيف من آثار تغير المناخ.
لابد كذلك، أن يتماشى هذا الالتزام مع حجم التحديات العالمية، وإذا لم تتم الاستجابة للنداء، فالمستقبل سيحمل المزيد والكثير من الكوارث البيئية خاصة تداعيات وأبعاد اقتصادية وبيئية، فالبيئة ترتبط بالأمن القومي للدول وتحديدا الماء و الغذاء والطاقة.
تحدث المشاركون في «كوب29» عن حلول أسموها بالجديدة، لقضايا النزوح القسري والهجرة الناتجة عن التغيرات المناخية، كيف يؤثر هذا التغيير على حياة الناس، وما هي الحلول التي يمكن تبنيها لمواجهة الأمر؟
أجل تمحور الحديث عن النزوح والهجرة المناخية التي أثرت كثيرا على الأمن الإنساني في العديد من المناطق، فالهجرة المناخية كانت قسرا لأن الإنسان واجه أزمات بيئية مثل الجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستوى مياه البحر، والسكان الأصليون عموما هم الأكثر تضررا في هذه المناطق.
تبحث هذه المجتمعات عن أماكن تتوفر فيها الموارد، لأن تفشي الكوارث الطبيعية يهدد سبل العيش والأمن الغذائي والأمن المائي، كما يهدد الاستقرار ورفاه الإنسان، سواء كانت هجرة داخلية أو دولية، وهذه الأخيرة تحديدا دفعت بأناس للخروج من دولها، وأعتقد أنه من بين الحلول يمكن تطوير برامج دولية تدعم اللاجئين البيئيين، وتوفير إجراءات على مستوى الدول المتضررة التي أضحت اليوم مجبرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
نتحدث اليوم، ليس فقط عن الحد من التغيرات المناخية، بل عن التكيف معها كذلك، لذلك لابد من تعزيز الأطر التشريعية والسياسية والقانونية وحتى الأطر الاقتصادية خاصة الممارسات والتقنيات المستدامة في إطار الموارد المائية، والتي يكون لها الأثر الأكبر على المجتمعات المحلية، فالهجرات المناخية تحتاج فعلا لتحسين التنسيق الدولي، من خلال تفعيل التمويل لفائدة المجتمعات المتضررة، لكن للأسف الضرر تعدى المجتمعات التي تعاني من تغير المناخ، وبلغ المجتمعات والدول التي تستقطب الهجرات المناخية والبيئية، لذلك وجب توفير الموارد وإيجاد طريقة لحماية حقوق الأفراد من خلال مبدأ الفرص وضمان حياة كريمة.
أعيد في قمة أذربيجان طرح فكرة أسواق الكربون، وسط تسجيل توافق أممي حولها بعد 10 سنوات من ولادتها، ما هي الفكرة تحديدا؟ وهل سترى النور فعلا بعد انقضاء «كوب29»؟
أسواق الكربون فكرة معروفة، وهي في الملخص تدور حول تنظيم الانبعاثات عن طريق تبادل حقوق التلوث بين الدول والشركات، لقد تم إدخال الفكرة بشكل تجريبي في إطار اتفاقية كيوتو، ومع مرور الوقت تبنت العديد من الدول والشركات الفكرة كجزء من استراتيجية الحد من الانبعاثات.
هناك توافق أممي في «كوب» على أسواق الكربون سيما أن الهدف الدولي هو تقليل الانبعاثات وتحقيق الأهداف أقل من 1.5 درجة مئوية، لكن الأمر كتحد سيصطدم بمدى وجود تنظيم فعال، وهل هناك نوع من الشفافية لضمان خفض انبعاثات الكربون الحقيقي؟ وهل ستكون شفافية حقيقية وموثوقة في النتائج؟
من جهة ثانية، فإن السؤال عن جانب المسؤولية في تقاسم الفوائد مهم، وإن كانت ستقسم بين الدول الكبرى التي تعتبر المسبب الأول للانبعاثات وبين دول نامية لا تتسبب في الكثير منها، بمعنى أن الإشكالية تكمن في تقاسم المسؤولية والفوائد في هذه الأسواق، لا شك أن تجاوز هذه النقاط من المرجح أن يلعب دورا في السياسات العالمية.
توصف هذه الدورة بالحاسمة للتمويل المناخي، هل سيتم التوصل لاتفاق مجد برأيك؟
تعتبر مشكلة التمويل نقطة أساسية ومن أكبر التحديات التي طرحت في كوب 29 وكوب 28 قبلها، ولا ننسى أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبي، واليابان وبريطانيا، وكندا سويسرا، وأستراليا والنرويج وإيسلندا، تعهدت وفق اتفاقية الأمم المتحدة 1992 بدفع 100 مليار سنويا بحلول سنة 2020، و لكن هذا الهدف لم يتحقق إلا سنة 2022.
اليوم مبلغ التمويل ارتفع لأن ما يتوفر ماليا غير كاف، ولم يعد الحديث مقتصرا على اقتصاديات الدول المذكورة، بل على الاقتصاديات الكبرى الأخرى كذلك وعلى رأسها الصين، ودول الخليج وحتى الهند باعتبار هذه الدول من أكبر الملوثين في العالم. بالنسبة لفكرة التمويل كمبلغ، فهذا يتطلب تعاونا دوليا حقيقيا، وإذا كانت هناك إرادة لابد أن تتجسد على أرض الواقع، لأنه لابد من آليات الالتزام والرقابة لدعم الدول المتضررة، لأنها أكثر الدول تحملا لتبعات آثار التغير المناخي، لأن الاقتصاديات الكبرى دائما تراعي مصالحها الوطنية وتضمن الوصول لهذا الهدف.
من جهة أخرى، فإن الوصول إلى اتفاق عالمي يضمن تمويل أكثر من تريليون دولار سنويا سيكون أمرا صعبا، لأن التحديات المناخية في تزايد وكذا تحديات التمويل الدولي الذي يعتمد على وجود إرادة سياسية لدى الدول الكبرى والتزام لتحقيق هذا الهدف.
هل ستجسد الدول المشاركة التزاماتها المناخية، أم أن المصلحة الوطنية ستطغى على قضية التمويل؟
أعتقد أن ما يرهن هذه القضية هو التوازن بين المصالح الوطنية لهذه الدول والالتزامات الكبرى، هذا ما سيحدد مدى نجاح القمة في تحقيق الأهداف المناخية، تتضارب مواقف هذه الدول دائما بين التزاماتها الاقتصادية والتغيرات المناخية، والقرارات الجادة لدعم الدول المتضررة والعائق يبقى الالتزام وتحويل التوافق إلى حقيقة على أرض الواقع.
هل ستنجح الدول المشاركة في القمم البيئية الثلاث رفيعة المستوى التي جرت و ستجري هذا الشهر، في تحقيق التوازن وإنصاف المناخ والبشرية حسب تقديرك؟
إن انعقاد القمم الثلاث الكبرى في نوفمبر 2024، هو نتيجة حتمية للعديد من التحديات البيئية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وهذه القمم تشكل فرصة لدفع التعاون الدولي لحماية المناخ وتعزيز التنمية الاقتصادية، لكن نجاحها وفعاليتها يعتمدان على مدى قدرة الدول المشاركة على تجاوز خلافاتها وتوحيد جهودها في مواجهة التحديات المشتركة، وهذا يسمح بتحقيق توازن حقيقي بين إنقاذ المناخ وتلبية احتياجات البشرية، والأمر ليس سهلا في ظل الأولويات والتحديات المختلفة، لكن يبقى الأمل معقودا على تسجيل خطوات ملموسة تضمن التزامات مناخية فعالية تضمن سير الاستدامة الاقتصادية لاسيما في الدول السائرة في طريق النمو.
حاورتها : إيمان زياري

الخبيرة والمستشارة في شؤون المناخ الدكتورة زينب مشياش
المؤتمر لم يحقق هدفه الأساسي بعد
قالت الخبيرة والمستشارة في شؤون المناخ، الدكتورة زينب مشياش، إن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين المنعقد بباكو أذربيجان، يحمل في برنامجه كما هائلا من المواضيع المتعلقة بالمناخ والملحة جدا، إلا أن التفاوض والنقاش لم يخرجا عن دائرة ضيقة لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأنها، منتقدة تقاعس الدول الغنية بشأن قضية تمويل التكيف المناخي والتي تدفع ثمنها الدول النامية، متحدثة للنصر، عن عدم الأخذ بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة واستمرار المماطلة في حل مشاكل المناخ بشكل عاجل.
النصر: يهدف المؤتمر لوضع رؤية جديدة لمعالجة القضايا الملحة، بعد أسبوع كامل من اللقاءات والمفاوضات، هل سلطت القمة الضوء على أكبر وأهم قضايا الكوكب؟
الدكتورة زينب مشياش: أجل لقد كانت الانطلاقة قوية لمؤتمر الأطراف 29، فقد بدأ بقوة، حيث تم اعتماد قواعد سوق كربون جديدة تحت إشراف الأمم المتحدة (المادة 6.4 وفقا لمؤتمر باريس) في اليوم الأول، لكن التقدم لم يتواصل بنفس الوتيرة، فأكثر من 100 موضوع لم تدرج على جدول أعمال المؤتمر، كما أنه لم يتم تسجيل تطورات ملحوظة بخصوص التكيف والحصيلة العالمية، والخسائر والأضرار أو قضايا النوع الاجتماعي، ونتمنى أن يتحقق تقدم إيجابي في الأيام المقبلة.
ـ إلى أي مدى ستجد الدعوة لضمان تمويل عالمي سريع للعمل المناخي لحماية البشرية صدى في هذه القمة؟
نلاحظ أن دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لم تلق لحد الآن الصدى ولا النجاح ولا النتيجة التي كان يطمح إليها العالم، خصوصا بلدان الجنوب التي كانت تراهن كثيرا على هذا المؤتمر الذي يسمى أيضا بمؤتمر التمويل، أين كان ينتظر من الدول الغنية بحسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، أن تتحمل مسؤولية الأزمة المناخية تاريخيا وذلك عبر مساعدة الدول الأخرى من خلال تمويل جزء من انتقالها، فالدول المستفيدة تطالب بمبلغ 1300 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 13 ضعفا للمبلغ الحالي المخصص لانتقال هذه الدول والذي يعادل 100 مليار دولار سنويا، كما ينص عليه اتفاق باريس للمناخ، لكن المطلب لم يتحقق إلى غاية الآن في المؤتمر الحالي.
اعتبرت هذه الدورة حاسمة للتمويل المناخي، خاصة وأن المؤتمر قدم تقارير تشير للحاجة إلى أموال ضخمة لأجل التمويل وتغطية تكاليف التكيف هل برأيك سيتم التوصل لاتفاق دولي يضمن التمويل؟
سوف نرى ذلك خلال الأيام المقبلة، نتمنى أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، وكما قبلت دول الجنوب أن تتقاسم هذه المسؤولية المشتركة رغم التمايز، فعلى الآخرين أيضا الالتزام بموجب اتفاق باريس الخاص بالمناخ.
أشار السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سايمن ستيل، إلى أن ثمن تغير المناخ باهظ جدا، ويبرز في شكل زيادة التضخم وارتفاع في أسعار المواد الغذائية، كيف يؤثر ذلك على دول العالم وخاصة الجزائر؟ وهل نحن ملزمون فعلا كما قال بوضع خطط تكيف وطنية؟
التغير المناخي يؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي بمختلف دول العالم بدرجات متفاوتة، ومن بين التأثيرات نلاحظ الجفاف و ارتفاع درجات الحرارة وتكرار وطول مدة موجات الحر، ناهيك عن الكوارث المناخية التي يمكن أن تتلف آلاف الهكتارات من المحاصيل...وهذه كلها عوامل تؤثر في توفير المنتجات وفي أسعارها، علما أن المؤشر العالمي للأمن الغذائي للجزائر، صنف في مقدمة الدول الإفريقية وفي المرتبة 54 من أصل 113 دولة في العالم سنة 2021، إلا أن الجهود يجب أن تتواصل من أجل نجاح برامج وزارة الفلاحة.
حاورتها: إيمان زياري

تُعد تجربة الجزائر في إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية، واحدة من المبادرات البيئية الهامة، التي تهدف إلى استعادة التوازن البيئي في حوض البحر المتوسط، خاصة في ظل التدهور الناتج عن التلوث والصيد الجائر والتغيرات المناخية.
لينة دلول

ويؤكد مختصون للنصر، أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في استعادة التوازن البحري، وحماية السواحل من التآكل، إضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية مثل الصيد والسياحة البحرية، وزيادة إنتاجية الأسماك، بما يعود بالفائدة على المجتمعات الساحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
ويذكر أن الجزائر، بدأت هذه التجربة في أوائل العقد الأول من القرن 21، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع لإنشاء شعاب مرجانية اصطناعية باستخدام مواد متنوعة مثل الخرسانة، والفولاذ، وأسطوانات فولاذية، وأحيانا حتى السفن القديمة و ذلك في المناطق البحرية التي تحتاج إلى دعم بيئي لتحفيز نمو الكائنات البحرية.
ومن أبرز المناطق التي عرفت تنفيذ مشاريع شعاب مرجانية اصطناعية ساحل تيبازة و عين طاية وعين بنيان، حيث تم إنشاء العديد من الهياكل الاصطناعية التي تساهم في تنمية الحياة البحرية.
ورغم نجاح بعض هذه المبادرات في تعزيز الحياة البحرية، أكد المختصون أن التحديات لا تزال قائمة، خصوصاً في مواجهة التلوث البحري، والصيد الجائر، وتأثيرات التغيرات المناخية التي تظل تهدد فعالية الشعاب المرجانية الاصطناعية، وبالتالي يتطلب الأمر المزيد من الجهود والابتكار لحماية البيئة البحرية وضمان استدامة هذه المشاريع المهمة في الجزائر.
* عضو الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البحرية مراد حرز الله
الشعاب الاصطناعية تحمي السواحل من الـتآكل
أكد موثق ومستكشف الحياة البرية في الجزائر وعضو الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية مراد حرز الله، أن الشعاب المرجانية الاصطناعية هي هياكل من إنتاج الإنسان تُصنع لأهداف بيئية معينة، باستخدام مواد متنوعة مثل الخرسانة والمعادن وأحيانا المواد المعاد تدويرها ، على غرار المقطورات والسفن القديمة، مضيفا أنه تتم تنقية هذه المواد من البلاستيك والملوثات الأخرى قبل وضعها في قاع البحر، من قبل خبراء ومتخصصين.
وأوضح المتحدث، بأن الهدف من هذه الهياكل هو توفير بيئات ملائمة لنمو الكائنات البحرية وتحفيز استعادة التوازن البيئي في المناطق المتدهورة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي البحري ودعم الاستدامة البيئية في المناطق الساحلية.
وبالأخص حماية حياة الأسماك والقشريات التي تعتمد على هذه البيئات كموطن لها، متابعا بالقول بأنه يمكن أن تصبح الشعاب الاصطناعية وجهة سياحية وترفيهية، مشابهة لتجارب سياحية في مناطق أخرى مثل فلوريدا وشرم الشيخ، حيث تُستخدم هذه الشعاب كأماكن للغوص الرياضي، مما يعزز السياحة البحرية ويعود بالفائدة الاقتصادية على المجتمعات المحلية.
وأوضح الخبير، بأن الشعاب المرجانية الاصطناعية تساهم كذلك بشكل فعال في حماية السواحل الجزائرية من التآكل، وذلك من خلال توفير حواجز تحت الماء تمنع تأثير حركة المد والجزر العاتية، ما يساعد على تقليل التآكل الساحلي ويحمي المناطق المنخفضة من التدمير. وأشار المتحدث، إلى أن أغلب المشاريع التي أُقيمت في الجزائر تعتبر صغيرة نسبيا مقارنةً بالمشاريع الضخمة التي استثمرت فيها أموال طائلة في دول أخرى، إذ أن العديد من هذه المشاريع في الجزائر تفتقر بحسبه إلى الحجم والموارد التي تضمن استدامتها على المدى الطويل، في حين أن الدول الأخرى قد استثمرت مبالغ ضخمة في إنشاء شعاب مرجانية اصطناعية كبيرة تحقق نتائج بيئية واقتصادية ملحوظة. وقال المتحدث، بأنه عندما يتم تنفيذ هذه المشاريع، يتم اختيار المواد بعناية لتكون قابلة للتحلل البيولوجي بمرور الوقت، دون أن تشكل تهديدا للبيئة.
مشروع «بيت البحر»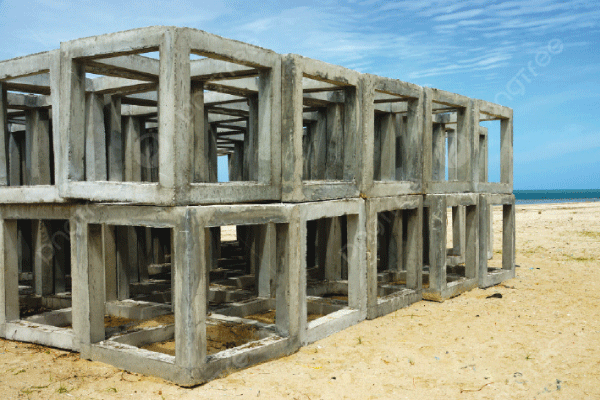
وأشار المتحدث في سياق منفصل، بأنه في عام 2017، قامت جمعية "هيبو سيب" المتواجدة في عنابة، بتنفيذ مشروع "بيت البحر" وتم تجديده في 2021، وهو من بين أكبر المشاريع البيئية في ولاية عنابة وفي الجزائر بشكل عام، بهدف حماية الثروة الحيوانية في الشعاب المرجانية من خلال إنشاء هياكل اصطناعية، تساعد على استعادة التوازن البيئي وتحفيز الحياة البحرية.
وأكد الخبير، بأنه وبفضل جهود الجمعية في تنفيذ هذا المشروع الضخم، تمكنوا من تحقيق نتائج ملموسة في إعادة الحياة البحرية في بعض السواحل الجزائرية، خاصة في المناطق التي كانت تعاني من تدهور كبير في النظام البيئي البحري، كما حصلوا على جوائز مرموقة في البحر المتوسط تقديرا لإسهاماتهم في مجال حماية البيئة البحرية وتحسين التنوع البيولوجي.
وأكد حرز الله، بأن هناك عدة أنواع من الشعاب المرجانية الاصطناعية، كل منها يهدف إلى تحقيق أهداف بيئية مختلفة، بعضها تدعم التكاثر البحري، حيث توفر بيئات ملائمة لتكاثر الأسماك والقشريات والكائنات البحرية الأخرى، وتساعد في تجديد المخزون السمكي. وأخرى تهدف إلى منع الصيد الجائر من خلال توفير مناطق محمية، حيث تعمل كحواجز تمنع وصول الصيادين إلى نقاط بحرية معينة، وبالتالي توفر حماية أفضل للشعاب الطبيعية وللحياة البحرية من الممارسات غير المستدامة.
هكذا يتم اختيار المناطق التي توضع فيها الشعاب الاصطناعية
وأوضح الموثق، أنه يتم اختيار مواقع إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية بناء على الاحتياجات البيئية المحددة لكل منطقة، على سبيل المثال، إذا كانت منطقة معينة تحتوي على شعاب مرجانية طبيعية تعرضت للتدهور بسبب التلوث أو الأنشطة البشرية، فإنه تتم إعادة تأهيلها باستخدام الشعاب الاصطناعية لاستعادة الحياة البحرية فيها، و يتم هذا العمل بالتعاون مع أخصائيين في البيئة البحرية، يحددون المناطق المناسبة التي تحتاج إلى شعاب مرجانية لحمايتها وتعزيز التنوع البيولوجي فيها. 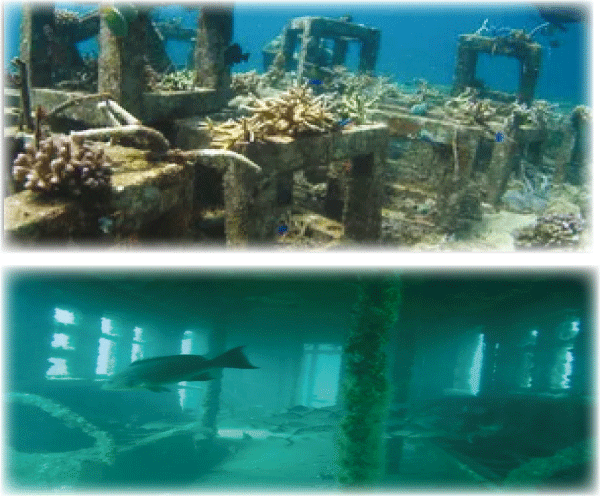
متابعا بالقول، بأن هناك عدة تقنيات لتسريع نمو الكائنات البحرية في الشعاب المرجانية الاصطناعية، ومن أبرزها اختيار البيئات المناسبة التي تتوافق مع حركات المد والجزر، لأنها تلعب دورا مهما في تغذية الكائنات البحرية التي تعيش في الشعاب، حيث إن معظمها يعتمد على العوالق البحرية كغذاء أساسي.
ويتطلب تحديد كثافة وحجم الشعاب المرجانية الاصطناعية بحسب الخبير دراسة شاملة للبيئة البحرية المستهدفة، لضمان توفير بيئة بحرية مناسبة تحقق التوازن البيئي المرغوب، تشمل قياس درجة حرارة المياه، وقوة التيارات البحرية، ودرجة الملوحة، ومستويات الإضاءة تحت الماء.
بالإضافة إلى ذلك، يجب فحص الكائنات البحرية المستهدفة بالتعاون مع مختصين في البيئة البحرية، لتحديد الأنواع التي يمكن أن تستفيد من هذه الشعاب، مشيرا في ذات السياق إلى أن الدراسات تساعد في ضمان قدرة الشعاب الاصطناعية على توفير موائل مناسبة لنمو وتكاثر الكائنات البحرية، مما يساهم في استعادة التنوع البيولوجي ودعم الاستدامة البيئية في المناطق المتدهورة.وأكد الخبير، أن التمويل من أبرز التحديات التي تواجه إنجاز مشاريع الشعاب المرجانية الاصطناعية، لأن إنشاءها يتطلب استثمارات كبيرة في البحث والتصميم والتنفيذ، بالإضافة إلى أن مفهوم الشعاب الاصطناعية يعتبر جديدا نسبيا في المجتمع الجزائري، مما يؤدي إلى نقص في الوعي العام حول أهميتها وفوائدها البيئية والاقتصادية.
* زرقوط جمال خبير في الثروة البحرية
من الأولويات الهامة لمواجهة التغيرات المناخية
من جهته، أكد رئيس جمعية التنمية المستدامة والسياحة البيئية، الخبير في الثروة البحرية جمال زرقوط ، أن الهدف الرئيسي من إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية في الجزائر هو توفير حل فعال لحماية السواحل من التآكل الناجم عن الأمواج والتيارات البحرية، وذلك لأن هذه الشعاب تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستقرار البيئي للبيئة البحرية السطحية، كما توفر بيئة ملائمة للكائنات البحرية وتدعم استعادة الأنظمة البيئية المدمرة.
علاوة على ذلك، فهي تسهم في حماية المنشآت الساحلية مثل الموانئ والطرق الساحلية من التأثيرات الضارة للعوامل البحرية، مما يجعلها أداة مهمة في إدارة الساحل وحمايته من التغيرات المناخية وظواهر المد والجزر العنيفة.
كما تسهم الشعاب المرجانية الاصطناعية كما أوضح الخبير، في توفير بيئة مناسبة لنمو الشعاب المرجانية الطبيعية، مما يعزز قدرة السواحل على التكيف مع التغيرات المناخية، وتعد هذه المهمة بحسبه من أهم الأولويات في الوقت الراهن، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت التغيرات المناخية تشكل ظاهرة متطرفة تؤثر بشكل كبير على الأنظمة البيئية البحرية، من خلال ارتفاع درجات حرارة المياه والحمولة الزائدة من ثاني أكسيد الكربون.
وأضاف المتحدث، بأن المنطقة الشرقية من الجزائر، خاصة في مدينتي سكيكدة والقل، تعتبر بمثابة "أمازون الجزائر" بفضل تنوعها البيولوجي البحري الغني، لذا يعدّ إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية خطوة حيوية لحماية هذا التنوع وضمان استقراره للأجيال الحالية والمستقبلية.
يجب إشراك المجتمع المحلي في حماية الشعاب الاصطناعية
وبحسب زرقوط، فإنه بعيدا عن الفوائد الاقتصادية لهذه الشعاب الاصطناعية، فإن الجانب البيئي يعد أكثر أهمية بالنسبة للسكان المحليين على طول الشواطئ، لكونها تعود بالفائدة على المجتمعات الساحلية سواء من حيث الموارد الطبيعية أو من خلال تعزيز السياحة البيئية، بالتالي فإن حماية الشعاب المرجانية كما عبر، تعتبر إستراتيجية محورية على المستويين المحلي والوطني، كونها تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي وحماية السواحل من التآكل والظواهر المناخية المتطرفة.
وشدد المتحدث، على ضرورة الحفاظ على الشعاب المرجانية الاصطناعية وتثمينها، و تعزيز الجهود المتعلقة بتطوير الدراسات والخبرات في هذا المجال، و توجيه برامج تدريبية وتكوين متخصص للسكان المحليين حول كيفية استخدام هذه الشعاب والحفاظ عليها.
مؤكدا في ذات السياق، أن إشراك المجتمع المحلي في حماية هذه الشعاب والاعتناء بها يعتبر خطوة أساسية لضمان استدامتها، وهو ما يساهم بشكل مباشر في الحفاظ على توازن البيئة البحرية، ويضمن استمرارية الموارد البحرية التي يعتمد عليها السكان في رزقهم اليومي.
فوائدها الاقتصادية
وتتمثل الفوائد الاقتصادية المتوقعة من إنشاء الشعاب المرجانية الاصطناعية، في تأثيراتها الإيجابية على الحياة البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، فهي بمثابة بيئة مثالية لتوفير الغذاء والمأوى للأسماك، مما يعزز تنوع الأنواع البحرية ويحفز النمو الطبيعي للشعاب المرجانية الأصلية، هذه البيئات الاصطناعية تعمل كمناطق جذب للأسماك، التي تجد فيها حماية وغذاء، مما يقلل من هروبها إلى الأعماق البعيدة ويزيد من كثافتها في المياه الضحلة.
من الناحية الاقتصادية، يساعد هذا التزايد في أعداد الأسماك في تسهيل عمليات الصيد التقليدي والتجاري، حيث تصبح الأسماك أكثر توافرا في المناطق القريبة من السواحل، مما يعود بالفائدة على الصيادين المحليين.
وأشار زرقوط، إلى أن هناك نقصا ملحوظا في الجانب التحسيسي بأهمية الشعاب المرجانية الاصطناعية والطبيعية، ما أدى إلى تجاهل دورها الحيوي في الحفاظ على التوازن البيئي، منوها بأن القضاء على هذه الشعاب، سواء كانت اصطناعية أو طبيعية، تترتب عليه مخاطر كبيرة على البيئة البحرية بما في ذلك تدهور نوعية المياه، فالشعاب المرجانية بحسبه، تلعب دورا أساسيا في تنقية المياه من الملوثات وتوفير بيئة ملائمة للكائنات البحرية، وأي تدمير لها يؤدي إلى اضطراب في النظام البيئي وزيادة تلوث المياه، ما ينعكس سلبا على التنوع البيولوجي وصحة البيئة البحرية بشكل عام.
ل.د
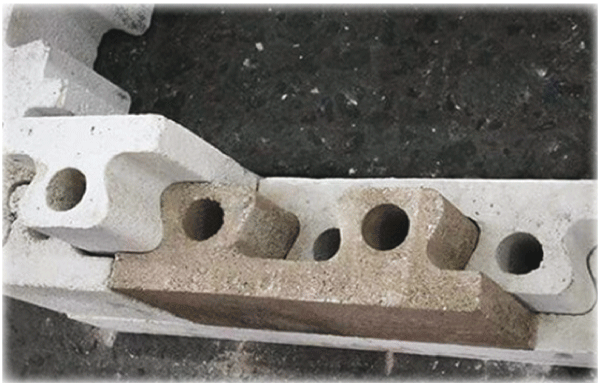
خبير البيئة كريم ومان يدعو الشركات الجزائرية للاستفادة منها
تجربة رائدة في إنتاج مواد بناء من البلاستيك المسترجع
طورت شركة كندية ناشئة مواد بناء مقاومة، تتكون من البلاستيك المسترجع وفق تقنيات جديدة تفتح المزيد من الآفاق على قطاع النفايات، الذي يثير قلق حماة البيئة و قادة العالم الذين يواجهون تحديات كبيرة لحماية الكوكب من البلاستيك الذي غزى البر و البحر.
فريد.غ
و قال خبير البيئة الجزائري كريم ومان، و المدير السابق للوكالة الوطنية للنفايات، بأن الشركة الناشئة الكندية تقدم لنا اليوم مثالا يحتدى به، من خلال تطوير مواد بناء تتكون من أكثر من 90 بالمائة من البلاستيك المعاد تدويره، مضيفا بأن هذه المواد ليست فقط صديقة للبيئة ولكنها أيضا تقدم خصائص فريدة مثل المقاومة للطقس، وخفة الوزن، والعزل الحراري الفائق.
و يعتقد كريم ومان المهتم بشؤون البيئة بالجزائر و العالم، بأن هذا الابتكار الجديد ليس عصيا على العقول الجزائرية، مؤكدا بأنه على قناعة بأن برنامج رئيس الجمهورية الطموح في قطاع السكن هو فرصة للاستثمار في هذا المجال الحيوي المنتج للثروة و مناصب العمل.
و يمكن للشركات الناشئة والمستثمرين الجزائريين، الذين يسعون لتحويل الأفكار إلى حلول مبتكرة في إدارة النفايات، الاستفادة من التجربة الكندية و تحويل الكم الهائل من النفايات البلاستيكية إلى مواد بناء مستديمة و منخفضة الثمن، لكن البداية حسب خبير البيئة الجزائري تمر عبر وضع التشريعات والمعايير الضرورية، و تحيين دفاتر الشروط العمومية حتى تكون محفزة علي استعمال مواد البناء المنتجة من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها.
و قال موقع أخبار القارة الأوروبية «يو.سي. نيوز» بأن الشركة الكندية «كاربيكريت» ابتكرت خلطة بناء دون اسمنت، يمكنها أن تكون حلا بيئيا للتغير المناخي، حيث تعمل على امتصاص الكربون وإنتاج مواد ثانوية يمكن استخدامها في الصناعة، ما أهلها للحصول على براءة اختراع.
و يدخل الإسمنت كمكون أساسي في خلطات الخرسانة التقليدية الأكثر استخداما في عمليات البناء والتشييد، ولكنه يسبب انبعاثات بنسبة 8 % من ثاني أكسيد الكربون.
و قال «يوري ميتكو”، مدير التسويق في الشركة بأن إنتاج طن واحد من خلطة (كاربيكريت) الجديدة يسمح بإزالة 150 كلغ من ثاني أكسيد الكربون من الجو.
و تمتاز التقنية الجديدة بالتقاط ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم وتحويله إلى كربونات الكالسيوم، التي تملأ فراغات مادة البناء وتعطي الخلطة قوتها، ما يجعل وحدات البناء الناتجة سالبة كربونيا.
وصمم الباحثون خلطة البناء الجديدة لتصبح مكونا أساسيا في عمليات تشييد وحدات مستدامة ومواد بناء مسبقة الصنع أقوى وأقل تكلفة مقارنة بالبدائل التقليدية المعتمدة على الإسمنت.
و تقدم الشركة الكندية دعما تقنيا وعلميا لشركات صناعة خلطات البناء بهدف استبدال تقنياتها الحالية بالتقنية الجديدة المستدامة. و استفاد الباحثون من مادة تسمى “خَبث الحديد” في ربط مواد الخلطة كبديل عن الإسمنت، ثم عرضوا الخلطة إلى ثاني أكسيد الكربون بدلا من الحرارة والبخار في غرفة معالجة مغلقة.
و يمكن لاستخدام “خَبث الحديد” الذي يُنظر له على أنه نفايات، في صناعة خلطة البناء، أن يجعل تكلفتها منخفضة مقارنة بالخلطة التقليدية التي تعتمد على الإسمنت.
و تخطط الشركة لبدء الإنتاج قريبا ليصل إلى 250 ألف وحدة من الخلطة الجديدة في اليوم، بالتعاون مع شركة كندية أخرى مصنعة لمواد البناء، و سيكون بلوك البناء الجديد متوفرا تجاريا حول العالم.
وتسعى الشركة الكندية المبتكرة الى بناء أول منشأة لإنتاج الخلطة بواسطة التقنية الحديثة بشكل تجاري وعلى نطاق واسع، ما يشجع الشركات الأخرى على استبدال التقنيات الحالية المعتمدة على الإسمنت التقليدي.
و يشهد العالم تحولا مذهلا في استرجاع و تدوير النفايات البلاستيكية، حتى وصل هذا الجهد الى إنتاج مواد بناء من هذه النفايات التي تكتسح العالم، ولم يجد لها حلا نظرا لعمرها الطويل ومقاومتها للتحلل السريع بالوسط الطبيعي. وتستهلك الجزائر كميات ضخمة من مواد البناء التقليدية سنويا، لإنجاز مشاريع كبرى بقطاعات السكن و الطرقات و المياه، حيث يعد الاسمنت المكون الرئيسي لهذه المواد، و حان الوقت، حسب خبراء البيئة، للاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجال التحول إلى مواد بناء صديقة للبيئة والإنسان و أقل تكلفة وأكثر استدامة.

تتميز بغطاء نباتي ومدعمة بمنزل غابي حديث
غابة الشطابة رئة قسنطينة
تعتبر غابة الشطابة الواقعة بين بلديتي عين سمارة وبن زياد الرئة التي تتنفس بها ولاية قسنطينة، نظرا لمساحتها الشاسعة وتنوع غطائها النباتي، ما جعلها تستفيد من جملة من المشاريع على غرار تهيئة المسالك المضادة للنار، وإعادة تهيئة المنزل الغابي الواقع بها والذي يضمن لأعوان محافظة الغابات أداء عملهم في ظروف مثالية.
وتقع غابة الشطابة في موقع استراتيجي جعلها الرئة التي تتنفس بها قسنطينة، بين بلديتي عين سمارة وبن زياد، غرب الولاية، وتتميز هذه الغابة الطبيعية بغناها بالحيوانات والنباتات البرية، وتقع على مساحة تبلغ 2300 هكتار، مسيرة من طرف محافظة الغابات بالخروب، بحدود غابات الخروب بمنطقة عين سمارة وبحدود غابات زيغود يوسف بمنطقة بن زياد. واستفاد هذا المكسب الطبيعي بالولاية، من دعم بمشاريع لانجاز هياكل من أجل ضمان أفضل الظروف لأعوان محافظة الغابات التي تشرف على تسييرها، والبداية كانت بانجاز منزل غابي بمساحة 750 مترا مربعا أنشئ لأول مرة سنة 1965، ليعاد ترميمه سنة 2024، ويظهر بأبهى حلة، خاصة وأنه يتوفر على عدد معتبر من الغرف بموقع عالي مطل تقريبا على كل الغابة.كما استفادت الغابة من مشاريع أخرى من أجل السماح لمختلف العائلات بالتواجد بها والاستمتاع بمناظرها الطبيعية الخلابة، وفي نفس الوقت لتسهيل مهمة أعوان محافظة الغابات أو الحماية المدنية في أداء عملهم على أكمل وجه، وكذا الاستفادة من أشجارها المثمرة ومساحتها الشاسعة، وتتمثل أبرز المشاريع في أشغال زراعة الغابات على مساحة 1259.5 هكتار، وتهيئة المسالك على مسافة 37 كلم، إضافة إلى تهيئة خنادق مضادة للنار على مساحة 61 هكتارا وتهيئة برج مراقبة سنة 1982 على مساحة 19 مترا مربعا، ليكون آخر مشروع أنجز بها هو عملية إعادة ترميم وتهيئة المنزل الغابي. وتتميز غابة الشطابة بثروة حيوانية، وتعتبر موطنا لعدة حيوانات على غرار الضبع، الذئب، الخنزير، ابن آوى وغيرها، نظرا لعدد الفضاءات الكبير المخصص لأصناف مختلفة من الحيوانات، متمثلة في 15 فضاء أو مساحة للثدييات و190 فضاء للطيور و15 منطقة للزواحف و10 مناطق للبرمائيات و273 فضاء للمفصليات و21 فضاء للعناكب و11 فضاء للرخويات، وهو ما يؤكد التنوع الحيواني بهذه الغابة الفريدة من نوعها.
وبجانب ثرائها الحيواني، تعتبر الشطابة من الغابات الثرية التي تعرف غطاء نباتيا متنوعا، حيث تتوفر على حلب الصنوبر، أشجار السرو دائمة الخضرة، هولم البلوط، لعرعر الأوكسيدار أو الأرز الشائك، وهي شجرة صغيرة أو شجيرة شائعة في منطقة ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتعد من النباتات المميزة للأدغال، شجرة الفراولة أو شجرة الفراولة الشائعة، وهي نوع من النباتات المزهرة في عائلة إريكاسيا وتتمثل في شجيرات أو أشجار صغيرة تنمو في جميع أنحاء الحافة الغربية للبحر الأبيض المتوسط ولكن أيضًا في شمال الحافة الشرقية، إضافة إلى شجرة فيليريا هو جنس من الشجيرات يتبع فصيلة الزيتيات ويجمع هذا الجنس بين نوعين من الفيلاريات، وهي شجيرات البحر الأبيض المتوسط العدوانية، قريبة جدًا من شجرة الزيتون، بساتين الفاكهة البرية، فطريات، النباتات العطرية والطبية.
حاتم / ب