
تعرف البراميل الصناعية المستخدمة، استعمالا مكثفا بالجزائر منذ سنوات طويلة، نظرا لحاجة الناس إليها لتخزين المياه و المواد الغذائية و غيرها من الاستخدامات الأخرى الآخذة في التوسع مع ظهور المزيد من الأنواع و الأشكال و الأحجام من هذه البراميل ذات المصدر البلاستيكي و المعدني.
و يعتقد الناس بأن غسل هذه البراميل بالماء و المنظفات الكيماوية كفيل بالقضاء على بقايا المواد التي كانت مخزنة داخلها، و من ثم تتم إعادة استعمالها في الحياة اليومية دون معرفة المخاطر الصحية و البيئية الناجمة عنها، حيث يقول خبراء الصحة و البيئة بأن بعض المواد الكيماوية تترك آثارا داخل هذه البراميل، و من الصعب القضاء عليها بالتنظيف العادي، و من ثم فإن إعادة استعمالها في الحياة اليوم تنجر عنه مخاطر كبيرة مؤثرة على الصحة و البيئة، تأثيرا جديا، مازال الناس العاديون لا يعرفونه، و ربما منهم من يتجاهل الخطر و يرى في استعمال هذه البراميل أمرا عاديا.
و لتسليط الضوء على الحاويات و البراميل الصناعية في الجزائر، و كيفية إعادة استعمالها بطريقة آمنة، و تقنيات تطهيرها و تعقيمها و التخلص منها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تستند الصفحة الخضراء إلى دراسة هامة أنجزها خبير البيئة الجزائري كريم ومان، المدير العام السابق للوكالة الوطنية للنفايات، حصلت النصر على نسخة منها أمس الثلاثاء، يتحدث فيها عن مخاطر الاستخدام الخاطئ لهذه النفايات، و تأثيرها على الصحة و البيئة و كيفية تعقيمها و تطهيرها و تدويرها خدمة للاقتصاد الوطني و المجتمع.
يقول كريم ومان بأن إعادة استخدام البراميل التي سبق أن احتوت على مواد أولية صناعية، غالبا ما تكون سامة، هي ممارسة آخذة في التوسع بشكل كبير.
هذه الممارسة غير المنظمة بما فيه الكفاية، يمكن أن تشكل مخاطر جسيمة على صحة الإنسان والبيئة، عندما تكون قد استخدمت لتخزين المواد السامة، حيث جرت العادة أن يتم استخدام هذه البراميل من قبل الأفراد لتخزين الطعام أو الماء، بعد عملية غسل بدائية، ومع ذلك، يمكنها أن تبقى محتوية على بقايا سامة، و يمكن أن تنتقل إلى الطعام أو الماء.
قد تكون العواقب وخيمة
و يحذر كريم ومان من عواقب قد تكون خطيرة عند الاستعمال الخاطئ لهذه البراميل، بينها التسمم الحاد، والاضطرابات العصبية أو الهرمونية بسبب التعرض المطول للمواد السامة، والمخاطر المسببة للسرطان المرتبطة ببعض المواد الكيميائية.
و يقدم خبير البيئة الجزائري ما يراه حلولا لمواجهة هذه المخاطر، كإنشاء شعبة مهنية مخصصة لتنظيف وإعادة استخدام البراميل الصناعية ليس فقط التزاما تنظيما، ولكنه أيضا فرصة اجتماعية واقتصادية كبيرة، مضيفا بأن هذه المبادرة لا تحمي الصحة العمومية والبيئة فحسب، بل تعزز أيضا إنشاء فرص عمل متخصصة وتطور شركات مبتكرة في إطار إدارة هذه البراميل المصنفة على أنها نفايات خطرة، موضحا بأنه و في الجزائر، تم وضع لوائح مهمة لتجنب الاستخدام غير المناسب لهذه البراميل، ومع ذلك لا تزال هناك ممارسات غير رسمية.
ما هي المخاطر المرتبطة بالبراميل غير المطهرة؟
حسب الدراسة التي أعدها كريم ومان، فإن البراميل الصناعية، المصممة لاحتواء مواد كيميائية قد تكون شديدة السمية، فهي تحتفظ ببقايا حتى بعد الشفط بالماء، و يمكن أن تنتقل هذه البقايا إلى المواد الغذائية أو المياه المخزنة، مما يعرض المستهلكين لمواد خطرة، حيث يمكن أن تشمل العواقب التسمم الغذائي الحاد، اضطرابات عصبية أو هرمونية بسبب التعرض المطول للمواد السامة، إلى جانب مخاطر الأمراض السرطانية.
كما يمكن أن يؤدي نفوذ المخلفات من البراميل أو مياه الشطف المرتبطة بهذه المعدات في البيئة إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، و تلوث النظم البيئية الأرضية والمائية، و زيادة الصعوبات في معالجة التربة الملوثة. و من هنا، يقول صاحب الدراسة، بأن هذه المخاطر الجدية تؤكد على ضرورة اتباع نهج صارم لإدارة هذه الحاويات، وتجنب إعادة استخدامها بشكل غير احترافي وتفضيل الحلول المهنية والمستدامة.
هل التنظيف المهني حل آمن؟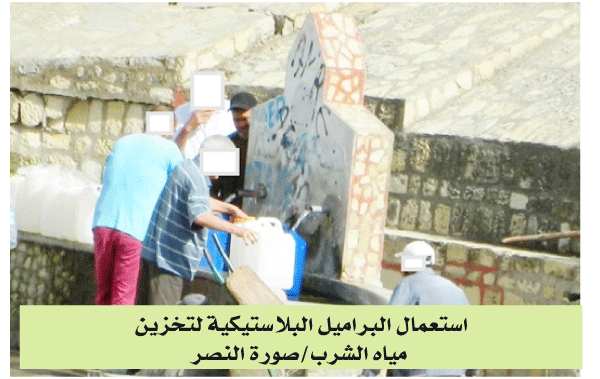
يتساءل كريم ومان هل التنظيف المهني حل آمن لتفادي المخاطر الناجمة عن البراميل الصناعية الملوثة بمواد سامة؟ موضحا بأن تطهير البراميل الصناعية هو عملية معقدة تتطلب بنى تحتية متخصصة، ومعدات مناسبة وعمال مؤهلين، مقدما الخطوات الرئيسية لبروتوكول تطهير صارم، يبدأ بالتقييم الأولي، الذي عرفه بأنه عملية ضرورية تبدأ بالتحديد الدقيق للمحتوى الأصلي، و تسمح هذه الخطوة بمعرفة طبيعة المخلفات المراد إزالتها، بعد ذلك يتم إجراء تقييم لمستوى التلوث لتحديد المخاطر المرتبطة به، و أخيرا من الضروري التحقق من السلامة الهيكلية للبرميل، للتأكد من أنه في حالة جيدة وأنه لا توجد به تسريبات، مما يضمن التعامل الآمن.
و يتضمن بروتوكول التطهير عدة خطوات أساسية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، حيث يجب أن يكون التنظيف المسبق بالشطف عالي الضغط لإزالة المخلفات المرئية، وبالتالي إعداد السطح للخطوات التالية، بعد ذلك، تتضمن المعالجة الرئيسية تنظيفا كيميائيا مناسبا، مصحوبا بتحييد المواد الخطرة، ثم دورات شطف متكررة للتأكد من إزالة جميع الملوثات، و في الأخير تتضمن التشطيبات تجفيفا محكما وفحصا شاملاً للجودة، لضمان إجراء عملية التطهير بنجاح و التأكد من أن البراميل صارت آمنة للاستخدام في المستقبل.
و تعد مراقبة الجودة والتتبع من الخطوات التي لا غنى عنها في عملية إدارة البراميل المستعملة، و تكون البداية بتحليل كيميائي يهدف إلى الكشف عن المخلفات الموجودة، مما يضمن إزالة جميع المواد الخطرة بشكل صحيح. بعد ذلك، يتم إجراء اختبارات التسرب مصحوبة بفحص دقيق لهيكل البراميل لضمان سلامتها، و أخيرا، و لضمان إمكانية التتبع الكامل، يتم تحديد تعريف فريد لكل برميل، مما يسمح بتتبع تاريخه وضمان المتابعة الدقيقة طوال دورة حياته.
إدارة البراميل الصناعية تمثل قطاعا واعدا للفرص الاقتصادية
و يرى كريم ومان، بأن إعادة تدوير البراميل و تطهيرها من السموم، و إعادة استعمالها في الحياة اليومية و الدورة الاقتصادية، تشكل مجالا آخذًا في التوسع، نظرا للنشاط الصناعي والزراعي المكثف الذي تعرفه الجزائر، مما يفتح الطريق أمام العديد من الفرص الاجتماعية والاقتصادية، بينها إنشاء شركات متخصصة في التطهير وإعادة التدوير، و علاوة على ذلك، ستظهر شركات ناشئة لتطوير حلول التتبع الرقمي، و التحليل الكيميائي الآلي، مما يعزز المتابعة الفورية لهذه العبوات الملوثة. كما يمكن إنشاء وظائف مؤهلة، حيث يتطلب تطوير هذا القطاع موظفين مؤهلين ومدربين على المخاطر الكيميائية وعمليات التطهير، و يشمل ذلك فنيين متخصصين في التنظيف الصناعي، ومهندسين في إدارة المخاطر البيئية، ومشغلين مدربين على معايير السلامة و التتبع.
و من خلال تعزيز إعادة الاستخدام الآمن للبراميل بعد التطهير، تندرج هذه النشاطات تماما في نهج الاقتصاد الدائري، مما يقلل من استهلاك المواد الخام ويحد من إنتاج النفايات.
دعوة إلى العمل وتحويل التحدي إلى فرصة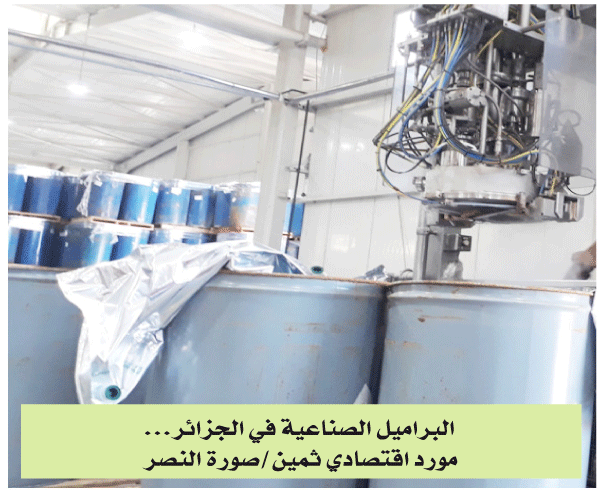
و خلص خبير البيئة الجزائري كريم ومان في دراسته، إلى القول بأن إدارة وتطهير و إعادة استخدام البراميل الصناعية تمثل تحديا كبيرا للصحة العمومية والبيئة، ولكنها أيضا فرصة اقتصادية هائلة تعتمد على نهج متكامل ومنسق، و من الممكن تحويل هذا التحدي إلى قوة داعمة للنمو الاقتصادي الوطني المستدام، موضحا بأن هذا النشاط، الذي يقع على مفترق طرق الاهتمامات الصحية والبيئية والاقتصادية، يتوفر على إمكانات هائلة لخلق فرص العمل والتنمية المحلية، والانتقال إلى اقتصاد دائري حيث تتوفر في الجزائر قوانين و لوائح تمثل إطارا قويا لهذا التحول المستقبلي، في مجال إدارة النفايات و الحد من المخاطر الصحية و البيئية الناجمة عنها. فريد.غ
البروفيسور جيمس ماكلين يحاضر في الجزائر ويؤكد
دراسة علم الزلازل القديمة مهمة لتقييم المخاطر
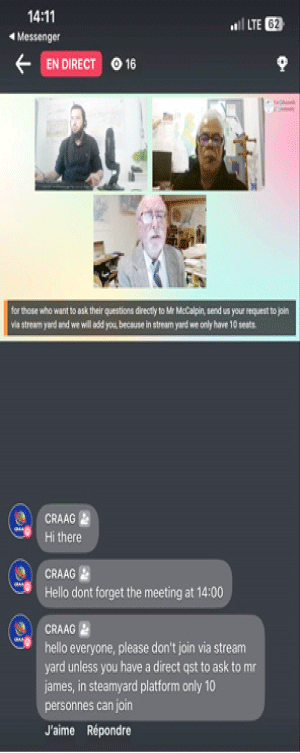
نشط مطلع الأسبوع، البروفيسور الأمريكي في مجال الزلازل القديمة جيمس ماكلين، ندوة مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بالجزائر، تحدث خلالها عن آليات رصد الحركة الزلزالية و جديد هذا العمل العملي الدقيق على المستوى العالمي، موضحا أنه في منتصف وأواخر الستينيات، لم يتمكن علماء الزلازل إلا من تقديم توصيف عام لمصادر النشاط الزلزالي، وذلك استنادا إلى سجل زلزالي قصير لم يتجاوز 175 عاما، لكن الوضع اختلف كليا اليوم.
وتطرق العالم، خلال الندوة التي تمت بشكل مباشر على منصة فيسبوك إلى التطور التاريخي لعلم الزلازل وأهم تطبيقاته في الدراسات الزلزالية والتكتونية، حيث استهدفت المحاضرة التي جاءت بالتعاون مع مجموعة «جيو هازارد كوميونيتي»، وكذا منصة «جيوليرن هيب»، الباحثين والطلبة المهتمين بجيولوجيا الزلازل والنشاط التكتوني، إلى جانب المختصين في تقييم المخاطر الزلزالية.
و تمت الإشارة من قبل البروفيسور جيمس ماكلين، إلى أنه قبل 175 عاما، لم تكن هناك طرق معروفة لـتحديد مواقع الفوالق النشطة، بل كان العمل ينحصر في تعيين منحنيات التكرار و قوة الفوالق، لرصد الحد الأقصى لقوة الزلازل، أو اتجاه الحركة، و تقدير دورات التكرار أو مقدار الإزاحة لكل حدث زلزالي. وقال ماكلين، بأن المشكلة سالفة الذكر، كانت محط دراسة للبروفيسور كلارنس آر. ألين، من معهد كالتيك، وقد فصل فيها خلال توليه رئاسة جمعية الجيولوجيا الأمريكية عام 1974، إذ أوضح القيود التي واجهها العلماء في تقييم النشاط الزلزالي، بحيث ساهمت ملاحظاته في تشجيع تطوير علم الزلازل القديمة، الذي أصبح لاحقا أداة أساسية في دراسة الزلازل والتنبؤ بها.
واستعان الباحث، بتجربة الولايات المتحدة الأميركية للحديث عن تطور هذا العلم، وأوضح كيفية الاستفادة منها، مشيرا إلى أن بلاده عندما بدأت التخطيط لمحطات الطاقة النووية في منتصف الستينيات، التزمت بتقييم مخاطر الحركة الزلزالية للأرض بشكل كمي.
وقد أصبح ذلك ممكنا بحسبه، في عام 1968 مع تطوير نموذج التحليل الاحتمالي للمخاطر الزلزالية، على يد كورنيل سي الين، كما ورد في بحثه «تحليل المخاطر الزلزالية الهندسية».
وقال، بأن كورنيل قدم خلال أطروحة الدكتوراه الخاصة به، في معهد ماساتشوستش للتكنولوجيا، طريقة لتقييم المخاطر الزلزالية في مواقع المشاريع الهندسية، بحيث تقاس النتائج بناء على معايير حركة الأرض « مثل التسارع الأقصى» مقابل متوسط فترة العودة. وأكد المتحدث، بأنه ورغم مرور 57 عاما، على تطوير هذا النموذج، إلا أنه لا يزال يستخدم حتى اليوم كأساس في تقييم المخاطر الزلزالية، وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت سجلا زلزاليا تاريخيا، وادواتيا قصيرا نسبيا، حيث لم يتجاوز 175 عاما، في الغرب التكتوني النشط، و200 إلى 275 عاما في المناطق الوسطى والشرقية الأقل نشطا زلزاليا.
لينة دلول
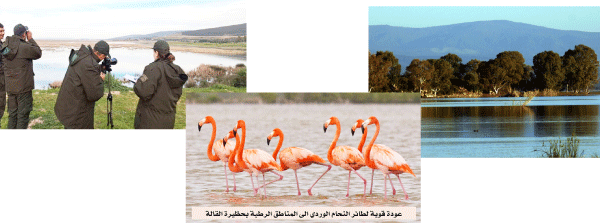
منها النحام الوردي و بط أبو خصلة
50 بالمائة من الطيور المهاجرة والمستقرة حطت رحالها بالطارف
شكل مركب المناطق الرطبة للحظيرة الوطنية للقالة هذه السنة، قبلة لآلاف الطيور المهاجرة من مختلف أصقاع العالم للتعشيش وقضاء فترة الشتاء في البحيرات والمسطحات المائية للحظيرة، حيث كشفت عملية الإحصاء التي قامت بها الشبكة الجزائرية لملاحظي الطيور عن استقبال المناطق الرطبة للولاية لأكثر من 50بالمائة من أعداد الطيور المهاجرة والمحلية في الجزائر.
ويعد الرقم مهما جدا مقارنة بما تم رصده في البلدان المجاورة، حيث تم إحصاء 158 الف طائر من 23صنفا، منها أزيد من 100ألف طائر من عائلة البطيات، وحوالي 20ألف طائر من الغر، إضافة إلى طائر الخواضات والبلشونيات والدجاجات المائية، و الجوارح حسب ما لوحظ خلال حملة الإحصاء التي اختتمت مؤخرا.
وذكر رئيس الناحية الشرقية رقم 1 للشبكة الجزائرية لملاحظي الطيور عبد السلام قريرة، أن هذه السنة عرفت توافد أعداد كبيرة من البط السطحي على بحيرات والمسطحات المائية بولاية الطارف، مع ملاحظة وجود أعداد من البط الغطاس من بينها بط أبوخصلة الذي سجل عودته لمركب المناطق الرطبة للحظيرة بعد غياب تجاوز 15سنة، إلى جانب طائر بوقليقة أسود الذيل، الذي عاد من جديد بعد غياب فاق 10سنوات وطائر النحام الوردي، وأعداد أخرى كبيرة من طائر سقد الشمال.
وأشار، إلى أن تهاطل الأمطار والظروف المناخية التي ميزت السنة الجارية والأشهر التي سبقتها بقليل، وامتلاء المناطق الرطبة بالمياه بعد فترة شبه جفاف، ناهيك عن ارتفاع منسوب مياه المسطحات المائية المؤقتة، جعل توافد الطيور المهاجرة و المستقرة عليها كبيرا، وذلك لأجل التعشيش وقضاء فترة الشتاء هربا من تدني درجة الحرارة والبرد الذي يضرب شمال أوروبا.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية الطارف تضم 10 مناطق رطبة طبيعية، تستوعب ما يقارب 30 نوعا من الطيور البرية المهاجرة مثل أبو ساق، أبو ملعقة، الغراب الكبير، وأبوسبولة أو الغطاس الكبير، والنحام الوردي، والشهرمان، والغرة، وحذف الشتاء، والنكات والكركري الرمادي، وهي مناطق متنوعة الثروات ومصنفة ضمن اتفاقية رمسار ذات الأهمية العالمية.
نوري حو

سجلت الجزائر ولأول مرة، ظهور طائر البجع الرمادي بسد حمام قروز بوادي العثمانية بولاية ميلة، وهو رصد وصف بالاكتشاف لأن وجود الطائر نادر جدا في شمال إفريقيا و يقتصر فقط على الجانب الجنوبي للقارة الإفريقية وشرق آسيا بيئته الأصلية.
وأعلنت الجمعية الجزائرية لتوثيق الحياة البرية، عن تأكيد وجود الطائر بعد أن تمت ملاحظته من قبل مصالح مديرية البيئة لولاية ميلة، والناشط البيئي عبد المالك لمغورب، ليجري تنسيق العمل مع خلية مراقبة الطيور بالولاية بالتعاون مع الجمعية للجزائرية للحياة البرية، التي انتقل فريق منها رفقة فريق مراقبين مشترك، لتأكيد وجود طائر البجع الرمادي الذي يشاهد ولأول مرة في الجزائر.
وفي بيان صادر عن الجمعية، أوضحت أن هذا التسجيل الذي وصفته بالتاريخي والإضافة إلى قائمة الطيور المسجلة بالجزائر، قد جاء تزامنا وانطلاق حملة إحصاء الطيور المائية المهاجرة في 20 من شهر جانفي الفارط، أين تم رصد أنواع عديدة من الطيور بمختلف سدود ولاية ميلة، كما اعتبرت أن تسجيل أنواع جديدة من الطيور المهاجرة كالبجع الرمادي والبط البري، تأكيد على ثراء وتنوع النظم البيئية في الجزائر وصحتها.
من جانبها، أكدت مصالح الغابات بولاية ميلة، رصد طائر البجع الرمادي بسد قروز، فيما كانت قد تمت ملاحظته في وقت سابق بسد بني هارون خلال سنوات 2017 و2018 دون توثيق ذلك، موضحة أن هذا الطائر من الأصناف المهاجرة من شرق آسيا وجنوب إفريقيا، وقد حط رحاله مؤخرا، بميلة التي تتوفر مسطحات مائية فريدة من نوعها أغرته للهجرة، نظرا لقدرته الهائلة على التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة، مما يضمن استمرارية وجوده في حياة الأجيال القادمة مهما أزعجته التغيرات المناخية.
يذكر أن طائر البجع الرمادي واحد من أنواع البجع التي تختلف في أحجامها وألوانها وتوزيعها الجغرافي، إلا أنها تشترك في العديد من الخصائص البيولوجية والسلوكية، كقدرتها على الطيران لمسافات طويلة وتعاونها في صيد السمك، كما أنها تعتبر من الطيور الاجتماعية التي تعيش في مجموعات كبيرة وغالبا ما تشاهد وهي تقوم بعروض طيران جماعية.
كما تتميز الأسراب برحلاتها الطويلة التي تمتد من أوروبا وآسيا إلى إفريقيا، حيث تبدأ هجرتها أواخر فصل الصيف، مغادرة مستعمراتها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى باتجاه الجنوب، لتعبر البحر الأبيض المتوسط وتستمر في التحليق فوق الصحراء الكبرى حتى تصل إلى مناطق الشتاء في إفريقيا.
إيمان زياري

رصدت في 10 مواقع رطبة
إحصاء أزيد من 3200 طير مهاجر بولاية الوادي
أحصت فرقة مراقبة الطيور التابعة للمحافظة الولائية للغابات بالوادي، أزيد من 3200 طير مهاجر من 19 نوعا، تم رصدها على مستوى 10 مناطق رطبة متواجدة عبر تراب الولاية، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و22 جانفي 2025.
وذكرت مصالح الغابات، أن فرقة مراقبة الطيور المهاجرة التابعة لها أحصت خلال الفترة الشتوية المخصصة لإحصاء الطيور المهاجرة، أزيد من 3200 طير مهاجر، على مستوى 10 مواقع رطبة، منها 08 مواقع ذات أهمية إيكولوجية على غرار بعض البحيرات التي تشكلت جراء ظاهرة صعود المياه، بالإضافة إلى شط مروان، ووادي خروف، وشط ملغيغ بالحمراية، المصنفين دوليا حسب اتفاقية “رامسار»، ناهيك عن محطات لتصفية مياه الصرف، ومصب للصرف الصحي.
وقالت محافظة الغابات، إن من بين الطيور التي تم إحصاؤها 754 طيرا من نوع «أبو مجرفة شمالي» غير المحمي، و528 طائرا من نوع «شرشير المخطط»، إلى جانب 276 من الطير المعروف باسم «الشهرمان الأمغر»، أو بط أبو فروة المحميان.
وتمت الإشارة إلى أن فترة التعداد والمواعيد النهائية متطابقة في جميع أنحاء المنطقة الأفرو- أوراسية، وتنفذ سنويا بالتنسيق مع منظمة الأراضي الرطبة الدولية أواخر شهر جانفي من كل سنة، عندما تكون الطيور مستقرة بعد هجرات ما بعد التكاثر.
منصر البشير
حسب تقرير المخاطر العالمية لسنة 2025
المخاطر البيئية من أكبر التهديدات طويلة وقصيرة الأمد
حذر تقرير المخاطر العالمية لسنة 2025، من تفاقم شدة وتكرار المخاطر البيئية، وتواصل تسجيل أحداث مناخية متطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم الإيكولوجية.كما أشار التقرير إلى التأثير المباشر للتكنولوجيا المتسارعة والتضليل في كل ما يحدث، وهو ما وضع التحديات البيئية على رأس قائمة المخاطر العالمية قصيرة و طويلة الأمد، ما يعكس حاجة ماسة إلى تعاون دولي مكثف وإجراءات جماعية
لمواجهة تحديات متداخلة ومتزايدة.وقد أبرز المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الجديد، حجم الأخطار المتزايدة التي تواجه العالم على المديين القصير والطويل، برؤى أكثر من 900 خبير من جميع أنحاء العالم في قطاعات الأعمال، الحكومة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، أجمعوا على أن التوقعات بشأن المخاطر البيئية على مدى العقد المقبل مثيرة للقلق.
تهديدات مقلقة
وجاءت الأحداث المناخية القياسية، إلى جانب تهديد النظم الإيكولوجية والتغير الحرج في أنظمة الأرض، ونقص الموارد الطبيعية، في صدارة التصنيف ضمن قائمة المخاطر على مدى 10 سنوات المقبلة، وهو ما ينظر إليه على أنه خطر رئيسي في الأمد القريب.
ويعكس الترتيب السادس في هذا التصنيف، اعترافا متزايدا بالتأثيرات الصحية والبيئية الخطيرة لمجموعة واسعة من الملوثات في الهواء والماء والأرض، إذ صنفت الأحداث المناخية المتطرفة بشكل بارز كمخاطر فورية قصيرة وطويلة الأجل في الوقت ذاته. يسلط التقرير الضوء كذلك على جميع الأخطار البيئية، والصحية، والجيو سياسية، وقد صنفت المخاطر البيئية والتدهور من بين الأكثر أهمية عالميا، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصبح الأحداث المناخية المتطرفة مصدر قلق أكبر مما هي عليه بالفعل، كونها تحتل المرتبة الأولى ضمن قائمة المخاطر على مدى 10 سنوات مقبلة، وذلك للعام الثاني على التوالي، ويحتل فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم الإيكولوجية المرتبة الثانية على مدى نفس الأفق الزمني، مع تسجيل تدهور كبير مقارنة بترتيبه طوال عامين.
الجيل الجديد الأكثر وعيا بحجم المخاطر البيئية
وأوضح تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته العشرين، أن المسح العالمي لآراء المستهلكين يظهر تباينا بين الأجيال فيما يتعلق بإدراك المخاطر المرتبطة بالقضايا البيئية، إذ أبدت الفئات الأصغر سنا في استطلاع خاص قلقا أكبر بشأن هذا الموضوع على مدى العشر سنوات القادمة مقارنة بالفئات العمرية الأكبر سنا.ويضرب التقرير مثالا على ذلك بمشكلة التلوث التي صنفها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، كثالث أشد المخاطر خطورة في عام 2035، وهو أعلى مستوى بين أي فئة شملها المسح.
كما كان تقرير سنة 2024، قد أشار إلى أن هناك تباينا في كيفية تصنيف التلوث حسب الجهات المعنية، حيث يضع القطاع العام التلوث ضمن قائمة المخاطر العشرة الأولى في التصنيف على مدى العشر سنوات المقبلة، فيما لم يقدم القطاع الخاص نفس التقييم، ليقيم التقريران التلوث كمفترق طرق يستدعي العمل من أجل سد فجوات الوعي، عن طريق استكشاف مخاطر الملوثات غير المقدرة والتي تحتاج إلى أن تصبح أكثر بروزا في أجندات السياسات بحلول العام 2035، خاصة بالنظر لتأثيراتها السلبية والكبيرة على الصحة والنظم الإيكولوجية.
التكنولوجيا المتسارعة والتضليل.. مخاطر تحت المجهر
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في أهم تقرير دولي للمخاطر، أن العام 2024 شهد تجارب كبيرة من قبل الشركات والأفراد في تحقيق أفضل استخدامات لأدوات الذكاء الاصطناعي، في ظل تسجيل انخفاض من حيث المخاوف بشأن النتائج السلبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى العامين المقبلين.
ودعا التقرير رغم ذلك، إلى ضرورة تجنب ما اعتبره رضا عن المخاطر المترتبة عن مثل هذه التقنيات نظرا للطبيعة السريعة للتغيير في مجال الذكاء الاصطناعي وانتشاره المتزايد.
وأوضح المصدر، أنه وإلى غاية اليوم، فإن النتائج السلبية لتقنيات الذكاء الاصطناعي تعد واحدة من المخاطر التي ترتفع أكثر في تصنيف المخاطر على مدى 10 سنوات مقبلة.
كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورا في إنتاج محتوى زائف أومضلل توليدي على نطاق واسع، كما يضع التكنولوجيا من بين المخاطر الأوسع نطاقا نتيجة زيادة الاتصال والنمو السريع في قوة الحوسبة وأدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة.
ومن بين المجالات التي تشهد أسرع التطورات التكنولوجية بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي، قطاع التكنولوجيا الحيوية، وذلك في ظل فقدان السيطرة على التكنولوجيا ووجود مخاطر منخفضة الاحتمال وعالية التأثير، مثل النتائج السلبية للتكنولوجيات الرائدة التي تنطوي على إساءة استخدام عرضي أو سيئ لتقنيات تحرير الجينات مثلا، أو حتى واجهات الدماغ والحاسوب، وفي الوقت نفسه لا تقلل مثل هذه المخاطر من التقدم الفعلي والمحتمل الهائل للبشرية الناتج عن التكنولوجيا الحيوية.
وفي خريطة تفاعلية للمخاطر، يوضح التقرير ترابط المخاطر العالمية، إذ يؤثر كل خطر على الآخر، كتأثير التغير المناخي على الاقتصاد والهجرة، كما يظهر أن التعامل مع المخاطر المركزية كالأحداث المناخية القياسية يمكنه التخفيف من تحديات متعددة.
يأتي كل ذلك في ظل تأكيد على أهمية التعاون الدولي لإدارة المخاطر الكبرى، ودور التكنولوجيا كفرصة وتهديد في الوقت ذاته، إذ يساعد الفهم الشامل لهذه العلاقات على وضع حلول إستراتيجية فعالة للتحديات العالمية، وأهمية الابتكار والاستثمار في تقنيات الاستدامة.
إيمان زياري

الفائزة في مسابقة الشباب العربي المبتكر سارة مفرج
أطور تقنيات زراعية مستدامة لتحقيق إنتاج بيئي وصحي
قالت سارة مفرج، المتوجة مؤخرا بالميدالية الذهبية في مسابقة الشباب العربي المبتكر، إنها تشتغل على مشروع مبتكر لتحسين زراعة الأزولا والعدس المائي في أحواض مؤمّنة، بالاعتماد على تقنيات مستدامة تهدف إلى تحقيق إنتاج بيئي وصحي لفائدة الإنسان وكذلك المواشي.
وأوضحت صاحبة ذهبية مسابقة الابتكار التي نظمتها جامعة قطر للعلوم والتكنولوجيا، أن الأزولا والعدس المائي اللذين يرتكز عليهما مشروعها المتوج، لا يستهلكان كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمحاصيل العلفية الأخرى، وهو ما جعلها تختار العمل عليهما، فيما تسعى لتوسيع نطاق بحثها مستقبلا كي يشمل الاستزراع السمكي، مؤكدة أن التقنية يمكن أن توفر حلا اقتصاديا وبيئيا لدعم إنتاج الأسماك محليا.
من إدارة الأقاليم إلى ابتكارات البيئة المستدامة
لم يكن اختيار الطالبة المتألقة بجامعة صالح بوبنيدر قسنطينة 3، سارة مفرج، للتخصص البيئي وليد الصدفة، بل جاء نتيجة شغف متجذر وحب لاستكشاف الحلول المستدامة التي من شأنها أن تساهم في مواجهة التغيرات المناخية، حيث بدأت مسيرتها الأكاديمية في تخصص إدارة الأقاليم و كانت الأولى على دفعتها.
اهتمامها العميق بالقضايا البيئية دفعها إلى البحث عن مجال أكثر توافقا مع طموحاتها، خاصة بعد فتح تخصص جديد في تسيير التغيرات البيئية في البحر الأبيض المتوسط بالجامعة ذاتها، لذلك لم تتردد في خوض التحدي، فشاركت في المسابقة التي نظمتها الجامعة لاختيار الطلبة المؤهلين للالتحاق بالماستر الجديد، و قد نجحت في اجتيازها، مؤكدة أنها تفوقت في التخصص وأثبتت جدارتها ضمن الأوائل طوال مسارها الجامعي. لم يكن هذا التحول الأكاديمي بحسب الشابة، مجرد تغيير في التخصص بل كان خطوة حاسمة في مسيرتها البحثية، حيث وجدت نفسها منخرطة في مشاريع علمية تسعى إلى تطوير حلول مبتكرة لمشكلات الأمن الغذائي والمائي.
أشتغل على مشاريع الاستزراع السمكي الوطني
تزامن اشتغال الطالبة على مذكرة التخرج، مع صدور المرسوم الوزاري 12/75 الخاص بالمؤسسات الناشئة والمصغرة، وهو ما شكل دافعا إضافيا لها للعمل على مشاريع ذات طابع تطبيقي وابتكاري.
موضحة، أنها أنجزت مذكرتين خلال مسيرتها البحثية الأولى تناولت التلوث المائي، أما الثانية فتمحورت حول تحسين زراعة الأزولا والعدس المائي في أحواض مؤمّنة، بهدف إنتاج أعلاف عضوية مغذية وذات تكلفة منخفضة مقارنة بفول الصويا والأعلاف التقليدية الأخرى.
مشيرة في سياق منفصل، إلى أن هذه النباتات تنتمي إلى الفئة المائية، وتعد من أسرع النباتات نموا في العالم، كما أنها من بين أغنى النباتات بالبروتين على الإطلاق. وأكدت مفرج، أن تطوير زراعتها بأساليب مبتكرة يمكن أن يكون حلا فعالا لتعزيز الأمن الغذائي للحيوانات، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التقليدية واعتماد القطاع الفلاحي عليها بشكل كبير. وحسبما أوضحته الشابة، فإنه ومن خلال تكوينها الجديد بكلية تسيير التقنيات الحضرية، استطاعت الجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، مما أهلها لإنجاز مشروعها الرائد حول زراعة الأزولا والعدس المائي، والذي توج بالميدالية الذهبية في مسابقة الشباب العربي المبتكر بالدوحة. وما زاد من قيمة هذا الإنجاز حسبها، هو أن شهادة الماستر التي حصلت عليها تُعد شهادة دولية، مما يفتح أمامها آفاقا أوسع في مجالات البحث العلمي والابتكار البيئي. كما قالت المبتكرة، بأن مشروعها يعتمد على تقنيات مستدامة تهدف إلى تحقيق إنتاج بيئي وصحي، مع تقليل الأثر السلبي على الموارد المائية، فالأزولا والعدس المائي لا يستهلكان كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمحاصيل العلفية الأخرى، كما أنهما يساعدان في تقليل الانبعاثات الكربونية، مما يجعلهما خيارا مثاليا في سياق التغيرات المناخية الحالية.
اعتمدت على التكنولوجيا الحديثة والأحواض الذكية والأوتوماتيكية
اعتمدت سارة مفرج، في مشروعها على التكنولوجيا الحديثة والأحواض الذكية والأوتوماتيكية، وهي نفس التقنيات المستخدمة في معالجة الطيور، مثل Les Alce وLes Spululule، لكنها تساءلت لماذا لا يتم استغلال هذه الأحواض لاستخراج الأطعمة الحيوانية؟ كانت هذه الفكرة هي نقطة الانطلاق لمشروعها.وحسبما أوضحت المتحدثة، فإن الدراسات أثبتت أن الأزولا تساعد الأبقار في مضاعفة إنتاج الحليب بنسبة 20 % عند تناولها، كما أنها تحسن من جودة البيض عند الدواجن.
ولم يتوقف تأثير هذا الابتكار عند الثروة الحيوانية بحسبها، بل امتد ليشمل مشروع الاستزراع السمكي الوطني، خاصة ما يتعلق بتربية السمك الأحمر في الأحواض، وهو نوع يتطلب غذاء خاصا مرتفع التكلفة. هنا، وجدت سارة أن الأزولا يمكن أن تكون بديلا اقتصاديا ومستداما، حيث يستهلكها السمك بسهولة، مما يجعلها قريبة المذاق للأسماك البحرية، كما أنها تعمل على تحسين مناعته ضد الأمراض.
من هنا كانت الانطلاقة الحقيقية في عالم الابتكار
أكدت سارة، أنه وبعد إنهاء دراستها، حصلت في أكتوبر 2023 على مشروع «لابال»، ثم تمكنت من الحصول على علامة «لابال» رسميا في 2024، وهي شهادة اعتماد تُمنح للمشاريع البحثية المبتكرة.
موضحة، أن مديرة مخبر «LIPE»، البروفيسور سهام عراس، لعبت دورا أساسيا في الإشراف على بحثها، ومساعدتها في تحليل النتائج المخبرية، كما ساهم معهد تسيير التقنيات الحضرية في مساعدتها على تصميم النموذج الأولي للمشروع، من خلال تركيب أجهزة الاستشعار، وإنشاء بيئة مثالية لزراعة الأزولا. وقالت سارة، إنه وبعد الحصول على علامة لابال، فكرت في طلب التمويل، لكنها قررت تأجيل الأمر إلى غاية استكمال التكوينات الجامعية، خاصة وأن مشروعها أصبح معتمدا على مستوى هضبة تكنوبول جامعة قسنطينة 3 ، مما أتاح لها فرصة تطويره بشكل أكبر.
التتويج في قطر…
وأضافت سارة، أن أستاذتها هي من شجعتها على المشاركة في المسابقة الدولية المنظمة بقطر حول الأمن الغذائي والمائي، مؤكدة أن هذه الأخيرة شهدت مشاركين من 106 دول وجامعات عربية وعالمية، اختيرت من بينها أفضل المشاريع الرائدة وعددها 12، على غرار مشروعها الذي طلب منها إعداده باللغة الإنجليزية. وأوضحت الشابة، أن مشروعها مر على لجنة تحكيم دولية ضمت خبراء من أمريكا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، الهند، ودول أخرى، وبعد التأكد من جودته، تم استدعاؤها رسميا إلى قطر للمشاركة في المسابقة.
الكفاءات البحثية في الجزائر متفوقة جدا
تضمنت المنافسة حسبما أوضحت، مرحلتين الأولى تقديم ملصق إشهاري للمشروع والذي تم تقييمه من قبل ثلاثة حكام دوليين بشكل منفصل حيث أوضحت أن الحكام كانوا من فرنسا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، استغرقت هذه المرحلة بين 20 إلى 30 دقيقة، ليقدم كل حكم تقييمه للمشروع بناء على الملصق. أما المرحلة الثانية، فكان التقديم فيها شفويا للمشروع، وتم باللغة الإنجليزية أمام لجنة تحكيم تضم خبراء من مختلف دول العالم، و كان على سارة إقناع اللجنة خلال 5 دقائق فقط بأهمية مشروعها وجدواه الاقتصادية والبيئية. وفي اليوم الموالي، تم الإعلان عن النتائج، بدءا من المرتبة الأخيرة وصولا إلى المرتبة الأولى، التي كانت من نصيبها، وقد أوضحت أن أغلب المشاريع المشاركة ركزت على جانب واحد فقط، إما الأمن الغذائي أو الأمن المائي، في حين أن مشروعها كان يجمع بين الاثنين، وهو ما جعله محط إعجاب اللجنة وانبهارها، لكونه يقدم حلا شاملا ومستداما لمشكلتين عالميتين.
وأشارت سارة، إلى أن أستاذتها الدكتورة سهام عريس، كانت تتوقع لها الفوز منذ البداية، لكن إحساسها الحقيقي بالانتصار بدأ عندما شاهدت باقي المشاريع المنافسة، حيث أدركت حينها قوة مشروعها وتميزه عن البقية، خاصة من حيث شموليته وتأثيره على الأمن الغذائي والمائي معا. كما لاحظت خلال المسابقة أن الطلبة الجزائريين يتميزون بالابتكار في مشاريعهم، وهو ما يعكس قدرات البحث العلمي في الجزائر، رغم التحديات التي تواجه الباحثين الشباب. وقالت سارة، بأنها حظيت بتكريم رسمي من قبل مدير جامعة قطر، بالإضافة إلى وزير البيئة، في اعتراف واضح بجهودها وإسهامها العلمي المتميز في مجال الابتكار البيئي
مشروع متعدد الأبعاد
لا يقتصر مشروع سارة مفرج على تحقيق الأمن الغذائي الحيواني فقط، بل يمتد ليشمل مجالات أخرى ذات أهمية بيئية وصحية، حيث أوضحت أن زراعة الأزولا والعدس المائي يمكن أن تستخدم أيضا في إنتاج مخصبات حيوية للتربة، مما يساهم في تعزيز خصوبة الأراضي الزراعية بطريقة طبيعية ومستدامة ويخدم غذاء الإنسان.
إضافة إلى ذلك، فإن هذه النباتات تمتلك خصائص غذائية مهمة، ما يجعلها مادة أولية لإنتاج مساحيق طبيعية مخصصة للاستهلاك البشري، خاصة للرياضيين، نظرا لغناها بالبروتينات والعناصر المغذية.أما عن طموحاتها المستقبلية، فقد أكدت أنها تسعى إلى نشر مقالات علمية بالتعاون مع أستاذتها الدكتورة سهام عريس، وتركز على دراسة كيفية استخراج مواد غذائية وبيئية من الأزولا والعدس المائي، وهو ما قد يفتح آفاقا جديدة في مجال الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الحيوية. كما تسعى إلى تجسيد مشروعها على نطاق أوسع، من خلال الاستزراع السمكي الوطني، حيث ترى أنه يمكن أن يكون حلا اقتصاديا وبيئيا لدعم إنتاج الأسماك محليا. وفي ختام حديثها، وجهت سارة رسالة إلى الشباب الجزائري المهتم بالابتكار والبحث العلمي، داعية إياه للإيمان بقدراته والعمل بجد لتحقيق الريادة، مشددة على أن الإصرار والالتزام والمثابرة هي مفاتيح نجاح مضمونة لأي مشروع علمي أو ابتكاري.
لينة دلول

تنشر جمعية الدراجة الخضراء «غرين بايك»، المتواجدة بولاية عنابة، الوعي البيئي من خلال تجسيد أفكار مبتكرة تؤثر بها في كل شرائح المجتمع على رأسها الشباب والأطفال، كما تربط في عملها التطوعي بين رياضة ركوب الدراجات والنظافة، لتقدم نموذجا حضاريا عن المواطن الجزائري الذي يهمه الترويج لصورة جميلة عن بلده، خصوصا وأن هذا المشروع الوطني اكتسب صدى دوليا أيضا.
تتشارك سواعد من كل الشرائح العمرية في مشروع «الدراجة الخضراء» وكلها عزم على تغيير السلوكيات التي تضر بالبيئة، فتجد شباب الجمعية منتشرا في الشواطئ، والحدائق العامة، والغابات، وفي الشوارع حاملا شعارات تنمي بذرة الصلاح في المواطن، وتحثه على العناية بالأمكنة التي يُرَوح فيها عن نفسه ويقضي فيها أوقات فراغه، وذاك من خلال تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه المحيط، وتشجيع سلوكيات حسنة كعدم ترك النفايات في الطبيعة، أو حتى تنظيف بعض الأماكن التي طالتها أياد لم تعرف قيمتها الحقيقية.
يوظف أعضاء الجمعية مواقع التواصل الاجتماعي كذلك لإيصال رسالتهم والتأثير والتعريف بالأنشطة التي يقومون بها، حيث تحصي صفحة الدراجة الخضراء «غرين بايك»، حوالي 550 ألف متابع، و تضم صورا لأنشطة الأعضاء، فضلا عن صور المشاركات التي تصلهم من متطوعين في ولايات جزائرية أُعجبوا بالفكرة وطبقوها.تبين من خلال تصفحنا للتعليقات أنها إيجابية جدا، وتشجع المشروع وتحث أصحابه على المواصلة في تفعيل الفكرة وتعميمها على كل ولايات الوطن. وفي هذا السياق، أكد صاحب الفكرة والمدرب في الفريق الوطني للدراجات، عبد الحكيم لعشيشي، أن سنة 2025 ستكون سنة بيئية بامتياز بما سيقدمونه في الجمعية من مبادرات متنوعة، وبأفكار مبتكرة تشرك كل مواطن في الحفاظ على البيئة.
تقبل الفكرة كان صعبا في البداية
بدأت فكرة «الدراجة الخضراء» سنة 2015، وقد ساعدها الفراغ الكبير في ميدان التطوع البيئي في البروز و التبلور سريعا، وذلك وفقا لصاحبها عبد الحكيم لعشيشي، الذي أوضح أن مشروعه كان ضمن أولى المبادرات البيئية، مضيفا أنهم وظفوا اللغة الإنجليزية للاسم «غرين بايك» لتتوسع المبادرة وتأخذ طابعا بيئيا.
سنة 2018 حصل أول تواصل بين الجمعية و المسؤولين البيئيين بعنابة، حيث اقترح على أعضائها تجسيد أنشطتهم على أرض الواقع لتتحول المبادرة إلى جمعية ولائية نشطة، تبلغ ذروة فعاليتها خلال موسم الاصطياف تزامنا مع تضاعف عدد السياح، إذ قال المتحدث إن الحركية الكبيرة تتسبب عادة في تراكم النفايات على الشريط الساحلي، وهو ما دفعهم لإطلاق مبادرات مثل «الموجة الخضراء» التي لاقت رواجا كبيرا خصوصا وأن تطبيق الفكرة تم بطريقة ذكية.
أخبرنا لعشيشي، أنهم كانوا يستهدفون العائلات من خلال نشاطهم، ويحاولون إقناع أفرادها بالانضمام إليهم، من خلال إرسال الأطفال للحديث معهم، وأردف أن هذا التعاون جعل المهمة تتم في وقت قياسي لا يتجاوز 20 دقيقة، ثم توالت مبادرات أخرى تحث المواطنين على عدم رمي نفاياتهم.
وقد مست نشاطات «غرين بايك» كل أرجاء الوطن بالتنسيق مع جمعية «دزاير بينيفول» المتواجدة في العاصمة، وأثرت في كثير من الأشخاص، وذكر لعشيشي أنهم في إحدى مبادراتهم الخاصة بتنظيف بالوعات في ولاية عنابة اختاروا شعار «بلادي ما نحبكش تغرقي»، ليتفاجؤوا برسائل وصور من ولايات عديدة في الشرق الجزائري، وحتى غربا أرسلها مواطنون إلى بريد الصفحة يعبرون فيها عن التحاقهم بالمبادرة.
وعلق الدراج قائلا :»لا يجب أن يكون حضورنا كجمعية في كل الولايات، صحيح أن الجمعية ولائية لكن لها مشجعون كثر»، وتطرق إلى شعار «ليست قمامتي لكنه وطني» الذي أطلقوه سنة 2019، وكان له صدى دولي وصل إلى دول عربية مثل مصر، والعراق، وقطر، والسعودية، واليمن، وليبيا أبن بادر شباب إلى إطلاق عمليات تنظيف وتهيئة واسعة.
قال محدثنا، إن ترسيخ الفكرة كان صعبا في بدايتها، فالمواطنون كانوا يترددون في الالتحاق بركب العمل التطوعي، لكن تكثيف النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أوجد طريقا للرسالة، موضحا أن الشباب في المدينة أصبحوا يتعرفون على أعضاء الجمعية بسهولة كبيرة، وذلك بفضل نشاطهم الدائم، فما إن يشاهدوا شخصا يحمل كيسا أخضر يبادرون إلى مساعدته بصدر رحب ودون أي إحراج.
«تبني» مبادرة لتعزيز روح المواطنة
ومن المبادرات الفاعلة والجميلة التي أطلقتها الدراجة الخضراء هذه السنة مبادرة «تبني»، وتعني وفقا للعشيشي، أن يصبح كل شخص مسؤولا عن نظافة بالوعة، أو شاطئ، أو مكان معين، وأوضح أن الفكرة طُبقت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاقت رواجا كبيرا لدى عائلات تبنوا أحياء تحتوي على بالوعات يعتنون بتنظيفها بشكل دائم، وذكر أن الجمعية تبنت مجرى مائيا طوله 280 مترا وشارك شباب وأساتذة وأطباء في عملية تنظيفه.
مضيفا أن المقطع المصور الذي وثق العملية لاقى رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعقب أن عدد البالوعات التي تبنوها وصل إلى 164 بالوعة، وهي عملية استباقية لتفادي الفيضانات شتاء، كما طبقوا الفكرة أيضا في شاطئ «النصر» في مدينة عنابة بالتعاون مع السكان، ووصل عدد عمليات تنظيفه إلى 44، تمت غالبيتها خلال تقلب الأحوال الجوية لأن الشواطئ تمتلئ بالنفايات التي يخرجها البحر، فيقومون هم بجمعها قبل أن تعود إليه، بالإضافة إلى اهتمامهم بنظافة حديقة عمومية، وبعض المقاعد الموجودة على واجهة البحر و التي يتدخلون لتنظيفها دوريا.
لهذا السبب اخترنا التأثير بالرياضة
يتحلى الرياضيون بعدة صفات تجعلهم مؤثرين في المجتمع، ومن بين الصفات التي يرى مدرب الفريق الوطني للدراجات عبد الحكيم لعشيشي، أنها يجب تلازم الرياضي، صفة النظافة والمحافظة على البيئة، وقال إن ميثاق اللجنة الأولمبية يحتوي على بند يذكر بهذا الجانب، وعبر أنه كمدرب ودراج سابق، يدرك أهمية هذه الوسيلة في خدمة البيئة.
من جهة أخرى، فقد جاء ربط الرياضة بالبيئة كما أوضح، من باب القناعة بأن الشعب الجزائري محب لهذا المجال، ففي كل عائلة تقريبا يوجد عاشق للرياضة، ولذلك فقد اختاروا في الجمعية استغلال هذا الشغف لتشجيع الناس على الانخراط في مبادرة «الرياضة الخضراء»، التي شملت مجالات رياضية متعددة، وتضمنت عدة محاور أهمها تحسيس المناصرين وإشراكهم في عملية تنظيف المدرجات في الملاعب، تحت شعار»مناصر حاضر ومتحضر»، و»مناصر نظيف في ملعب نظيف»، وقال إن المبادرة ميزت المقابلات السبعة لكأس إفريقيا سنة 2019، وطبعت مشاركة الجمعية في كأس العرب، وعدة تظاهرات رياضية أخرى، أما الفكرة الجديدة التي أطلقوها بصفة شريك إيكولوجي فقائمة حسبه، على إقناع الأنصار والرياضيين بعملية فرز النفايات في المنافسات الرياضية.
أخبرنا، أن هذه المهمة اصطدمت أيضا بالصورة النمطية للملاعب لدى المناصرين، والتي تربط المكان بالترفيه والتسلية فقط، لكن الإصرار والالتزام بالإقناع الإيجابي ساهم في تغيير هذه الذهنية، حيث استعان لعشيشي بخبرته في التعامل مع الشباب والتي اكتسبها خلال ثلاثين سنة قضاها في التعليم، واستطاع التقرب منهم والتحدث إليهم بأسلوب يُطَبِّع الفكرة لديهم، إلى أن حقق التأثير المطلوب.
سنقحم كل أفراد المجتمع في العمل البيئي التطوعي
وتحضر جمعية «الدراجة الخضراء» لمبادرات عديدة ستُنفذ سنة 2025 وفقا لصاحبها، بالتركيز أكثر على التنظيف باستخدام الدراجة، وذكر عددا منها مثل «دراجة الطفل الصغير»، التي ستعطي الفرصة للأطفال ابتداء من سنتين إلى خمس سنوات للتعرف على العمل التطوعي البيئي، ومبادرة «مدرسة الكبار»، حيث سيقومون بتعليم المسنين رياضة ركوب الدراجة، وكذا مشروع «ليدي بايك» الخاص بالنساء بالتعاون مع مدربات الجمعية.
كما كشف لعشيشي، أنهم تواصلوا مع اللجنة الأولمبية لتنظيم الألعاب الإفريقية المدرسية المقررة بولايات عنابة، وقسنطينة، وسطيف، خلال صائفة 2025، وستكون الجمعية شريكا إيكولوجيا في الحدث، من خلال برمجة عدة أنشطة بيئية، وكذا إشراك المتنافسين في مبادرة «الدراجة الخضراء» لتنتشر في بلدان إفريقية أيضا.
من جهة أخرى، أوضح المتحدث، أنه بالرغم من السنوات العشر التي قضاها في العمل التطوعي والتوعوي بشكل يومي، فضلا عن المبادرات واستغلال المنصات الإلكترونية إلا أن التلوث موجود دائما، وهو ما جعلهم يغيرون استراتيجيتهم واعتماد شعار «ترمي تخلص» منذ أربع سنوات، وهو شعار تشارك صفحات أخرى على نشره، ويهدف إلى تفعيل القانون 19-01 الذي تنص المادة 55 منه على «تكبيد كل من يرمي النفايات غرامة مالية»، وعلق قائلا :»تمادي الأشخاص في التعدي على الطبيعة يتطلب ردعا مثلما هو الحال في كل دول العالم».
مضيفا، أن الجمعية تُعنى بالحفاظ على البيئة ويهمهم أن تكون الصحوة حقيقية وأكثر جدية، و ليست مجرد موجة نركبها أو «ترند»، كما أكد على تسجيل تغير في بعض الذهنيات تجاه الطبيعة مقارنة بسنوات مضت، خصوصا وأن المواطنين أصبحوا يحبون تقليد المبادرات المفيدة التي تلقى رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونصح رئيس جمعية الدراجة الخضراء، الشباب بحب وطنهم لأن المواطن الذي يسكنه هذا الشعور لا يمكن أن يترك نفاياته تخل بالمظهر العام لولايته، أو الأماكن التي يزورها، وعبر:»يحز في نفسي كثيرا أن أقصد الشاطئ حتى أنظفه، أريد أن أجد شواطئ وغابات نظيفة حتى أتنزه وأخفف عن نفسي، لا أن أخرج القفازات والأكياس لجمع النفايات». إيناس كبير

أكثـر النظم البيئية تهديدا على الكوكب
تحديات غير مسبوقة لإنقاذ الأراضي الرطبة
تواجه الأراضي الرطبة عبر العالم تحديات كبيرة وتتقلص مساحتها بشكل يوصف بالمقلق بفعل تغيرات المناخ، وهو ما يضاعف المساعي الدولية والدعوات لإنقاذ أكثر النظم البيئية تهديدا على كوكب الأرض وحماية 40 بالمائة من جميع أنواع النباتات والحيوانات التي تعيش أو تتكاثر في هذه المناطق.
جاءت احتفالية هذا العام، باليوم العالمي للأراضي الرطبة تحت شعار «حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك»، وهو شعار يعكس حجم التحديات التي تواجه مختلف دول العالم في حماية أكثر النظم الإيكولوجية تهديدا على مستوى الكوكب، بحسب ما تؤكده دراسات وتقارير أممية أعلنتها بأن الأراضي الرطبة تعتبر الأكثر عرضة لأعلى معدلات الانحسار والفقدان والتدهور.
ويذكر آخر تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة، أنه من المتوقع تواصل تردي مؤشرات الاتجاهات السلبية الراهنة في التنوع البيولوجي العالمي ووظائف النظم الإيكولوجية، نتيجة لمسببات مباشرة وغير مباشرة كالنمو السكاني السريع والإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، إلى جانب التطور التكنولوجي الكبير والآثار السلبية للتغيرات المناخية الكبيرة.
البشر والتغيرات المناخية يعصفان بالأراضي الرطبة
وتحذر هيئة الأمم المتحدة، من معدل فقدان الأراضي الرطبة التي تشكل 6 بالمائة من إجمالي مساحة الكرة الأرضية، بينما يشكل التنوع البيولوجي لها عنصرا أساسيا في الصحة البشرية والإمداد الغذائي والسياحة والوظائف
وقالت الهيئة في تقارير لها، إن التدهور يتسارع بمعدل أكبر بثلاث مرات مما تتعرض له الغابات، إذ تشير الأرقام إلى أنه وفي غضون 50 عاما فقط أي منذ سنة 1970، فقد العالم 35 بالمائة من الأراضي الرطبة، نتيجة للأنشطة البشرية وما يفرز من ملوثات الصرف الصحي، والحفر من أجل السقي، والبناء، والتلوث والصيد الجائر، وتغير المناخ.
وبفقدان مساحات مهمة من الأراضي الرطبة، يزيد تهديد التنوع البيولوجي و تتقلص البيئة الحاضنة للكائنات التي تشكل هذه الأراضي، أهمية كبرى لها، علما أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن شخصا واحدا من بين 8 أشخاص، يعتمد على سبل العيش التي توفرها مصادر الأراضي الرطبة المختلفة مثل المياه، والغذاء والنقل والترفيه، كما تساهم في حماية 60 بالمائة من البشر على كوكب الأرض، خصوصا المقيمين على طول السواحل، كونها تخفف وطأة العواصف والأعاصير وأمواج التسونامي. وعلى الرغم من أهميتها، فإن المناطق الرطبة تختفي بسرعة كبيرة بحسب ما يوضحه برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ولذلك تعمل اتفاقية المناطق الرطبة على حمايتها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الأنهار والبحيرات وحقول الأرز، ما يجعل الجميع ملزما بالحفاظ على النظم البيئية المائية التي تعد منها هذه المناطق، عن طريق اعتماد حلول مبتكرة وتحسين جودة المياه، ودعم التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز القدرة على الصمود.
خبيرة السياسات البيئية والتنمية المستدامة الدكتورة منال سخري
الأراضي الرطبة صمام أمان وحمايتها تحتاج مقاربة شاملة
أكدت الخبيرة في السياسات البيئية والتنمية المستدامة، الدكتور منال سخري، أن المناطق الرطبة تؤدي دورا محوريا في مكافحة تغير المناخ، الذي قالت إنه يتسبب إلى جانب الأنشطة البشرية الجائرة، في تراجع مساحات الأراضي وطنيا ودوليا وتدهور وظائفها البيئية. وأوضحت الخبيرة، أن المناطق الرطبة تعد من بين أكثر الأنظمة البيئية عرضة للخطر نتيجة لعدة عوامل، أبرزها ارتفاع درجات الحرارة وتزايد موجات الجفاف بفعل التغيرات المناخية، ولأنها تعد موطنا لعدد كبير من الأنواع النباتية والحيوانية بما في ذلك المهددة بالانقراض، فإن هذه التغيرات و التدهور البيئي، قد أديا بحسبها لانخفاض أعداد الكثير من الكائنات، وتسببت في تغير أنماط هجرتها وتكاثرها، وأضافت الخبيرة أن بعض الكائنات اضطرت إلى البحث عن بيئات جديدة، في حين اختفى بعضها كليا بسبب فقدان الموائل الطبيعية.
تراجع مساحتها يهدد استقرار النظم البيئية المرتبطة بها
وأكدت الخبيرة البيئية، أن الجفاف المستمر وتراجع التساقطات المطرية يؤثران بشكل مباشر على المناطق الرطبة، بحيث يؤدي كل ذلك إلى تقلص مساحات البحيرات والمسطحات المائية، وبالتالي تراجع التنوع البيولوجي. وقالت سخري، إن الأمر أصبح واضحا من خلال تراجع أعداد الطيور المهاجرة بعد أن كانت تعتمد على هذه المناطق كمحطات للراحة والتكاثر، ناهيك عن اختفاء بعض الأنواع النباتية التي تحتاج إلى مستوى معين من الرطوبة من أجل الاستمرار، مؤكدة أن انخفاض منسوب المياه الجوفية يعمق كذلك من تأثيرات هذا التغير مما يهدد استقرار النظم البيئية.
وحذرت، من خطر تحويل الأراضي الرطبة إلى مناطق زراعية أو عمرانية، مما يؤدي إلى فقدان موائل العديد من الأنواع الحيوانية، إلى جانب التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية والرعي الجائر والاستخدام المفرط للموارد المائية، ما يؤدي لاختفاء هذه المناطق على المستوى العالمي، ويهدد الأمن الغذائي والموارد المائية للعديد من المجتمعات. وأكدت الخبيرة، أن دور المناطق الرطبة محوري للغاية، حيث تساهم وبشكل كبير في مكافحة تغير المناخ، وذلك من خلال تخزين الكربون في التربة والنباتات، بما يساعد على تقليل مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مضيفة أنها تعمل أيضا كمنظومة طبيعية لتنظيم المياه، حيث تقوم بتخزين الفائض أثناء الفيضانات، لتعيد إطلاقه خلال فترات الجفاف.
50 موقعا في الجزائر على قائمة «رامسار»
وعن واقع المناطق الرطبة في الجزائر، قالت محدثتنا بأن بلادنا تصنف ضمن قائمة الدول التي تزخر بتنوع بيئي هام يشمل مناطق رطبة تمتد عبر مختلف أقاليمها من السواحل إلى المناطق الداخلية، بحيث تضم أكثر من 2500 موقع، من بينها 50 موقعا مدرجا ضمن قائمة «رامسار» للمناطق الرطبة ذات الأهمية الدولية، وتشمل هذه المناطق البحيرات الطبيعية، والمستنقعات والسبخات، وتؤدي دورا رئيسيا في حفظ التوازن البيئي ودعم التنوع البيولوجي. وأكدت الخبيرة، أنه وعلى الرغم من ثراء الجزائر بهذا التنوع، إلا أن الأراضي الرطبة تواجه تحديات متزايدة بفعل التغيرات المناخية والأنشطة البشرية، مما أدى حسبها إلى تسجيل تراجع في مساحاتها وتدهور وظائفها البيئية. وشددت المتحدثة، على ضرورة التعجيل في حمايتها محليا ودوليا من خلال تبني مقاربة شاملة تدمج بين التشريعات البيئية وإعادة تأهيل المناطق المتدهورة، وكذا إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحفاظ عليها، وأشارت أيضا إلى ضرورة تحسين طرق إدارة المياه والحد من الأنشطة الجائرة والضارة، كالبناء العشوائي والاستغلال المفرط للموارد المائية، كما تحدثت عن إمكانية تعزيز السياحة البيئية المستدامة كبديل يحافظ على هذه المناطق ويوفر فرصا اقتصادية للمجتمعات المحيطة بها.
مديرة المعهد الوطني للتكوينات البيئية حياة عاشور
هطول الأمطار بعث الحياة في المناطق الرطبة بالجزائر
أكدت مديرة المعهد الوطني للتكوينات البيئية، السيدة حياة عاشور، أن واقع المناطق الرطبة في الجزائر لا يشبه مثيله في باقي دول العالم، موضحة أنها انتعشت محليا ودبت فيها الحياة من جديد، في وقت فقد العديد منها في دول أخرى بفعل التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة والتلوث، كما أدى الوضع إلى اختفاء جميع الأنظمة الإيكولوجية.
وأوضحت، أن الجهود تتكاتف في الجزائر ويتم تنسيقها بين مختلف الوزارات والفاعلين مثل الفلاحة، والبيئة، والغابات، لإعادة تهيئة المناطق الرطبة، مشيرة إلى مشروع واد الحراش الضخم، الذي يجري العمل على تنقيته ووضع حد للتلوث على مستواه، حيث قامت وزارة البيئة وجودة الحياة بفرض محطات تصفية على المؤسسات المتسببة في التلوث لإلزامها بتصفية إفرازاتها ومعالجتها قبل صبها في الوادي، أو إعادة تدويرها واستغلالها، مؤكدة أن صرامة القانون حققت استجابة ونتائج إيجابية خاصة وأن الخرق يقابله الغلق النهائي للمؤسسة.
كما تحدثت المسؤولة، عن مشاريع كبرى عبر مختلف ولايات الوطن من أجل إعادة تهيئة المناطق الرطبة، تحت إشراف وزارة البيئة التي تقوم أساسا على منع سبل تلوث هذه المناطق وإعادة بعثها مجددا، فضلا عن استرجاع عديد الأصناف النباتية التي اختفت بهذه المناطق. وبفضل كميات مياه الأمطار والثلوج التي تساقطت خلال السنوات الأخيرة، أكدت المديرة، أنها ساهمت في إعادة إحياء الكثير من المناطق الرطبة بما فيها الوديان، البحيرات والواحات، بما ساهم في بعث التنوع البيولوجي والإيكولوجي بهذه المناطق، وهو ما من شأنه أن يساهم في إنعاش السياحة المحلية حتى على مستوى الحمامات المعدنية التي تصنف أيضا ضمن خانة المناطق الرطبة المحمية.
عمل مشترك لتأمين المناطق الرطبة ومشاريع لأخرى اصطناعية
وأضافت السيدة عاشور، أن حماية المناطق الرطبة في ظل تغيرات كثيرة تهددها بالاختفاء، تعتبر مسؤولية مشتركة مما يستدعي حسبها مساهمة جميع الفاعلين، والعمل على تحسيس فئة الأطفال والجمعيات والشباب حاملي المشاريع، من أجل التعريف بأهميتها في زيادة التنوع البيولوجي وسبل حمايتها، و أكدت أنه مشروع يندرج ضمن رزنامة المعهد ووزارة البيئة وجودة الحياة،وقد تم التركيز عليه في احتفالية هذا العام بالمناطق الرطبة على مستوى جميع دور البيئة عبر 58 ولاية. وأوضحت المسؤولة، أن العملية تمت بالتعاون مع محافظة الغابات على مستوى كل ولايات الوطن، وجمعيات الصيد بهدف التوعية بخطر الصيد الجائر، وكذا مديرية الموارد المائية التي تشكل حلقة في سلسلة حماية الأراضي الرطبة، متحدثة أيضا عن مشاريع جديدة لتنويع المناطق الرطبة وذلك عبر استحداث أخرى صناعية كـ»دنيا بارك» بالجزائر العاصمة، لزيادة الرطوبة واستقطاب الحيوانات.
إيمان زياري

عمليات قطع عشوائي في قلب الغابة
اعتداءات على أشجار الزان ببلديتي الشحنة و وجانة بجيجل
تشهد، غابة الزان بين بلديتي وجانة و الشحنة بأعالي جبال جيجل، اعتداءات متكررة على أشجار الزان، إذ تتعرض هذه الثروة الغابية لتقطيع ممنهج عبر عدة مناطق لاسيما المعزولة و البعيدة.
عرفت مؤخرا، مساحات غابية بجيجل، استفحالا في ظاهرة قطع الأشجار، وأكد مواطنون ورياضيون أنهم قدموا تبليغات للجهات المختصة للتنديد بما تتعرض له غابة الزان بين بلديتي وجانة والشحنة، من تخريب، داعين إلى حماية هذه الرئة البيئية الممتدة على مساحة 7400 هكتار تقريبا بين إقليم البلديتين معا، وحوالي 3086 هكتارا ببلدية الشحنة وحدها، وهي غابة مشتركة تتكون من عدة أصناف من الأشجار، أبرزها أشجار الزان التي تعتبر موطنا للتنوع البيولوجي، تتواجد به بعض الطيور النادرة على غرار طائر كاسر الجوز القبائلي، والرخمة المصرية وعدة أنواع وأصناف من النباتات والحشرات.
وتعتبر المنطقة بمثابة كنز إيكولوجي بفضل الغطاء النباتي الكثيف من أشجار الزان الذي يسمح بنمو بيئة متوازنة، كما أن شجرة الزان محمية وفق قانون الغابات، لكن المنطقة المشتركة بين بلديتي وجانة و الشحنة تتعرض للاعتداء منذ الأشهر القليلة الماضية حسبما رصد، وهي عملية تخريب وقطع غير شرعي للأشجار على مستوى عدة نقاط متفرقة.
وقد أوضح مواطنون وشباب يمارسون رياضة الجري في المنطقة، بأنهم وقفوا على تزايد عمليات التخريب، بعدما كانت في السابق معزولة جدا لكنهم تفاجؤوا مؤخرا، باتساع رقعة الأشجار المقطوعة، وأن العملية طالت عددا ملحوظا جدا منها، علما أن هذا القطع يستهدف مناطق معزولة و متشعبة داخل الغابة، لاسيما الشعاب أين يوجد عدد كبير من الأشجار الكبيرة و المعمرة، وقد وصل الأمر حسبهم، إلى قطع ما يفوق 6 أشجار في نفس المكان.
وأوضح المتحدثون للنصر، أنه بسبب شساعة الغابة تكثر الاعتداءات على الشجرة المحمية، مؤكدين بأنهم قاموا بتبليغ الجهات المختصة عدة مرات.
يذكر، أن أشجار الزان الكثيفة في الغابة تساهم في جعلها ملاذا لعشاق الطبيعة و الهدوء، حيث أضحت المنطقة في الآونة الأخيرة قبلة للعائلات و لممارسي الرياضة، وتم بها تنظيم تظاهرات عديدة على غرار سباق الزان الذي عرف مشاركة أزيد من 300 رياضي من مختلف ولايات الوطن، أين أعجب المشاركون بجمال الطبيعة و المناظر الخلابة و الهواء العليل.
كما يقبل على الغابات العشرات من الرياضيين الذين يفضلون المنطقة بسبب الجو المعتدل الذي تضمنه أشجار الزان، إذ تعتبر فضاء طبيعيا مناسبا جدا لهم بالنظر إلى طبيعة التضاريس، و المسلك الترابي غير المتعب، كما أنها وجهة سياحية بامتياز وتعرف توافدا كبيرا لعائلات بفضل اعتدال الحرارة وقلة الرطوبة و كثافة الأشجار الباسقة، كما تتميز المنطقة بانتشار الينابيع العذبة والبرك المائية الباردة. ك.طويل

* احتياطـــــــــي الجزائـــــر قـــادر على قلــب المـوازيـــــــن
يحيي العالم اليوم العالمي للطاقة النظيفة المصادف لـ26 جانفي من كل سنة، وسط دعوات لتسريع وتيرة الانتقال الطاقوي والتوجه نحو إمدادات معادن أساسية أو حيوية، تشكل اليوم مكونات أساسية في العديد من تقنيات الطاقة النظيفة سريعة النمو، في ظل توقعات بتضاعف الطلب عليها ثلاث مرات بحلول عام 2030.
يعتمد الانتقال العالمي إلى الطاقات المتجددة والنظيفة على إمداد مستمر من المعادن الأساسية مثل الليثيوم، والنحاس، والنيكل، والكوبالت والعناصر الأرضية النادرة التي يجري استخدامها في الكثير من الصناعات الكبرى المتعلقة بتقنيات الطاقة النظيفة، والتي تعرف نموا متسارعا بداية بتوربينات الرياح والألواح الشمسية، وتخزين البطاريات وحتى المركبات الكهربائية.
ثورة المعادن الحيوية في مواجهة الوقود الأحفوري
وقد كشف آخر تقرير للجنة الأممية المعنية بالمعادن الحيوية للانتقال الطاقوي الصادر أواخر سنة 2024، أنه من المرجح تضاعف الطلب على المعادن الحيوية ثلاث مرات تقريبا بحلول العام 2030، مع تحول العالم من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، بهدف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.
وبالتوازي مع ذلك، تشير التقارير الدولية إلى أن الحاجة للمعادن الحيوية أصبحت ملحة للغاية لتلبية طلب عالم يعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، أين تلعب هذه المعادن أدوارا متغيرة، تبدأ من بلدان نامية تشكل مصدرا لها، بحيث تحمل معها آمال شعوب ترى فيها فرصا لتوفير مناصب عمل مع تنويع في الاقتصاديات وتعزيز الإيرادات بشكل كبير، وسط تحديات بيئية واجتماعية وكذا توترات جيوسياسية، وتسارع عملية استخراج هذه المعادن.
حاجيات العالم من المعادن الأساسية في أرقام
وبحسب دراسة أنجزتها شركة الذكاء المعدني المعياري «بينشمارك مينرال أنتيليجنس» المتخصصة في دراسة المعادن، فإنه ولأجل تلبية الطلب العالمي على البطاريات بحلول عام 2030، ستكون هنالك حاجة إلى 293 منجما جديدا، علما أن الحاجة للنحاس لنفس الفترة تمثل 3.7 مليون طن، و تصل حاجة إمدادات الليثيوم إلى 1.2 مليون طن، بينما قدرت حاجة إمدادات الجرافيت الاصطناعي بـ356 ألف طن، والمنغنيز بـ319 ألف طن، أما حاجة الكوبالت، فتقدر بحلول العام 2030 بـ129 ألف طن والنيكل بـ1.7 مليون طن.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة تضاعف حجم أسواق المعادن الأساسية حول العالم، خاصة في ظل الاهتمام بتنفيذ اتفاقية باريس لمكافحة تغير المناخ ووضع حد لزيادة درجة حرارة الأرض إلى أكثر من 1.5 درجة مئوية، كما تشير الوكالة إلى توقع ارتفاع استهلاك الطاقة لهذه المعادن بنسبة 40 بالمائة بحلول العام 2040، وبنحو 60 إلى 70 أو 90 بالمائة لبعض هذه المعادن كالليثيوم، الكوبالت والألمنيوم بحلول نفس السنة مقارنة بالفترة الحالية.
* أخصائية الطاقة الدكتورة بجامعة الجلفة فاطمة الزهراء بن عراب
نجاح التعدين مرهون بطرق مبتكرة تضمن الاستدامة
تؤكد المتخصصة في مجال الطاقة، الأستاذة بجامعة الجلفة، الدكتورة فاطمة الزهراء بن عراب، أن العالم يشهد حاليا تحولات كبيرة نحو استخدام الطاقة النظيفة والكهرباء كبدائل للوقود الأحفوري، وهو تحول تقول بأنه أدى إلى زيادة هائلة للطلب على المعادن الأساسية مثل الليثيوم، النحاس، النيكل، الكوبالت والعناصر الأرضية النادرة، وكل ذلك من أجل تلبية احتياجات التصنيع في مجال البطاريات والمركبات الكهربائية والمزارع الشمسية وتوربينات الرياح، مشيرة إلى توقعات بارتفاع الطلب على هذه المعادن بنسبة تصل إلى 400 بالمائة بحلول سنة 2050 مقارنة بمستويات عام 2020.
وبالنسبة للجزائر، ترى المختصة في الطاقة أن قطاع التعدين يشكل فرصة ذهبية للمساهمة في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصادها، معتبرة أن تحقيق ذلك يستوجب تكاتف الجهود بين جميع الأطراف المعنية من أجل تبني إستراتيجية واضحة تقوم على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وتطوير الكفاءات البشرية، مع أهمية تطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، وهو ما ترى بأنه لن يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن الأساسية فحسب، بل سيساعد أيضا في بناء اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وأكدت الدكتورة بن عراب، أن الجزائر تمتلك احتياطات كبيرة من المعادن الأساسية التي يمكن لها أن تلعب دورا محوريا في تلبية الطلب العالمي المتزايد على هذه الموارد، خاصة مع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتعتبر أن منجم «غار جبيلات» الضخم، يعد حاليا من أبرز المناجم النشطة، بحيث يمثل أحد أكبر احتياطيات الحديد في العالم، إلى جانب منجم «وادي أميزور» المخصص لاستخراج الزنك.
وإلى جانب ذلك، تشير المتحدثة إلى وجود عديد المشاريع قيد التطوير من أجل استغلال الذهب والنحاس في منطقة الجنوب الجزائري.
وتضيف الأستاذة، أن الجزائر تسعى حاليا إلى تطوير قطاع التعدين من خلال التركيز على تعزيز البنية التحتية وتبني التكنولوجيا الحديثة، كما أنها تبذل جهودا لتطوير الكفاءات المحلية عبر برامج التدريب والتعاون مع مؤسسات دولية لتوفير الخبرة والمعرفة المتخصصة، وترى أن هذه المبادرات تمثل خطوات إيجابية نحو استغلال أمثل للموارد المعدنية، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني ويضمن مواكبة مثالية للطلب العالمي المتنامي.
الاستدامة لتجنب الأضرار
وتشير المتحدثة، إلى أنه وفي مقابل النمو الملحوظ الذي يشهده قطاع التعدين على المستوى العالمي، لكنه يواجه تحديات بيئية واجتماعية كبيرة، تظهر من خلال عمليات التعدين التقليدية التي تتسبب في أضرار بيئية خطيرة تشمل تلوث المياه والتربة، وكذا تدمير الموائل الطبيعية، وانبعاثات كبيرة للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وتؤكد الدكتورة بن عراب، على أنه وفي مقابل هذا النمو الكبير، فإن الحاجة أضحت أكثر من ملحة لتطوير عمليات تعدين مستدامة، من أجل التقليل من الآثار السلبية على البيئة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
ولمواجهة كل هذه التحديات وتلبية الطلب المتزايد على المعادن الأساسية مع الحفاظ على البيئة، تشدد محدثتنا على ضرورة تبني نهج يعتمد على التعدين المستدام، وهو ما اعتبرت إمكانية تحقيقه قائمة عبر استخدام تقنيات نظيفة تقلل من استهلاك المياه والطاقة، إضافة إلى إعادة تدوير البطاريات والمكونات الإلكترونية لاستعادة المعادن النادرة وتقليل الحاجة لاستخراجها من الطبيعة، منوهة أيضا إلى أهمية الاعتماد على الدراسات الجديدة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي قبل البدء في أي مشروع للتعدين، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص الذي يعتبر حسبها من الركائز الأساسية لتطوير القطاع، كما تشير إلى ضرورة فرض تشريعات صارمة تنظم عمليات التعدين وتضمن الامتثال للمعايير البيئية.
تعدين مسؤول يساوي تنمية مستدامة
تعتبر الدكتورة بن عراب، أن الأثر البيئي للتعدين يشكل تحديا كبيرا يتطلب حلولا مبتكرة لمواجهة المخاطر، وتؤكد أن تلوث المياه الناتج عن عمليات التعدين يمكن الحد منه عن طريق بناء سدود لاحتجاز المياه الحمضية، واستخدام تقنيات متطورة لمعالجة المياه، كما تعتبر إعادة تأهيل المناطق المتضررة وزرع الغطاء النباتي الطبيعي بعد انتهاء عمليات التعدين، من بين أهم الأدوار التي تساهم في تقليل الأضرار البيئية وتساعد على استعادة التنوع البيولوجي، كما تشير إلى إمكانية تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر استخدام الطاقة المتجددة في عمليات التعدين وتحسين كفاءة الطاقة.
ولأن الهدف العالمي هو حماية الكوكب والتقليل من الاحتباس الحراري، تشير محدثتنا، إلى أنه يتم تسجيل العديد من الممارسات العالمية التي تسلط الضوء على إمكانية تحقيق تعدين مستدام، كاستخدام المياه المعاد تدويرها في عمليات التعدين، بحيث يعتبر ذلك حلا تصفه الباحثة، بالفعال لتقليل استهلاك المياه العذبة.
وتتحدث بن عراب أيضا، عن طريقة لاستخلاص المعادن البيولوجية باستخدام كائنات دقيقة، وهو الحل الذي تعتبره بديلا صديقا للبيئة عن تلك الطرق التقليدية التي تعتمد على مواد كيميائية ضارة، كما تشير أيضا إلى ضرورة إعادة تدوير البطاريات المستعملة، واستغلال المعادن النادرة ما يشكل حسبها، واحدا من الحلول الواعدة التي يمكن أن تقلل من الضغط على الموارد الطبيعية.
إيمان زياري
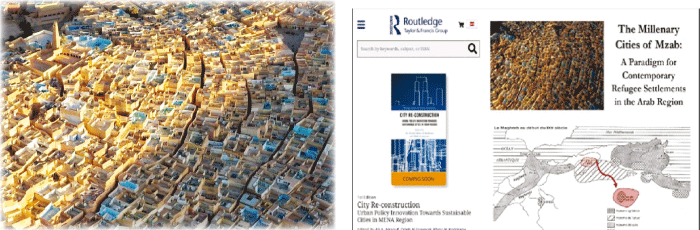
ملاجئ تقدم نموذجا قائما على الاستدامة
العالمة الجزائرية نعيمة بن كاري تنقل تجربة مباني بني ميزاب للعالم
أعلنت العالمة والبروفيسور الجزائرية، نعيمة بن كاري بوديدح، عن مشاركتها بفصل كامل في كتاب حول إعادة بناء المدينة باللغة الإنجليزية صادر عن إحدى دور النشر الأمريكية المعروفة، من خلال تقديم التجربة الجزائرية في مباني مستدامة أنشئت كملاجئ.

وتحت عنوان «من وحي مدن وادي ميزاب العريقة»، قدمت العالمة الجزائرية المقيمة بسلطنة عمان، مساهمة قيمة عن احتمال أن تحمل المدن القديمة مفتاح حل إحدى أخطر الأزمات الإنسانية اليوم، وتقول في فصلها من الكتاب الذي ينتظر صدوره في الفاتح من شهر أفريل المقبل حسبما كشفت عنه، أن مدن وادي ميزاب العريقة تشكل نموذجا لمستوطنات لاجئين معاصرة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنها تقدم رؤية جديدة لتصميم مخيمات للاجئين مستوحاة من دروس وادي ميزاب بالجزائر المصنف ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.
وأكدت البروفيسور في تصريح للنصر، أن الكثير كتب حول عمارة وادي ميزاب، إلا أنه لم يتم أبدا التطرق إليها من باب أنها كانت مدنا للاجئين وكيف شكلت حلا لعمارة اللاجئين، في وقت تعاني المنطقة العربية كثيرا من مشكلة اللجوء عبر عديد الدول التي تعيش حروبا ونزاعات. مضيفة أن نزوح الأشخاص من بيوتهم ومدنهم الأصلية وكيفية وضعهم في مخيمات وخيم ليس لها روح، يشكل تعذيبا للإنسان خاصة إذا كان قادما من مدينة عريقة، فتتحول هذه الملاجئ العشوائية إلى أماكن لا تعطي الشعور بالانتماء. وأكدت البروفسور بن كاري، أنها تقدم التجربة الجزائرية لمدن بني ميزاب، كأجمل وأعرق وأقدم الحلول التي قدمتها البشرية فيما يخص قضية اللجوء، متطرقة في ذات الفصل إلى تاريخ الإباضية بالمنطقة وكيفية تمكنها من التوسع وبناء حضارة عاصمتها تاهرت، ومنها الهروب لسدراتة الحالية التي تحتوي على آثار تحت الأرض، إلى غاية وصولها إلى مشارف الصحراء بوادي ميزاب في صحراء قاحلة بلا حياة، لتتحول إلى مكان ينبض بالحياة، في ملخص يبرز الإبداع في البناء، كما تقدم توصيات بأهمية الحفاظ على بعض المقومات لنجاح التجربة في أماكن أخرى ومع ملايين اللاجئين عبر العالم والمنطقة العربية.
دعوة لإعادة التفكير في هندسة مستوطنات اللاجئين
وتوضح الباحثة، في مساهمتها أن هذه المدن المستدامة قد تم تأسيسها من قبل الجماعة الإباضية المهجرة في القرن الحادي عشر، والتي صمدت لأكثر من ألف عام، معتبرة أنها تمثل نموذجا قويا لكيفية تحويل مخيمات اللاجئين إلى مساحات حضرية مستدامة يقودها المجتمع نفسه، فبدلا من أن تكون مجرد ملاجئ مؤقتة، تطرح فرضية استغلالها وتحويلها إلى مدن مستقلة متجانسة ثقافيا وشاملة اجتماعيا.
البروفيسور بن كاري، أوضحت أن هذا الفصل من الكتاب يربط بين التاريخ والتحديات العمرانية المعاصرة، ليقدم رؤى قيمة للمعماريين وصناع القرار والمنظمات الإنسانية الساعية إلى حلول مستدامة لأزمات اللجوء، مضيفة أنه قد تم الاستناد فيه إلى نتائج أبحاثها الشخصية في منطقة وادي ميزاب، التي سبق وأن نشرت بعضها في مقالات وكتب سابقة، وأعلنت عن فتح باب الحوار معها بكل حماس للشروع في مناقشة كيف يمكن للحكمة التاريخية أن تشكل مستقبل المجتمعات المهجرة، داعية لإعادة التفكير في مستوطنات اللاجئين بشكل جماعي.
يذكر أن العالمة والباحثة الدكتورة نعيمة بن كاري، كان قد تم تنصيبها شهر ديسمبر الفارط، من قبل المجلس الدولي للآثار والمواقع «إيكوموس»، كجهة اتصال جديدة للمجلس، سعيا لتنسيق مجموعة عمل أهداف التنمية المستدامة للفترة 2024/2027، وجاء التعيين بعد مسيرة مثمرة و عمل جاد في الإيكوموس منذ العام 2016 كعضو خبير، حيث تعاونت مع العديد من المنظمات الدولية والسلطات الوطنية، إلى جانب مساهمتها في مراجعة ترشيح مواقع التراث العالمي وبرامج بناء القدرات في جميع أنحاء المنطقة العربية وإفريقيا، كما عملت لسنوات كباحثة مشاركة في جامعة طوكيو باليابان، بينما تشغل منصب أستاذ مشارك في جامعة السلطان قابوس بعمان، بما يؤهلها للعب دور محوري لاستكمال جهود الإيكوموس لملائمة التراث التراث الثقافي مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.
إيمان زياري

نفايات صلبة وتصريف عشوائي للمياه
تحديات بيئية تهدد استمرارية واد الرمال كإرث طبيعي
شهد وادي الرمال تدهورا بيئيا كبيرا في السنوات الأخيرة، نتيجة تراكم النفايات الصلبة على ضفافه، وتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة إلى مجراه،وقد أدى هذا التلوث المتزايد، إلى تراجع جودة مياهه، مما أثر سلبا على جمالية الوادي ودوره كموطن طبيعي لحيوانات ونباتات محلية.
وللإشارة فإن وادي الرمال، يعتبر أحد أبرز المعالم الطبيعية في قسنطينة، حيث يخترق المدينة بموقعه الفريد عبر خانق عميق يصل عمقه إلى 200 متر. كما أن هذا الوادي الذي ينبع من جبال ميلة، ويصب في سد بني هارون، شكل عبر التاريخ مصدر حياة وبيئة طبيعية غنية بالتنوع الحيوي، رغم ذلك يواجه اليوم تحديات بيئية خطيرة تهدد استمراريته كإرث طبيعي حسبما ذهب إليه ناشطون بيئيون محليون.
التغيرات التي طرأت على الوادي عبر الزمن
كان وادي الرمال في الماضي رمزا للنقاء والجمال، وشكل عامل جذب للسكان والسياح، غير أن التحولات الصناعية والتوسع العمراني العشوائي في قسنطينة تسببا في تدهور حالته البيئية، وتراجع المساحة الخضراء المحيط بها، ما انعكس سلبا على التنوع البيولوجي الذي اشتهرت به المنطقة. ورغم أن دراسات حديثة أظهرت أن وادي الرمال لا يزال يحتفظ ببعض التنوع البيولوجي، مثل وجود 12 نوعا من الخفافيش التي تستوطن المنطقة المحاذية له، إلا أن استمرار التلوث يهدد بقاء هذه الأنواع ويحد من قدرتها على العيش في بيئة غير صحية.
تدهور بيئي مستمر منذ عقود
أكد الناشط البيئي و رئيس نادي الاستغوار والنشاطات الجبلية بقسنطينة أمين شانتي، أن وادي الرمال يعاني من تدهور بيئي كبير بدأ منذ فيضان سنة 1958، إذ شهد الوادي كارثة طبيعية نتيجة فيضان هائل حمل معه كميات ضخمة من الأشجار والأتربة، مما أدى إلى انسداده وارتفاع مستوى المياه بشكل غير مسبوق.
وأضاف المتحدث، أن هذا الفيضان تسبب في تدمير العديد من المعالم الأثرية المحيطة بالوادي، مثل حمامات القيصر، ومسبح سيرتا، ودرب السياح، ما أثر على القيمة التاريخية والثقافية للموقع، موضحا أن الفيضان كان مجرد بداية لمسلسل طويل من التدهور البيئي الذي يعاني منه وادي الرمال حتى يومنا هذا. متابعا بالقول، بأن أحد أهم الأسباب الحالية للتلوث هو تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة مباشرة في الوادي، مما أدى إلى تلوث مياهه بشكل كبير. وأضاف شانتي، أن السبب الثاني وراء تدهور وادي الرمال يتمثل في السلوك غير المسؤول لبعض المواطنين، الذين يرمون كميات كبيرة من النفايات في الوادي و على ضفافه، وذلك في ظل غياب وعي كاف بأهميته البيئية. مشيرا في ذات السياق، إلى أن هذه الممارسات تزيد من صعوبة تنظيف الوادي وإعادة تأهيله.
تأثير التلوث على التنوع البيولوجي بالوادي
وأكد رئيس الجمعية، أن وادي الرمال رغم تلوثه ما يزال حاضنة لتنوع بيولوجي كبير، فعلى سبيل المثال يوجد في محيطه الغراب الذي تأقلم مع الظروف البيئية الصعبة الناتجة عن التلوث. كما أشار إلى اكتشاف أنواع من الطيور التي هاجرت إلى الوادي، مثل البومة الفرعونية، وذلك أثناء عمليات التنقيب التي قامت بها الجمعية.
تعكس هذه المؤشرات على حد قوله، قدرة الوادي على احتضان الحياة البرية رغم التحديات، داعيا إلى تدخلات عاجلة لضمان الاستدامة. وأضاف المتحدث، أن غياب الاهتمام الجاد بحمايته بيئيا يعد من أبرز العقبات التي تحول دون تحسين الوضع في وادي الرمال، مشددا على أهمية وضع خطة شاملة لإعادة الاعتبار لهذا المعلم الطبيعي، تبدأ بتنظيف مجراه وضفافه، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ عليه، إضافة إلى وضع قوانين صارمة للحد من التلوث وممارسات الإهمال. كما أكد شانتي، على ضرورة تبني إستراتيجية متكاملة تعالج أسباب المشكلة من جذورها، موضحا أن طول الوادي الذي يمتد من أعالي جبال فرجيوة مرورا بالعديد من المناطق مثل عين السمارة، والعثمانية، وشلغوم العيد، وتاجنانت وصولا إلى قسنطينة،عرضة للتلوث من مختلف المصادر بما في ذلك مياه الصرف الصحي، والنفايات المنزلية والصناعية. وأشار شانتي، إلى أن الحل الأساسي يكمن في إنشاء محطات لتصفية المياه ومعالجتها على طول مسار الوادي.موضحا، أن الجمعية التي يترأسها قامت بمحاولات عدة لتنظيف أجزاء من الوادي، خاصة في المناطق القريبة من قسنطينة، كما ركزت جهودها على البحث الميداني في المواقع الأثرية المرتبطة بالوادي، مثل درب السياح وحمامات القيصر، لفهم كيف كانت هذه المعالم في الماضي وكيف تأثرت بالفيضانات والتلوث عبر الزمن.
وشدد المتحدث، على أن استعادة الصحة البيئية لوادي الرمال تحتاج إلى تكاتف الجهود بين الجمعيات البيئية والسلطات المحلية، من خلال تنفيذ مشاريع تنظيف دورية للوادي وضفافه، وكذا إطلاق حملات توعية تستهدف السكان المحليين لتغيير سلوكياتهم تجاهه، والحد من رمي النفايات، ناهيك عن تشديد الرقابة على عمليات تصريف المياه، مع فرض غرامات على المخالفين واستثمار الوادي كوجهة سياحية طبيعية، مما يساهم في زيادة الوعي بأهميته البيئية والتاريخية.
التلوث يهدد السلسلة الغذائية
أكد ممثل جمعية «إيكوسيرتا» التي تعنى بالشأن البيئي والتنوع البيولوجي وحماية الطبيعة بقسنطينة، مهدي شطيبي، أن أبرز التحديات البيئية التي تواجه الوادي حاليا، تكمن في تدفق كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي المنزلية والصناعية مباشرة إلى مياهه دون أية معالجة مسبقة، مما يؤدي إلى تفاقم التلوث، بالإضافة إلى مشكلة النفايات الصلبة التي يتم إلقاؤها من قبل السكان والتجار على طول الوادي.وأضاف المتحدث، أن الماء يعتبر العنصر الأساسي للنظم البيئية للوديان كما أن الكائنات الحية المحيطة تعتمد عليه لتشكيل نظام بيئي متوازن، ويؤدي التلوث إلى تدمير روابط أساسية في الشبكة الغذائية، مما يُحدث تأثيرًا متسلسلًا على السلسلة الغذائية بأكملها، وقد لوحظ بالفعل اختفاء بعض أنواع الأسماك والطيور التي كانت تعتمد على المياه النظيفة للوادي، مما يعكس التأثير السلبي للتلوث حسبه. ودون الإشارة إلى دراسات علمية حديثة توثق التغيرات التي طرأت على الوادي، يعتبر شطيبي، أن الملاحظات المحلية تُظهر بوضوح تراجعًا مقلقًا في الحياة المائية والطيور المرتبطة بالواد، وهذا يُعتبر دليلًا قويًا حسبه، على التغيرات السلبية الناتجة عن التلوث وتدهور النظام البيئي. مؤكدا، أن الحلول الممكنة لتقليل التلوث واستعادة صحة الوادي البيئية تتمثل بشكل رئيسي في إنشاء شبكة فعالة للصرف الصحي، تشمل قنوات مخصصة لجمع المياه المستعملة بالكامل وبناء محطات معالجة للمياه في المناطق الواقعة عند مداخل المدينة. كما أنه من الضروري في رأيه، إدارة النفايات المنزلية والتجارية بشكل مستدام، مع توفير البنية التحتية المناسبة وتوعية السكان وأوضح المتحدث، بأنه يمكن تحويل وادي الرمال إلى نموذج للاستدامة البيئية إذا تم تصنيف صخرة قسنطينة ووادي الرمال كموقع ذي أهمية بيئية وطنية، فإن ذلك يمكن أن يوفر إطارا قانونيًا لحمايته. ومن خلال استعادة صحة الوادي وتعزيز عودة تنوعه البيولوجي الأصلي، يمكن أن يصبح الموقع نموذجًا في مجال الحفظ والاستدامة البيئية. وقال، بأن أبرز المبادرات التي قامت بها الجمعية للحفاظ على وادي الرمال، تمثلت في مشروع شامل لحماية صخرة قسنطينة، يشمل الوادي ومحيطه، حيث قاموا بإنشاء خلية مراقبة بيئية بالتعاون مع السلطات المحلية، تهدف إلى متابعة حالة الموقع، والتبليغ عن أي تدهور، واقتراح الحلول المناسبة. يتمثل التحدي الأكبر كما عبر، في تنفيذ حملات التوعية والتنظيف للموقع الصعب المميز بتضاريسه الوعرة، إضافة إلى حجم التدهور وطبيعته المعقدة، كما أن تحقيق تأثير دائم يتطلب مشاركة نشطة من السلطات وجهود توعوية مستمرة للمجتمع. وأوضح شطيبي، أن المواطنين يلعبون دورًا أساسيًا من خلال تبني سلوكيات مدنية مثل عدم رمي النفايات في الوادي، وتجنب تلويثه، والتبليغ عن أي تدهور أو تلوث للجهات المعنية. وأن مشاركتهم النشطة أمر حيوي لحماية هذا التراث الطبيعي.واعتبر المتحدث، أن خلية المراقبة البيئية التي أنشئت بالتعاون مع السلطات المحلية، ضرورية لمراقبة حالة الموقع والتدخل بسرعة عند الحاجة. مضيفا، أنه على الرغم من أن العمل التطوعي ضروري لحشد المجتمع وتنظيم أنشطة مثل حملات التنظيف، إلا أنه لا يكفي للتخلص من التهديدات، التي يتطلب تجاوزها بنية تحتية مناسبة وإرادة سياسية قوية لتحقيق تغيير دائم وأكد الناشط البيئي والجمعوي، على أن واد الرمال محطة سياحية مهمة جدا ومحور ثروة بيئية، لا يتحقق استغلالها إلا من خلال الحفاظ على نظافة المكان و حمايته، معلقا بالقول إنه بمجرد حل المشكلات البيئية، يمكن أن يصبح الوادي شريانًا حيويًا للموقع، يدعم المسارات السياحية البيئية والأنشطة التعليمية المرتبطة بالتنوع البيولوجي.
لينة دلول

يواجه العالم تحديات متزايدة بفعل تغيرات مناخية كثيرة تهدد النظم البيئية، وتؤثر بشكل كبير على التنوع البيولوجي، وفي الجزائر ترصد عديد الظواهر البيئية التي تعكس اضطرابا في التوازن، فهناك كائنات حيوانية ونباتية يتهددها الانقراض، بالمقابل ظهرت أخرى جديدة أو كان يرجح انقراضها، وكلها تغيرات تترجم حسب متابعين للشأن البيئي، تبعات الاحتباس وتغيرات المناخ، وتوجب تحركات سريعة وعملية محليا وعلى المستوى الدولي من أجل تخفيف تأثيرات هذه العوامل وانقاذ الكائنات الحية.
أعدت الملف: إيمان زياري
يشكل تغير المناخ محركا رئيسيا لظهور كائنات جديدة وفقدان أنواع محلية وزيادة الأمراض، كما يتسبب بشكل مباشر في موت نباتات وأشجار كانت تعيش في بيئتها بشكل طبيعي، وهي اضطرابات يرجعها الخبراء لمشكل تغير المناخ خاصة فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة ونقص الموارد المائية وتغير أنماط هطول الأمطار، إضافة إلى تكرار الظواهر القاسية كحرائق الغابات والعواصف الشديدة التي شهدتها العديد من دول العام خلال السنوات الأخيرة وأحدثت تغيرا في البيئة العامة لهذه الدول.
كما يلعب تغير المناخ دورا رئيسيا في تدهور التنوع البيولوجي، بحيث أدى إلى تغير النظم الإيكولوجية البحرية والبرية وأثر بشكل مباشر على مصادر المياه العذبة في جميع أنحاء العالم، فضلا عن كونه سببا في فقدان أنواع محلية وزيادة الأمراض، والموت الجماعي للنباتات والحيوانات، مما أدى إلى تسجيل حالات انقراض سببها المناخ.
وقد أجبرت درجات الحرارة المرتفعة حيوانات ونباتات على الانتقال من ارتفاعات أعلى أو خطوط عرض أعلى، بحسب تقارير أممية تؤكد أن هناك كائنات انتقلت نحو قطبي الأرض، ما يؤثر سلبا على النظم البيئية على المدى البعيد ويزيد من خطر انقراض الأنواع مع كل درجة من الاحترار.
تزايد معدل الجفاف عبر 75 بالمئة من اليابسة تهديد عام
يشكل الجفاف والارتفاع المتزايد في درجات الحرارة عاملا رئيسيا في التغيرات التي تشهدها البيئة الطبيعية، بما ينعكس على المواطن المعتادة للحيوانات و يؤدي لانقراضها أو هجرتها، أو إيجاد طرق أخرى للتكيف مع هذه الظروف الجديدة، وتتسبب ذات العوامل في تدمير كلي للغابات المطيرة وتحويلها إلى جزر صغيرة مع فقدان للتنوع البيولوجي، ما يضع العالم أمام حتمية التدخل العاجل لحماية الحياة البرية بشكل خاص.ويشير تقرير للأمم المتحدة، إلى أن ما يصل إلى مليون نوع من الحيوانات مهدد بالانقراض عبر العالم والعديد منها سيختفي خلال عقود، وذلك في ظل تحول نظم بيئية لا يمكن الاستغناء عنها، من مصارف للكربون إلى مصادر لها، مثل ما يحدث في أجزاء من غابات الأمازون المطيرة بسب إزالة الأشجار، كما اختفت 85 بالمائة من الأراضي الرطبة كالمستنقعات المالحة ومستنقعات المنغروف التي تمتص كميات كبيرة من الكربون.
وتكشف آخر الدراسات الدولية، أن أكثر من 75 بالمائة من اليابسة تشهد جفافا متزايدا مع زيادة الحرائق وتدهور الغابات، مما يجعل النباتات والحياة البرية التي تعتمد على مناخات محددة تعاني بسبب ندرة المياه، فيؤدي ذلك إلى فقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظم البيئية، ويتسبب في تقلص التربة، بما يؤثر سلبا على المحاصيل ويزيد من انعدام الأمن الغذائي عالميا، علما أن زيادة الحرارة بواقع 1.5 درجة مئوية تؤدي إلى فقدان 4 بالمائة من الثدييات.

* الخبيرة في شؤون المناخ الأستاذة زينب مشياش
مؤشرات خطر ترصدها النباتات و الطيور والحشرات
تعرف أخصائية الشؤون المناخية الأستاذة زينب مشياش، التغيرات المناخية على أنها تلك التغيرات طويلة الأجل في أنماط الطقس ودرجات الحرارة على الأرض، مرجعة سبب حدوثها إلى عوامل طبيعية مثل الانفجارات البركانية وتغيرات مدار الأرض.
وتعرف هذه التغيرات تسارعا كبيرا بفعل النشاط البشري مثل انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري وقطع الأشجار، والزراعة الصناعية، ما يخلف آثارا خطيرة كارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة موجات الحرارة، وتغير أنماط الهطول، فيهدد ذلك النظم البيئية وحياة البشر على حد سواء.
وعن التأثيرات على الغطاء النباتي والحياة البرية، توضح الخبيرة أن تغير أنماط الهطول يؤدي إلى جفاف الأراضي، وأيضا حدوث الفيضانات التي تؤثر بدورها على نمو النباتات، بينما يعمل الارتفاع في درجات الحرارة على انقراض بعض أنواع النباتات غير القادرة على التكيف مع الحرارة المرتفعة.
أما فقدان الموائل الطبيعية، فتقول الأستاذة مشياش، أنه يتمثل في تراجع الغابات أو ذوبان الجليد في القطبين، مما يدفع الحيوانات إلى الهجرة أو الانقراض.
وتضيف الخبيرة أن التغيرات المناخية تلحق أيضا أضرارا كبيرة بالسلاسل الغذائية، حيث إنه عندما تتأثر النباتات التي تعتمد عليها بعض الحيوانات، يسبب ذلك خللا في التوازن البيئي، بينما تعمل زيادة الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات على تدمير بيئات الحيوانات، مما يجعل التغيرات المناخية تشكل تهديدا خطيرا للتنوع البيولوجي والأنظمة البيئية على مستوى العالم.
وبالنسبة لتأثيرات هذه التغيرات على الحياة البرية والنباتية في الجزائر، أكدت الخبيرة، أنها لم تعد مجرد مشاهد موسمية، بل تحولت إلى إشارات واضحة على التأثيرات المتزايدة للتغير المناخي.
ومن بين الظواهر الأكثر لفتا للانتباه تغير أنماط هجرة الطيور، فطائر اللقلق كما أوضحت، كان يزور الجزائر عادة خلال شهر مارس مع حلول فصل الربيع، إلا أن ظهوره مؤخرا أصبح خلال شهر ديسمبر، واصفة هذا التغير بالكبير في توقيت هجرته، ومرجعة إياه للتغيرات المناخية.
كما تحدثت، عن اختفاء أسراب طائر الزرزور المهاجر، خلال فصل الخريف من عام 2023، واصفة المشهد بغير المألوف بالنسبة للأجواء الجزائرية، خاصة وأن قدوم هذا الطائر كان يرتبط بموسم جني الزيتون، إلا أن تأثر الموسم بتغير المناخ من خلال تأخره أو ضعف المحصول نتيجة للجفاف وارتفاع درجات الحرارة، أخل بنظام ظهور الطائر.
وذكرت الباحثة كذلك، موعد تكاثر الطيور والذي تؤكد أنه تأثر أيضا أين لوحظ تأخر في العملية إلى شهر جويلية أو أوت، بعد أن كان معهودا خلال شهري أفريل و ماي، ما يعكس التأثير الكبير للتغيرات المناخية على الدورات الحيوية للأنواع.
وبالنسبة للغطاء النباتي، تحدثت الأستاذة مشياش، عن تسجيل تغير كبير قالت إنه يظهر بشكل جلي من خلال تأثر أشجار السنديان بشكل كبير أين تأجل تفتح براعمها بفعل الجفاف الذي ضرب البلاد على مدار سنوات متتالية، في حين أن براعم الأشجار القريبة من البساتين المسقية تمكنت من التفتح في شهر أفريل.
وأشارت أيضا، إلى أن الوضع أثر أيضا على الأشجار الغابية التي لم تستفق من سباتها إلا أواخر ماي، ومع تأخر سقوط الأمطار استفاقت في منتصف الشهر. كما تحدث الباحثة، عن تسجيل ملاحظات أخرى تتعلق باحمرار وتساقط جماعي لأوراق نفس الفصيلة، وهو مؤشر اعتبرته قويا على الإجهاد المائي الكبير الذي تعاني منه النباتات.
وحذرت المتحدثة، من تأثر صحة الغابات، قائلة إن أشجار الصنوبر بمنطقة الجلفة تعرضت لأضرار بالغة، وماتت العديد منها، في حين أصيبت أخرى بأمراض نتيجة الإجهاد المائي والجفاف الطويل، كما تم تسجيل اختلال في دورات الحشرات والزواحف، ولوحظت تغيرات كبيرة في دوراتها، فالحشرات التي كان من المعتاد أن تنشط في الربيع، بدأت تظهر خلال فصل الصيف، مما أدى إلى تداخلها مع الأنواع الصيفية، وفشل العديد منها في إكمال دورة الحياة بسبب نقص النباتات الخضراء اللازمة لنموها، أما الزواحف تضيف الباحثة، فقد لوحظ أن بعضها لم يدخل في سباته الشتوي المعتاد، وهو أمر اعتبرته غير طبيعي يعزى إلى تغير درجات الحرارة المستمر.
مسؤولية جماعية تفرض تدخلا مستعجلا
وللحد من آثار التغيرات المناخية وضمان مستقبل مستدام، تشدد الخبيرة المناخية زينب مشياش، على أهمية التركيز على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة للالتزام بالهدف العالمي المتمثل في إبقاء ارتفاع درجة حرارة الكوكب أٌقل من درجتين مئويتين، مع ضرورة اعتماد إستراتيجيات تكيف على المدى القصير، والمتوسط، والطويل لمواجهة التحديات المناخية. ومن بين أهم طرق التكيف، تدعو المتحدثة إلى العمل على حماية المناطق المعرضة للتصحر من خلال برامج إعادة التشجير، وزراعة أصناف نباتية مقاومة للجفاف والحرارة العالية والتركيز على زراعة الأنواع المحلية.
كما تدعو الخبيرة، إلى ضرورة تحسين إدارة الغابات والمراعي لضمان استدامتها، وتعزيز السياسات التي تمنع إزالة الغابات واستغلالها بشكل مفرط، وإنشاء محميات طبيعية جديدة لحماية النباتات النادرة والمهددة بالانقراض، كما تشير إلى حتمية العمل على استعادة النظم البيئية المتدهورة عبر مبادرات طويلة الأمد.
أما بالنسبة للحياة البرية، فتعتبر أن توفير ممرات مائية تساعد الحيوانات على الانتقال نحو مناطق مناسبة بيئيا، من أهم الحلول لمواجهة الخطر، إلى جانب تحسين الموائل الطبيعية، وتوفير مصادر مياه وغذاء للحيوانات وذلك من خلال حماية المفترسين والطرائد، وكذا مراقبة التغيرات في النظم البيئية، والتدخل عند الضرورة، والعمل على تعزيز التنوع البيولوجي عبر حماية النظم البيئية المتكاملة، ناهيك عن دعم البحوث حول كيفية تكيف الكائنات الحية مع التغيرات المناخية، خاصة وأن بعض الأنواع قد نقلت مجالها الحيوي نحو الشمال بحثا عن ظروف ملائمة للعيش. والأهم من ذلك الحرص على التعليم والتوعية من أجل تعزيز الوعي على جميع مستويات المجتمع، وكذا تكييف الإجراءات لتتانسب مع خصوصيات كل منطقة وكل إشكالية.

* رئيس الجمعية الوطنية لتوثيق الحياة البرية مراد حرز الله
الجفاف يضعف الحياة البرية وحظيرة القالة الأكثر تضررا
كشف رئيس الجمعية الوطنية لتوثيق الحياة البرية، السيد مراد حرز الله، أنه وبعد خبرة سنوات في الميدان، يمكنه تأكيد تسجيل تدهور كبير للوضع بالنسبة للغطاء النباتي وكذا الحياة البرية في الجزائر، أين تمت ملاحظة عديد التغيرات على مستوى الغرب، وتحديدا بطريق غيليزان وسيدي بلعباس، أين اصفرت جل الغابات بشكل واضح للعيان، ما يؤكد التدهور الكبير في الغابات خاصة في المناطق الغربية بسبب الجفاف الناتج عن التغيرات المناخية بالدرجة الأولى.
وتحدث حرز الله، عن تسجيل تناقص كبير في الأعشاب عبر كامل التراب الوطني سواء الطبية أو غيرها، وتراجع في الكم والنوع، كما أشار إلى نقص في الكائنات الحية سواء الطيور أو الثدييات أو الحشرات، وهو ما يدعو حسبه، إلى دق ناقوس الخطر، خاصة وأن سنة 2024 كانت كارثية على حد وصفه.
تدهور ما يقارب 80 بالمائة من الحياة البرية في الجزائر
وأوضح، أن السنوات العشر الماضية عرفت تدهور ما يقارب 80 بالمائة من الحياة البرية في الجزائر، خاصة فيما يتعلق بالطيور المهاجرة، أين تم إبلاغ إدارة الغابات بولاية برج بوعريريج، بتقلص عدد الطيور التي تمشي بمحاذاة الجداول والأنهار، بعد أن كانت بالآلاف لنحصر العدد إلى عشرات قليلة جدا، والسبب هو جفاف البرك.
مضيفا،أن مشكل الجفاف أدى كذلك إلى موت أصناف أخرى كطائر النحام الوردي، الذي اضطر ما تبقى منه للبحث عن مواطن عيش جديدة بسبب جفاف بعض بحيرات مدينة أم البواقي أين يرصد عادة، ليتم اتخاذ قرار بنقل حوالي 500 طائر إلى مكان آخر لتفادي الموت الكلي للصنف.
وقال المتحدث، إنه قبل عشر سنوات كانت عمليات الإحصاء تسجل الآلاف من صنف طائر الحدف الشتوي، لكن العدد لا يتجاوز اليوم 50 طائرا، مشيرا أيضا إلى الخطر الذي يتهدد أنواعا مصنفة كطرائد، مثل طائر الكركي، الذي قال إنه لم يشاهد أبدا سنة 2024، بالرغم من أنه اعتاد على الظهور في مجموعات كبيرة خلال السنوات الماضية.
وأوضح الخبير البيئي، أن أكبر المناطق تضررا من هذه التغيرات المناخية هي حظيرة القالة بولاية الطارف، وذلك بسبب جفاف بحيرات «قرعة» التي تعتبر المورد الرئيسي للطيور في المنطقة ومكان تجمعها وتعشيشها، وكذلك الوضع في منطقة «المقطع» مكان التقاء البحر مع واد الشلف بمستغانم، وهي منطقة مائية يبلغ مدى تأثيرها عدة ولايات منها معسكر ووهران، كونها شكلت لسنوات وجهة رئيسية للطيور المهاجرة باعتبارها رواقا غربيا لهجرة الطيور.
وقد سجلت في المكان عدة مجمعات لطيور معششة سنة 2023، إلا أن المقطع بدا شبه جاف سنة 2024، مما سيؤثر سلبا على الحياة البرية وتعشيشها وتكاثرها في المستقبل.
ويؤكد المتحدث، أن حظيرة القالة ليست الوحيدة المعنية بالخطر، وأن معظم الحظائر الوطنية مهددة وفي مقدمتها جرجرة المعروفة بتعشيش الطيور الغابية، إذ لوحظ بها السنة الماضية تدهور كبير بفعل الجفاف أثر كثيرا على الحياة بها وبخاصة على الطيور.
مضيفا، أن معظم الحظائر تواجه الخطر بسبب الاحتباس الحراري، وأن التعشيش والتكاثر تأثرا كثيرا بنقص المياه، خاصة وأن الطائر يعشش في قلب البحيرة، ما يجعله يبحث عن مناطق أخرى خارج بوصلة الهجرة المحددة لديه، بما يهدده بالتيهان وأحيانا الموت لعدم وجود المياه والغذاء، وبالتالي موت جماعي لهذه الطيور بفعل جفاف تلك البرك.
كما أكد حرز الله، أن الحظيرة الوطنية بالقالة، تضررت بشكل كبير بنسبة تقارب 90 بالمائة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية، مضيفا أن حظائر أخرى تضررت نسبيا خاصة المناطق الجبلية.

* محافظة الغابات بإيليزي حدوشي نورة
رصدنا أصنافا جديدة و سجلنا اختفاء طيور وحيوانات
أكدت محافظة الغابات بولاية إيليزي، السيدة حدوشي نورة، أن التغيرات المناخية التي يشهدها العالم بشكل عام والجزائر بشكل خاص، أثرت كثيرا على النظم البيئية، متسببة في فقدان التنوع البيولوجي.
وقالت، أن الحيوانات والنباتات التي تكيفت مع البيئة القاسية في الجنوب تعاني من صعوبة البقاء، مما يعرض بعض الأنواع لخطر الانقراض.
وتؤكد المحافظة، أن الجفاف تسبب بشكل مباشر في تغيير مواقيت هجرة الكثير من الطيور، خاصة وأن ذلك يتسبب في ندرة الغذاء، مما يقلل من محطات الراحة لديها، مشيرة إلى أن للتغيرات المناخية تأثير كبير على الجزائر ككل، فقد تسبب في الجنوب الصحراوي في تغيرات ملحوظة في معدل الهطول، إذ شحت السماء في آخر خمس سنوات كليا، بعدما كانت الأمطار تسقط بمعدل 3 إلى 4 مرات سنويا، وهذا ما تسبب حسبها، في نقص في المياه الجوفية، وموت الأشجار ومرض البعض منها، على اعتبار أن الوديان جفت ولم تعد تجري سوى مرة كل سنتين تقريبا.
من جهة ثانية، تحدثت المحافظة عن ظهور أنواع عديدة من الطيور التي لم يسبق أن مرت بالجزائر، مؤكدة أن الجفاف الذي أصاب مالي والنيجر، أجبر الطيور في تلك المناطق على الدخول إلى الجزائر والاستيطان فيها وهي ملاحظات جد مهمة، تشمل كذلك حيوانات أتت من النيجر إلى الحدود الجزائرية بحثا عن المياه.
كما تتحدث السيدة حدوش عن أشجار الآكاسيا التي مات الكثير منها بسبب الجفاف، وهو نفس الوضع بالشمال الجزائري، في ظل شح مياه الأمطار الذي أصبح يرهن نمو الأشجار، بينما كان للجزائر خزان مائي جوفي كبير بفعل تساقط الثلوج التي تناقصت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وأكدت أن الجفاف الذي يصيب اليوم معظم الكوكب، يفرض على الدول زراعة أشجار تلائم المناخ الجاف مثلما بدأت دول أوروبية بالعمل عليه كفرنسا التي تبحث اليوم عن أصناف جزائرية لزراعتها في فرنسا.وتدعو محافظة الغابات بولاية إيليزي، إلى ضرورة التشجير والاعتماد على أشجار تقاوم الجفاف في ظل التوجه نحو مناخ شبه جاف في معظم المناطق، مشددة على أهمية اختيار أصناف ملائمة، مع الالتزام بطرق سقي مبتكرة لضمان نمو الأشجار.معتبرة في معرض حديثها، أن الماء أساس الحياة النباتية والبرية و سر بقاء أشجار الزيتون والخروب، مع التأكيد على أهمية التكيف من خلال تنفيذ إستراتيجيات خاصة كالإدارة المستدامة للموارد المائية وتطوير محاصيل مقاومة الجفاف، فضلا عن تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي للحد من حجم هذه التأثيرات.
وقالت، إن الصحراء الكبرى من بين النظم البيئية الهشة التي تبقى عرضة لتأثيرات التغير المناخي، بما يفرض اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على هذا النظام البيئي الفريد ودعم السكان الذين يعيشون فيه.

ترجمت الحرفية المتخصصة في صناعة المجوهرات جميلة بكور، حبها للطبيعة وخوفها عليها من التلوث الذي يطالها، في قطع تزيين تشكلها من كبسولات القهوة التي تجمعها من المقاهي ثم تعيد تدويرها لتصنع منها قلائد وأقراط تتزين بها النساء، كما توظفها في تشكيل لوحات فنية بمواضيع مختلفة ذات عناوين بيئية وأهداف توعوية.
إيناس كبير
وتحاول السيدة بكور، التي تحب التفكير خارج الصندوق كما عبرت للنصر، أن تقدم إضافة فعالة وأن تكون فردا نافعا في المجتمع من خلال مشروعها «تابكورث آرت»الصديق للطبيعة، حيث تجتهد رفقة ناشطين في جمعيات متخصصة في حماية البيئة، التأثير في أفراد المجتمع وتمرير رسائل فنية من خلال لوحاتها التي تجمع بين الهدف التوعوي و البعد الفني الإبداعي، كما تطلع جمهور فنها وزبائن إكسسواراتها على الخطر الذي يهدد المحيط والأرض عموما بسبب مادة «الألمنيوم» التي تُصنع منها كبسولات القهوة، وتستهدف أيضا من خلال نشاطها الأطفال بلوحات تنطق بمعاناة الطبيعة التي تقف خلفها تصرفات الإنسان وأنانيته.
المشروع يبدو غريبا لكن رسالته ذات قيمة
تمنح الحرفية كبسولات القهوة المستعملة قيمة فنية من خلال تحويلها إلى تحف فنية ومجوهرات، وتوظفها كذلك في إنجاز لوحات تشكيلية تعطيها بعدا آخر بفضل الهدف الذي تضعه عند بداية العمل عليها وهو حماية البيئة من خطر مادة «الألمنيوم».
قالت لنا، إن فكرة مشروع «تابكورث آرت» جاءت فجأة، فذات صباح عندما كانت في منزلها ترتشف قهوتها، وفي لحظة تسلية قامت بضغط الكبسولة وبعين الفنانة اكتشفت أن الكبسولة تحولت إلى قطعة جميلة سرعان ما عدلتها وحولتها إلى قلادة نالت إعجاب أقاربها الذين أثنوا عليها.
مضيفة، أنها تشبعت بالفكرة مباشرة وبدأت في جمع الكبسولات من المقاهي لتشتغل عليها وقد كان عددها قليلا حينها، والطريف في الأمر كما علقت، أن أصحاب المقاهي استغربوا سؤالها عن الكبسولات في بادئ الأمر و كانوا يستفسرون منها عما ستفعله بهذه النفايات، لترد عليهم بشرح تقنية إعادة التدوير التي ستعتمدها في مشروعها وقد تقبلوا الفكرة وساعدوها كثيرا في هذه المرحلة من مشروعها.
حوَّلت السيدة بكور، إحدى غرف منزلها إلى ورشة مصغرة انطلق منها مشروع «تابكورث آرت»، وأوضحت أنها بدأت في التعرف على تقنيات مختلفة لتحويل الكبسولات إلى قلائد، وأقراط، وحاملات مفاتيح، فكانت مثلا تضغط على القطعة وتزينها بالخرز، أو تلونها حتى تظهر جميلة، ولم تكتف بما تجيده بل طورت حرفتها وأدخلت عليها تقنيات جديدة، مثل استخدام الملقط في قطع القطع للحصول على أشكال دائرية للأقراط، مؤكدة أنها عملية تتطلب صبرا كبيرا.
وأردفت الحرفية، أنها اقتحمت أيضا مجال العمل الجمعوي كعضو في جمعية للحفاظ على البيئة، وقدمت أول معرض لها وقد أُعجب الزوار بالقطع التي تصنعها، ثم استأجرت ورشة وبدأت تؤسس لعملها.
يستغرب زبائن السيدة بكور من مجوهراتها أول ما تقع أعينهم عليها، وقد أوضحت لنا، أنهم لا يتوقعون أيضا المادة التي صُنعت منها كونها تظهر في غاية الإتقان فالغالبية تظن أنها من مادة النحاس أو الفضة، وعلقت الحرفية على الأمر قائلة :»يستغرب الزبائن وتُعجبهم في الوقت نفسه فكرة تحويل قطعة من النفايات إلى تحفة ذات قيمة».
لوحات فنية تنقل رسالة الطبيعة
كبرت الحرفية على حب الفن واستغلال إبداعها لتجسيد أفكار ابتكارية، بالإضافة إلى هذا تقول إنها تحب الطبيعة جدا ومتأثرة بها لذلك فقد تضمن مشروعها إنجاز لوحات فنية أيضا، أبرزها تشكيل لوحة المرأة الإفريقية من خلال كبسولات القهوة التي خصصتها للقارة السمراء، وعبرت محدثتنا أنها جسدت حاجة الأفارقة إلى نشاط إعادة التدوير واعتماده كمصدر رزق لهم، كما تخص الأطفال أيضا برسالتها فقد أخبرتنا أنها اشتغلت على لوحة لحوض فيه أسماك بهدف توعية الأطفال بمخاطر تلوث البحار بسبب القناطير من النفايات البلاستيكية التي تُرمى فيها وتُفسد جمالها ونقاءها وتؤثر على حياة الكائنات البحرية على اختلافها.
وأردفت الفنانة، أن الأطفال يتفاعلون مع أعمالها ويجدون فسحة من التأمل فيها ومنهم من يتعلم من خلالها التعبير عن حبه للفنون التشكيلية، وفي هذا السياق، تنصح أولياء الأمور بالاعتناء بهوايات أبنائهم وتشجيعها لتمكينهم من البروز كفنانين تشكيليين، فالفرد الذي يحب مجالا ما سيبدع فيه وقد يتحول إبداعه إلى مشروع حقيقي منتج، وأوضحت أن الفنون التشكيلية أيضا مفيدة للصحة النفسية ومحفزة للتفكير الإبداعي.
وعن مستقبل مشروعها، قالت الحرفية المتخصصة في صناعة المجوهرات جميلة بكور، إنها تشارك في المعارض في الوقت الحالي كما تطمح لنقل مجوهراتها إلى متجر خاص بها.
أشجع الفنانين التشكيليين على إعادة التدوير
تتزين ورشة صاحبة مشروع «تابكورث آرت»، بأعمال فنانين آخرين تخصصوا في إعادة التدوير، وهي بهذا تشجعهم على الظهور حتى يتعرف الناس عليهم، تضيف أنها تساهم من خلاله في حماية كوكب الأرض وقد ساعدها على التقرب أكثر من الطبيعة والتعرف على المخاطر التي تهددها وبسببها أصبحت تشعر أن الإنسان غير آمن على كوكب الأرض، حيث أعلمتنا أن الكبسولات التي تجمعها تسبب خطورة كبيرة على البيئة.
لذلك فهي تحرص أيضا، على توعية المحيطين بها وتشارك هذا الهدف معهم، فأي نوع من النفايات، وفقا لها، يمكن أن يفيد الطبيعة بدل الإضرار بها، وعقبت أن بقايا القهوة التي تستخرجها من تنظيف الكبسولات تعد سمادا طبيعيا للنباتات حيث تحوله إلى الجمعيات المتخصصة في الزراعة.
ووفقا لها، فإن السنوات الأخيرة عرفت انتشار ثقافة إعادة التدوير بفضل نشاط الجمعيات، وكذا من خلال ما لمسته من آراء زبائنها الذين يشترون أعمالها فقط من أجل المساهمة في الحفاظ على البيئة.
إ.ك

غيرت السلوك الاجتماعي
برامج بسيطة تعبد الطريق نحو التحول الطاقوي الكبير
تعمل الجزائر منذ عدة سنوات على برامج اقتصادية و بيئية واعدة للمحافظة على الموارد الطبيعية للبلاد، و تحقيق الانتقال الى الطاقات المتجددة التي تعد البديل القادم للطاقات المعرضة للنفاد، و ذلك من خلال خطط و برامج يجري تنفيذها بجدية، استعدادا للمستقبل الذي بات ينذر سكان الكوكب بمزيد من التغيرات المناخية و تراجع الموارد الطبيعية التي تتعرض لاستنزاف كبير.
فريد.غ
و ترى الخبيرة الجزائرية، نشيدة قصباجي مرزوق، مديرة البحث السابقة بمركز تنمية الطاقات المتجددة (CDER) بأن الجزائر قادرة على المضي قدما في مسعى التحول الطاقوي من خلال مشاريع هامة تمتد على مدى عدة سنوات، و في انتظار ذلك يمكن القيام بعمل ميداني بسيط و محدود، لكنه سيحدث تغييرا في السلوك الاجتماعي للسكان و خطط الجماعات المحلية، و يساعد أصحاب القرار الوطني على تطوير الأفكار و استحداث المزيد من البرامج المجدية ذات التكلفة المالية القليلة.
و على المدى القصير، تقول الخبيرة الجزائرية، في دورة سابقة لتكوين الصحافيين الجزائريين في مجال البيئة و الطاقات المتجددة و الاقتصاد البديل، بأن تدريب السكان على اقتصاد الماء و الطاقة يعد خطوة هامة نحو الاندماج في المسعى الوطني للتحول الطاقوي، و بناء قاعدة محلية قوية تستجيب للبرامج و المشاريع الكبرى، التي تعتزم الجزائر انجازها لمواجهة الآثار المترتبة عن التغيرات المناخية، و ارتفاع معدلات الاحترار على كوكب الأرض.
و في هذا الإطار، دعت الباحثة البلديات إلى تركيب أنظمة لتسخين المياه بالطاقة الشمسية في المدارس، و المتوسطات و الثانويات و مباني البلديات و الدوائر، و بقطاع الصحة تركيب أنظمة حفظ و تبريد تعمل بالطاقة الشمسية بالعيادات المتعددة الخدمات، و بقطاع خدمات النقل بات من الضروري تركيب مصابيح تعمل بالطاقة الشمسية بنقاط التوقف الرئيسية، و بقطاع الصناعة يجب دعوة المستثمرين الخواص إلى تركيب الألواح الكهروضوئية لإنتاج الكهرباء، و مساعدتهم على ذلك من خلال تسهيلات لمنح القطع الأرضية، لإقامة محطات صغيرة تنتج ما يكفي من الطاقة الكهروضوئية، و التخلي التدريجي عن الطاقة الكهربائية التقليدية.
و لخفض معدلات التلوث و تحسين جودة الهواء، تنصح الخبيرة الجزائرية ببناء جدران من الأشجار حول حظائر السيارات، التي تعد إحدى مصادر انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، مؤكدة بأنه بات من الضروري إقامة تعاون وثيق بين الجامعات و هيئات البحث الوطنية، لوضع و تطبيق برامج أكاديمية مهنية في مجال الطاقات المتجددة، و تصنيع و تركيب معدات الطاقة الشمسية، و إنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة لتركيب و تشغيل و صيانة معدات الطاقة المتجددة.
وقال مركز تطوير الطاقات المتجددة، بأنه يواكب مسعى الدولة نحو التحول الطاقوي، حيث كان الداعم الرئيسي لأسبوع الطاقة الشمسية في الجزائر، المنظم يوم 10 ديسمبر 2024، مؤكدا بأنه يسعى الى تعزيز التعاون مع شركائه الاقتصاديين، ومرافقة الجهود الوطنية لإنجاح مختلف البرامج الطاقوية، خصوصا المتعلقة بمشاريع الطاقة الشمسية على غرار البرنامج الوطني لإنتاج 15000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة في آفاق 2035، كما انه يسعى لمساهمة فعالة في مرافقة المؤسسات الاقتصادية في مجال التحول الطاقوي من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم التقني و التكنولوجي لتجسيد هذه البرامج في الآجال المحددة.
و تتوفر الجزائر على عدة مصادر و انواع من الطاقة النظيفة التي ستكون البديل المستقبلي للطاقة التقليدية، حيث تمثل الطاقة الشمسية المصدر الرئيسي المحفز على التحول الطاقوي بالجزائر، الى جانب طاقة الرياح و الطاقة الحركية و الطاقة المائية، و طاقة الهيدروجين الأخضر.
و يتعمد برنامج التحول الطاقوي على التكنولوجيا و الاستثمارات العمومية و الخاصة و النصوص القانونية المنظمة و سوق محلية و دولية لبيع الإنتاج و تحقيق عائدات مالية تسمح بتوسيع الاستثمارات و صيانة المعدات، و مواكبة الابتكارات المتواصلة في هذا المجال حول العالم.

منخفض جوي ماطر بغزارة سيستمر لفترة طويلة
توقعــات بامتـداد فصـل الشتــــاء هـذا العـــام
حذر المركز العربي للمناخ، من منخفض جوي بارد وماطر بغزارة قال في بيان له، إنه سيؤثر على منطقة المغرب العربي بما فيها الجزائر، بداية من مطلع الأسبوع المقبل ويستمر إلى غاية نهايته على الأقل.
وأوضح المركز عبر موقعه الرسمي، أن التوقعات تشير إلى اندفاع كتلة هوائية باردة نحو وسط البحر الأبيض المتوسط على شكل حوض مغلق، مما يؤدي إلى تشكل منخفض جوي بارد سيتمركز في البداية حول جزيرة سردينيا، ليتحرك تدريجيا باتجاه تونس والجزائر وصولا إلى المغرب. كما نوه ، إلى أن هذا المنخفض الجوي سيمتد لفترة تعتبر طويلة، بحيث يتوقع أن تشهد معظم المناطق أمطارا غزيرة، ترافقها رعود وتساقط زخات من البرد أحيانا، مع احتمال تسجيل تساقط للثلوج على المرتفعات الجبلية العالية.
مستويات تبريد تاريخية يشهدها العالم
من جهة ثانية، قدم المركز تقريرا حول تسجيل مستويات تبريد تاريخية تتعرض لها الدوامة القطبية الشمالية، والتي أوضح أنها تشهد حاليا ظاهرة الاحترار الستراتوسفيري المفاجئ، وذلك تزامنا وارتفاع الضغط الجوي فوق القطب، مما أدى إلى ما يعرف بـ»الطور السلبي للقطب»، وهو ما يفسر تسجيل درجات حرارة أقل من معدلاتها العامة بشكل لافت. وأضاف التقرير، أن الدوامة القطبية الستراتوسفيرية، تعرف بارتفاع حرارتها عن المتوسط بشكل كبير عند حدوث احترار ستراتوسفيري مفاجئ، إلا أن ذلك لم يحدث حاليا، مما يعكس التبريد الشديد الذي تتعرض له الدوامة القطبية في المناطق الشمالية. ويرى الخبراء في المركز، أنه وبعد موجات البرد التاريخية التي اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وأمريكا خلال الأسابيع الماضية، ما تزال التوقعات تشير إلى احتمال حدوث نزولات قطبية باردة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط خلال النصف الثاني من شهر جانفي الجاري. وبالاستناد إلى المؤشرات الحالية، يتحدث المركز العربي للمناخ عن احتمال تسجيل نزولات قطبية شديدة البرودة نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط ودول الشرق الأوسط بشكل عام، كما يحتمل تسجيل امتداد فصل الشتاء إلى فترات متأخرة من فصل الربيع المقبل، وذلك بفعل المؤشرات التي تدعم احتمالية إطالة فترة النشاط الشتوي وبالتالي حدوث زيادة في فترة فصل الشتاء، إلى جانب انتشار موجات البرد بشكل ملحوظ بحيث تكون شديدة وممتدة جغرافيا.
إيمان زياري
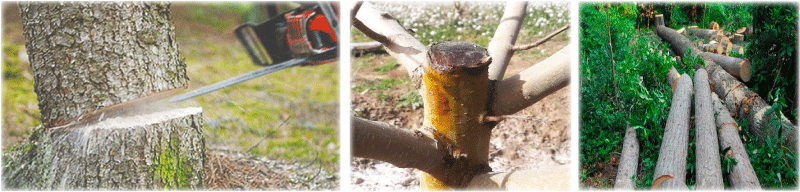
* تحصلنا على نتائج إيجابية تسمح باستبدال المواد المستوردة
تنظم مصالح الغابات مع بداية موسم البرد، علميات للقطع الصحي للأشجار على مستوى المحيط الغابي و هي عملية ضرورية جدا لحماية الثروة الغابية من الحشرات الضارة التي تنقل العدوى، كما يعد التقليم كذلك حاجة صحية للحفاظ على عمر الشجرة وسلامتها.
هـــدى طابي
تنظم مصالح الغابات مع بداية موسم البرد، علميات للقطع الصحي للأشجار على مستوى المحيط الغابي و هي عملية ضرورية جدا لحماية الثروة الغابية من الحشرات الضارة التي تنقل العدوى، كما يعد التقليم كذلك حاجة صحية للحفاظ على عمر الشجرة وسلامتها.
يلاحظ المتجول في محيط غابة ذراع الناقة بحظيرة جبل الوحش الغابية بقسنطينة، هذه الأيام، قطع مساحات محددة من الأشجار، وقد يبدو الأمر غير مفهوم أو مفاجئ في البداية، خصوصا وأن العملية تتم من قبل أعوان الغابات، وهو ما يطرح تساؤلا حول الغرض، خصوصا وأن المنطقة عرفت تدخلا مس هكتارات من الأشجار.
يوضح بهذا الخصوص المكلف بالاتصال على مستوى محافظة الغابات بقسنطينة علي زقرور، بأن العملية تتعلق أساسا ببرنامج للقطع الصحي يتم في إطار حماية الثروة الغابية وإعادة إصلاحها خصوصا بعدما تعرضت له من أضرار خلال السنوات الماضية بفعل آفة الحرائق ومشكل انتشار الحشرات الضارة.
وحسب المتحدث، فإن برنامج القطع الصحي يندرج ضمن مسار تربية وتنمية الغابات، علما أن هناك أنواعا عديدة من القطع أبرزها القطع الصحي، وقطع التنظيف، وقطع الإضاءة وغير ذلك، منها ما يتم على مستوى المحيط الغابي، ومنها ما يكون ضمن المحيط الحضري مع اختلافات ترتبط بطبيعة كل تدخل من مجموعة التدخلات التي تصنف كأشغال حرفية.
وقال، إن البرنامج الخاص بالقطع الصحي تحديدا، يشمل كلا من غابات المريج، و كاف لكحل، والجباس حاج بابا، وذراع الناقة بجبل الوحش، وقد انطلق العمل على ضبطه قبل سنوات بإشراف من أعوان متخصصين تابعين لمحافظة الغابات بقسنطينة، وذلك بناء على خرجات معاينة صحية اتضح خلالها وجود أشجار دخلت مرحلة الوفاة بعد تضرر البراعم النهائية كليا ما تسبب في اضمحلالها.
منع بيع الأخشاب المقطوعة لتجنب انتقال العدوى
وأوضح المتحدث، أنه بين جانفي ومارس من سنة2021، بوشرت أولى عمليات الجرد بالتنسيق مع المعهد الوطني للأبحاث الغابية، لإحصاء الأشجار التي أصيبت بالأمراض الطفيلية وباتت ناقلة للعدوى، أين تم تعيينها باستعمال الطلاء وقد كان العدد في تلك الفترة لا يتجاوز100 شجرة، لكنه تضاعف مع مرور السنوات وصولا إلى 2024، بسبب عديد العوامل أبرزها الحشرات الضارة والحرائق، وهو ما استدعى إلزامية القطع الصحي للأشجار الميتة ومتابعة الأشجار الأخرى في مرحلة الموت، مع وضع فخاخ للحشرات الناقلة للعدوى على مستوى الأشجار الحية والجيدة.
وحسب علي زقرور، فإن الخشب الناتج عن الأشجار التي يتم قطعها والتي تكون مريضة في الأصل لا يباع، وإن تقرر بيعه قصد تحويله إلى فحم، فإن ذلك يتم على مستوى قسنطينة فقط، وتحت مراقبة إدارة الغابات، تجنبا لانتقال العدوى إلى مناطق أخرى في حال بيع خارج إقليم الولاية.
موضحا، أن هناك إجراءات تسبق عملية بيع الخشب، أولها التخلص من القشرة الخارجية للخشب بحرقها مباشرة، قبل تحويل الجذوع لفائدة منتجي الفحم.
خطة تشجير لاستخلاف الأنواع المتضررة
وأضاف، بأن القطع الصحي في محيط غابات قسنطينة كان قد انطلق في أكتوبر 2024 بعد سنوات من المعاينة، وبناء على خطة تدخل علمية مدروسة، حيث مست العملية حوالي 17 هكتارا بغابة جبل الوحش، إلى جانب تدخلات عديدة على مستوى غابة البعراوية، وحاج بابا ومناطق أخرى، لأنها عملية ضرورية لحماية الثروة الغابية من خطر العدوى، علما أن نسبة كبيرة من الأشجار المقطوعة عبارة عن أشجار مسنة.
وتحدث المكلف بالاتصال بمحافظة الغابات بقسنطينة، عن برنامج تعويضي لاسترجاع بعض الأصناف المقطوعة أو المتضررة بغابة جبل الوحش التي وصفها بالمخبر، بالنظر إلى تنوع الأصناف على مستواها، مشيرا إلى أن هناك برنامجا للتشجير لاستخلاف الأشجار المقطوعة، يضم نفس الأنواع التي تم التخلص منها ولكن بأعداد أكبر لتوسيع المساحة، مؤكدا أن العديد من الشتلات جاهزة للغرس.
لهذا يجب قطع أو تقليم الأشجار في المناطق الحضرية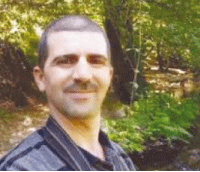
من جهته، أوضح الخبير البيئي و الإطار بمحافظة الغابات بقسنطينة عيسى فيلالي، أن القطع يختلف بحسب الحاجة، فهناك القطع الصحي وهناك نوع من القطع الوقائي، أو عند الضرورة القصوى لحماية المواطن، وهو ما يتم عادة على مستوى المناطق الحضرية، لأن هناك أشجارا كبيرة في السن تكون قد ماتت وصارت تشكل خطرا على المارة، وقد تكون هناك أشجار مريضة يتوجب الاهتمام بها. وقال إن معظم عمليات القطع التي تمس الأشجار في المحيط السكني أو العمراني، تتم بناء على شكاوى المواطنين، خصوصا عندما يتعلق الأمر ببعض الأشجار المعمرة أو كبيرة الحجم التي تبدأ تدريجيا في الميلان، أو في فقدان أغصانها ما يضاعف خطرها في ظل احتمالية سقوطها أو سقوط جزء كبير منها.
مؤكدا، أن هناك حالات لا تستدعي القطع كليا بل الزبر فقط أو التقليم لتحسين حجمها تجنبا لأية مخاطر محتملة، موضحا أن مثل هذه العمليات تكون مكثفة في موسم البرد لأن الأشجار تدخل في مرحلة تشبه السبات تحضيرا لفصل الربيع أين تعود للحياة بقوة وتباشر عملية إفراز النُسغ.
وحسب فيلالي، فإن القطع الصحي يختلف من حيث الأهمية والغرض، لأنه يهدف إلى حماية باقي الأشجار الأخرى من خطر عدوى معينة، ولا يتم بناء على طلب المواطن، بل استنادا إلى معاينة متخصصة وخبرة علمية يقوم بها أعوان محافظة الغابات.
علما أن هناك عمليات قطع لا يكون سببها مرضا محددا، بل يوجبها ما يعرف بالإجهاد الحراري أو المائي الذي تتعرض له أصناف من الأشجار على مستوى الغابات، فيضعفها ويجعلها غير قادرة على إنتاج دورة حياة أخرى فيكون من الضروري قطعها لأنها أصبحت ميتة.
هـ / ط
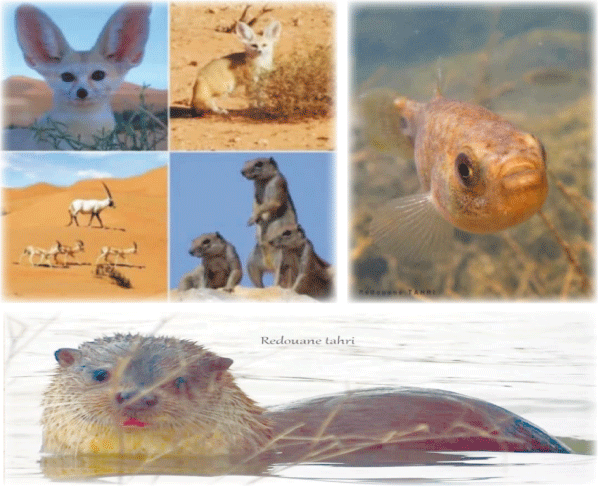
الباحث في التنوع الحيواني والنباتي رضوان طاهري
كائنات منقرضة رُصدت مجددا لأول مرة في الجنوب الجزائري
تتبع عدسة الباحث في التنوع الحيواني والنباتي، ومخرج أفلام وثائقية عن الحياة البرية، رضوان طاهري، حركات رشيقة وسريعة لحيوانات تترصد فريستها، أو تزهو راقصة على الماء مثلما هو الحال مع النحام الوردي، وفوق رمال الصحراء الجزائرية الملتهبة، وتحت مسطحاتها المائية المثيرة للغرابة، تظهر حيوانات أخرى لتؤكد عودتها للعيش على أرضنا بعد غياب دام لسنوات، أو بعدما اعتقد بانقراضها كليا، لكن ذلك لا يعني أن كل القصص سعيدة حسب صاحب قناة « البرية»، فخطر الانقراض يتهدد بعض الأصناف ويفرض ضرورة توفير محميات لها.
إيناس كبير
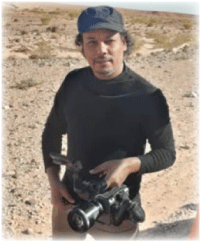
تشكل أي حركة مفاجئة في الجبال، الوديان والمغارات، بالنسبة لرضوان طاهري، بداية قصة جديدة يضمنها في فيلم وثائقي عن الحياة البرية في الصحراء الجزائرية.
ساعات من الانتظار يقضيها في الخارج متحملا قساوة الصحراء ليصور حياة أخرى تجري بعيدا عن أعين الناس، فيجازف لينقل أدق تفاصيلها لحوالي نصف مليون متابع على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «وايلد آلجيريا».
وفي عالم ألهبته الشمس على حد تعبيره، ستفاجئك سمكة تشق مياه بحيرة في معركة مع طائر أو فقمة يترصدانها هدوء الصحراء، وهكذا فإن كل مقطع ينشره على صفحته يصيبك بدهشة جديدة، كأن تعرف أن الصحراء كانت موطنا للجمبري قبل الديناصورات.
الشريط الحدودي الجزائري أصبح مأمنا للحيوانات
أرجع الباحث في التنوع الحيواني والنباتي، ومخرج الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية، ثراء التنوع البيولوجي في الجزائر إلى شساعة مساحة الأرض ومكانها الاستراتيجي الواقع بين إفريقيا وأوروبا، ومتصلا بالبحر الأبيض المتوسط، وأوضح بأن هذا المكان الدافئ أوجد تنوعا نباتيا وحيوانيا كبيرا بالإضافة إلى التنوع المناخي، إذ يمكن أن تتوالى على اليوم الواحد أربعة فصول.
وعلق طاهري قائلا :»لو ننزل إلى عين صالح سنجدها صحراء شديدة الحرارة، بينما تكون جبال جرجرة بيضاء بالثلوج»، مضيفا « يمكن أن نجد في ولاية بشار مثلا، أربعة فصول كأن تتراكم الثلوج على قمم الجبال لكن حرارة الرمال في الأسفل تظل حارقة».
تحدث الباحث في التنوع الحيواني والنباتي، عن ميزة أخرى تختص بها الجزائر وهي مناطقها الحدودية المحمية من طرف الجيش لمحاربة التهريب والمخدرات، ما جعل حركة البشر تقل هناك وبالتالي فقد وجدت الحيوانات المنطقة آمنة فأصحبت تتكاثر فيها مثل الغزلان.
أما عن المناطق التي تزخر بتنوع بيولوجي كبير، فاعتبر طاهري بأن بشار ولاية ثرية بالتنوع الحيواني والنباتي، بالإضافة إلى القالة المصنفة كمحمية، كما ذكر سلالات عديدة تزخر بها الجزائر على غرار نوع من القردة يتواجد في جبال جرجرة، وهناك العقعق المغاربي، وهو نوع من الغُرابيات، وكاسر الجوز القبائلي، الموجود في البيئة الجزائرية فقط، فضلا عن أنواع نباتية متعددة مثل سرو الطاسيلي، الذي تختص به هذه المنطقة فحسب، لذلك يرى طاهري أنه من الضروري توفير الحماية لهذه الأصناف.
أما بخصوص دوره كموثق للحياة البرية وعارف بأسرارها، فقال إنه وجد من المهم أن يساهم في توعية المواطنين بقيمة هذا الكنز الطبيعي والتحذير من الكوارث الطبيعية التي تهدده، وتؤدي إلى فقدان أنواع من الحيوانات مثلما قام به سابقا عندما نشر عن إمكانية حدوث حرائق ستقضي على طائر العقعق المغاربي، بالإضافة إلى التحذير من اختفاء بعض سلالات الغزلان.
حيوانات الصحراء الجزائرية فريدة من نوعها
كلما جُبتَ الصحراء تكتشف سلالات بعضها تعيش في موطنها الأصلي وأخرى قدمت من قارات أخرى، هكذا تحدث طاهري عن الحياة البرية جنوب الجزائر، أين توجد كائنات نادرة أهمها القضاعة المائية أو الثعلب المائي، الذي شبهه محدثنا بالفقمة، وأوضح أنه يقتات على الأسماك فقط وحساس تجاه التلوث، فلو تناول سمكة مريضة على سبيل المثال سيكون مصيره النفوق.
أخبرنا كذلك، أنه لا يوجد مكان في العالم تستوطن فيه القضاعة المائية منطقة صحراوية إلا في الجزائر، وبالتحديد في الساورة، لذلك فقد جذبت باحثين لتوثيق أسلوب عيشها وتفاعلها مع هذه البيئة الجافة، ومن المفارقات العجيبة الموجودة في صحرائنا أيضا، مشهد طائر الرفراف الأوروبي يقتات على الأسماك في منطقة شديدة الحرارة.
كما لفت أيضا، إلى سلالات مختلفة من الغزلان التي ينحصر وجودها في الجزائر وبعض الدول المجاورة، وعقب أن ولاية بشار لوحدها تعد موطنا لثلاثة أنواع من الغزلان، هي غزال الأطلس الذي يعيش في الجبال وهو نوع خاص بشمال إفريقيا، وغزال «دوركاس» الريم، يُضاف إليها غزال الأدمي، وهذه الأنواع مهددة بالانقراض بسبب كثرة صيدها.
وتتميز الكائنات الصحراوية وفقا لمخرج وثائقيات الحياة البرية، في تحديها للمنطقة القاسية التي تعيش بها من أجل البقاء، وضرب المثل بقط الرمال، الذي يعيش في مكان جاف من المياه لذلك فهو يقتات على القوارض الصغيرة ويتخذ من دمائها سائلا يروي عطشه.
كائنات رُصدت أول مرة في جنوب الجزائر
شكل العثور على سمكة «الساورانسيس» الخاصة بواد الساورة فقط، هدفا للمغامر طوال عشر سنوات، إذ أُعلن عن انقراضها سنة 2001 ولم تُشاهد في أي مكان آخر في العالم بعدها، وقد قام هو بمحاولات عديدة باحثا في عنها في الواحات، والوديان وحتى في المياه الجوفية، لكن دون نتيجة.
سنة 2024 وفي إحدى خرجاته إلى منطقة خالية من البشر، تفاجأ بوجود واد ينبع من عين وسط الرمال به طحالب ويستغله فقط أحد رعاة المنطقة وهنا خمن محدثنا، أن النبع لم يجف منذ مئات السنين فبدأ في البحث عن السمكة التي وجدها أخيرا تسبح أمام عينيه.
عبر المغامر عن الموقف قائلا: «من حسن الحظ أن الماء كان مالحا ولو كان عذبا لنفقت»، ليعود في اليوم الموالي حاملا معدات التصوير ويوثق وجودها، وقد أخبرنا أن صحفا عالمية اهتمت بالخبر وتناقلته. ومن بين الكائنات المثيرة للاهتمام أيضا «جمبري الديناصورات» الذي كشفت حفريات قديمة أنه عاش قبل الديناصورات منذ 400 مليون سنة، وبحسب وصف الباحث في التنوع الحيواني والنباتي له، فإن شكله مدرع يعيش في الحفريات وقد وجد في السنوات الأخيرة في البرية الجزائرية وبعض دول العالم. وأفاد طاهري، أن باحثين من إسبانيا تواصلوا معه لتشخيص جيناته الوراثية، حتى يحددوا ما إذا كان من السلالة نفسها المنقرضة أو يحمل جينات وراثية أخرى. كما تحدث، عن أنواع أخرى كان الباحثون يرجحون انقراضها مثل الفهد الصياد الغائب منذ عشر سنوات، والذي اتضح أنه هاجر من الجزائر قاصدا نيجيريا بسبب انتشار صيد الغزلان في بيئته ما أدى إلى فقدانه غذاءه، وبسبب الحروب التي هددت أمنه عاد مرة أخرى إلى الجزائر، وهناك النمر الأطلسي، الذي يعيش في مناطق جبلية بعيدة عن الإنسان وهو أيضا كان مغتربا، وقد أكد طاهري وجوده من خلال بعض الأدلة مثل الغزلان المعلقة على الأشجار وآثار مشيه على الأرض، بالإضافة إلى شهادة حوالي 50 صيادا ممن رأوه.
ومن الحيوانات التي أشار إلى عودتها إلى الجزائر «فقمة الراهب»، التي تبلغ حوالي ثلاثة أمتار وتعيش فقط في البحر الأبيض المتوسط، وهي غائبة منذ الثمانينات، وقد تجول في سواحل وهران وعنابة باحثا عنها إلى أن رُصدت منذ سنتين في ساحل ليبيا وبالقرب من الجزائر، وأوضح طاهري، أن الحيوانات الغائبة تعود إلى منطقة ما عندما تجد فيها الأمان أو بحثا عن الغذاء.
المحميات ضرورية للحفاظ على الحياة البرية
وأكد طاهري، على وجود حيوانات في الجزائر لم تُكتشف إلى حد الساعة، وعلق قائلا :»نحن نعيش الوقت بدل الضائع، بعض الكائنات انقرضت ولم تُسجل من الأساس».
وأرجع سبب الاختفاء إلى النشاط البشري الذي يظلم باقي الكائنات الحية التي تقاسمنا كوكب الأرض، ومن أكثر النشاطات تأثيرا فتح مسالك الطرقات في المناطق الوعرة، وبناء السدود، والاستحواذ على مناطق المياه، أو تواجد رعاة الماشية بها، وكذا الحروب والصراعات التي تجعل الحيوانات تفقد الأمان ما يؤدي إلى انقراضها أو تناقص أعدادها.
أما عن انقراض بعض الحشرات، كالفراشات التي لم تعد تزين ألوانها الطبيعة في فصل الربيع، فأوضح أن السبب يعود إلى الاستخدام العشوائي للمبيدات، فبعضها ممنوع دوليا لأنه يقضي على تنوع الحشرات وأي كائن حي.
و تطرق محدثنا كذلك، إلى استخدام أساليب حديثة لصيد الغزلان، ما أدى إلى اختفائها وانقراض أنواع أخرى مثل غزال الأطلس، كما اعتبر طاهري، أن الصيد الجائر سبب غياب بعض أنواع الطيور، محذرا من عمليات تهريب طائر الحسون عذب الصوت.
كما أشار، إلى تصرفات أخرى ظالمة للبيئة وكائناتها مثل تجارة بعض النباتات موضحا: «إن تجارا تغلب عليهم الأنانية ينسون أن الأرض وما تنبته حق لأمم مثلهم، فيقتلعون كل النباتات التي تنبت من أجل بيعها دون التفكير في باقي الكائنات». مضيفا أن بعض الأراضي في ولايات جنوبية أصبحت جرداء. وعلق الباحث في التنوع الحيواني والنباتي، ومخرج الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية، رضوان طاهري، أن الحياة البرية في الجزائر تسير نحو الأسوأ خصوصا في ظل غياب محميات بمعايير متطورة، وقلة دوريات المراقبة والحماية، داعيا إلى تكثيف هذا النشاط بما يسمح لنا بالاستمتاع بمناظر تجول الغزلان على حافة الطرقات، خصوصا منطقة الساورة التي تحتوي على تنوع طبيعي كبير لا يمكن استرجاعه في حال ضياعه.
إ.ك

تهدد الصحة وتكلف 4 مليار دولار سنويا
الاحتباس والتلوث البيئي ينشران الأمراض الاستوائية
أوضحت المنظمة العالمية للصحة، أن تواصل الاحتباس الحراري على كوكب الأرض، أصبح يهدد الصحة البشرية أكثر وأكثر، وأن الأبحاث في هذا النطاق تشير إلى أن تغير المناخ بين عامي 2030 و2050 سيتسبب في وفاة نحو 250 ألف حالة إضافية سنوياً، وستقدر تكاليف الأضرار المباشرة على الصحة بسبب تغير المناخ ما يتراوح بين 2 و4 مليارات دولار سنويا بحلول عام 2030.

وقد أظهرت حالات الإصابة بالأمراض الاستوائية مؤخرا في عدة دول من شمال الكرة الأرضية البعيدة جدا عن المدار الاستوائي، أن الملاريا، وحمى الضنك، وحمى غرب النيل، والليشمانيا وغيرها من الأمراض، لم تعد مقتصرة على النصف الجنوبي للكرة الأرضية، ولكن مع تغير المناخ وزيادة حركة السفر، بات من الواجب اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر، لأن البشر باتوا في مواجهة خطر انتشار هذه الأوبئة بشكل أكبر، مع احتمالية وصولها إلى مناطق غير معهودة.
وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة مناد سعاد أخصائية الأمراض المعدية، إن الوقاية من الأمراض الاستوائية المتنقلة عن طريق الحشرات، تشمل أساسا مكافحة الحشرات الخطرة بطرق علمية سليمة بمشاركة مختلف القطاعات و الفاعلين في مجال الصحة والبيئة و الفلاحة، و إشراك المواطن وتوعيته و تحسيسه بخطر هذه الأمراض و بمسبباتها، ليكون عضوا فعالا في تحقيق الأمن الصحي في بلادنا عبر الاهتمام أكثر بموضوع البيئة وسلامة المحيط. تنتشر الأمراض الاستوائية وفق المتحدثة، بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، حيث تكون مرتبطة بالظروف المناخية والبيئية التي تسود في تلك الجهات، ومن أهم هذه الأمراض الملاريا، وهو مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغات البعوض المصاب، الذي يأخذ الطفيلي في وجبته من خلال لدغ شخص مصاب، و تعد الحمى من أبرز أعراض الملاريا التي تتقاطع قليلا مع أعراض الأنفلونزا.
وفي حال تأخر العلاج أو غيابه، فإن المرض يتطور حسبها، إلى مضاعفات خطيرة أهمها الالتهاب الدماغي، وبفضل الجهود المكثفة للمكافحة تم القضاء على الملاريا المتنقلة محليا في الجزائر منذ 2019، منذ ذلك الوقت فإن كل الحالات هي حالات مستوردة و يعتبر هذا مكسبا مهما جدا ينبغي الحفاظ عليه كما قالت، وذلك من خلال اليقظة المستمرة و متابعة البرنامج المسطر لهذا الغرض خاصة في المناطق الحدودية.
أما مرض حمى غرب النيل، فينتقل عن طريق لدغات البعوض التي مصدرها الطيور المهاجرة كما أوضحت، و يتسبب غالبا في أعراض تتراوح بين الحمى الخفيفة إلى التهاب الدماغ الشديد.
كما ذكرت «الليشمانيا»، وهو مرض طفيلي ينتقل عن طريق لدغات ذبابة الرمل، ويمكن أن يسبب تقرحات جلدية أو إصابات داخلية خطيرة، و ينتشر في بعض المناطق الريفية أين تتوفر الظروف البيئية المناسبة لتكاثر ذبابة الرمل.
ومن الأمراض الاستوائية الأخرى نجد مرض النوم، الذي ينتقل عن طريق ذبابة «التسي تسي»، وقد يؤدي إلى الموت إذا لم يتم علاجه، و تشمل أعراضه طول فترات النوم خلال اليوم، بالإضافة إلى تضخم الغدد اللمفاوية، وتقوم ذبابة «التسي تسي» بلدغ الحيوانات أيضًا، فتصاب بمرض يُدعى «النانجا» الذي يؤثر في الإنتاج الحيواني فترتفع معدلات الوفيات بين الماشية.
بن ودان خيرة