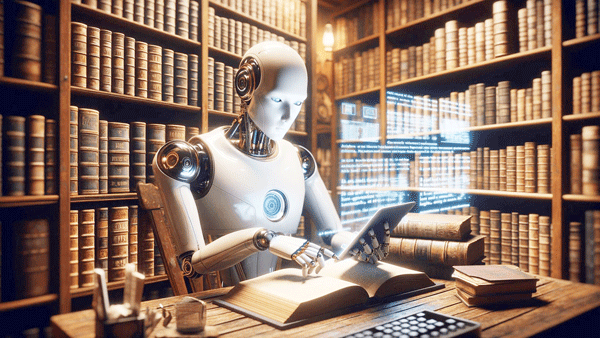
كَثر الحديث في السنوات القليلة الأخيرة عن الذّكاء الاِصطناعي وعن دوره في الفن والأدب، وما مدى تأثيره عليهما؟ وعن طُرق توظيفه، وهو أمر لا يزال يطرح نقاشات وإشكالات والكثير من الجدل. ومن بين أهم الأسئلة المطروحة: هل يُؤثر الذّكاء الاِصطناعي في/ وعلى الأدب وكيف؟ وهل يُساهم في اِنتشاره على أوسع نطاق؟، أيضاً هل يمكن للذّكاء الاِصطناعي أن يفتح آفاقًا جديدة للأدب والإبداع، أم هو مجرّد أداة، وسيبقى مجرّد أداة؟ وما هي آليات أو سياقات اِستخدام الذّكاء الاِصطناعي في الأدب وكيف؟ وما هو الدور الّذي يمكن أن يُقدمه للأدب أو لعالم الأدب؟ وهل من شأنه -حقًا- أن يُعيد تشكيل معالم الأدب، أو أن يمنح الأدباء والقُرّاء أدوات جديدة تُمكنهم من التفاعل مع الأدب بطُرق مختلفة.
أعدت الملف: نـوّارة لحـرش
حول هذا الموضوع «الذّكاء الاِصطناعي والأدب»، أو «الأدب وتحديات الذّكاء الاِصطناعي». كان ملف هذا العدد من «كراس الثقافة»، مع مجموعة من النُقاد والباحثين الأكاديميين، الذين تناولوا وقاربوا الموضوع كلٌ من زاويته وحسب وجهات نظر مختلفة ومتباينة، لكنها تلتقي وتتقاطع في الكثير من النقاط، كما تختلف في بعض التفاصيل.
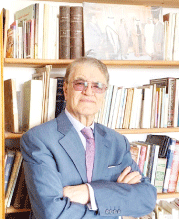
* الباحث والناقد عبد القادر فيدوح
يتيح طرقا جديدة لتطوير الإبداع
يقول الباحث والناقد، الدكتور عبد القادر فيدوح: «يُمثل الذّكاء الاِصطناعي أحد العوامل المُبتكرة التي يمكن أن تُحدِث تحولاً في طريقة تطوير الأدب بشكلٍ عام. من خلال قدرته على مُعالجة كميات ضخمة من المعلومات، وتحليل الأنماط اللغوية، كما يتيحُ الذّكاء الاِصطناعي طُرقًا جديدة لتحفيز الإبداع الأدبي وتطويره؛ كأن يُساهم في تسريع إنتاج النصوص الأدبية، وتقديم أفكار جديدة لكِتاب؛ لم يكن لديهم تصورات عنها، ما يفتح أمامهم آفاقًا واسعة لاِستكشاف أساليب جديدة».
كما يرى المُتحدث أنّ الذّكاء الاِصطناعي يُؤثر في الأدب، إذ يقول بهذا الخصوص: «يعد الذّكاء الاِصطناعي فرعًا من فروع علوم الحاسوب، ويُؤثر في الأدب بعِدة طُرق. فهو يُساعد على أتمتة Automation بعض المهام، مثل التدقيق اللغوي والتحرير، مِمّا يُوفّر وقتًا وجهدًا للكُتّاب».
كما يمكن للذّكاء الاِصطناعي -حسب الدكتور فيدوح دائماً- أن يولِّد نصوصًا إبداعية بأنماط وأساليب مختلفة، مِمّا يفتح آفاقًا جديدة للتجارب الأدبية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اِستخدام الذّكاء الاِصطناعي في تحليل النصوص الأدبية، وكشف الأنماط والاِتجاهات فيها، مِمّا يُساعد على فهم الأدب بشكلٍ أعمق.
أمّا عن إمكانية مُساهمة الذّكاء الاِصطناعي في اِنتشار الأدب، فيؤكد المُتحدّث هذا الأمر، قائلاً: «بطبيعة الحال يُساهم الذّكاء الاِصطناعي في تنويع أشكال التعبير الأدبي من خلال توفير إمكانيات جديدة، وتحدي التقاليد المُعترف بها، ويمكن اِستخدامه لتوليد أعمال تفاعلية، كما يمكن أن يكون سندًا ثمينًا للكُتّاب، في اِستكشاف آفاق إبداعية جديدة، وتحسين جودة عملهم وزيادة إنتاجيتهم، ويمكن لبرامج الذّكاء الاِصطناعي تعزيز التبادل الثقافي واللغوي بين الثقافات المُختلفة، ويُتيح فهمًا أعمق للأعمال الأدبيّة العالمية عن طريق ترجمتها آليًا إلى اللّغة العربية».
مُضيفًا في ذات السّياق: «يُمكن للذّكاء الاِصطناعي أن يفتح آفاقًا جديدة للأدب والإبداع، إذ يُوفر إمكانيات مُبتكرة لتوليد الأفكار الجديدة، وتوسيع أساليب الكتابة، وتجربة طُرق غير تقليدية في السرد. مع ذلك، يبقى في جوهره أداة يعتمد اِستخدامها وتوجيهها على الإنسان، الّذي يظل المسؤول عن الإبداع الفعلي. وبالتالي يبقى دور الإبداع في يد الإنسان».
ثم أردف: «يُستخدم الذّكاء الاِصطناعي في الأدب عبر أدوات تُساعد في توليد النصوص، وتحليل الأساليب اللغوية، عبر إنشاء شخصيات وحبكات جديدة. ويتم ذلك من خلال تقنيات مثل التعلم الآلي، والشبكات العصبية، التي تُمَكِن الذّكاء الاِصطناعي من مُحاكاة الأنماط الأدبية، واكتشاف طُرق غير تقليدية للسرد، مِمَا يدعم الكُتَّاب في توليد أفكار مبتكرة وتطوير أعمالهم. فضلاً عن ذلك، يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لفهم الأنماط اللغوية والإبداعية، مِمَا يُساعد الكُتّاب في خلق محتوى جديد أو تحسين كتاباتهم».
ذات المُتحدّث أشار إلى الدور المُهم الّذي يمكن أن يُقدمه الذّكاء الاِصطناعي للأدب ولعالم الأدب، من خلال تعزيز الإبداع، وتوسيع آفاق الكتابة، وتسريع عملية الإنتاج الأدبي. كما يُمكنه مساعدة الكُتّاب في تجاوز القيود التقليدية، وتحفيز الأفكار الجديدة، مُما يؤدي إلى تطوّر الأدب بطُرق مُبتكرة.
ويشمل هذا الدور -حسب الدكتور فيدوح- العديد من المجالات التي تُعزّز تطوّر الأدب وتُساهم في إثرائه. لعل من أهمها، -حسب رأيه-: أوّلاً: «(التحفيز على التفكير النقدي): من حيث إن الأدب يُعزز القدرة على التفكير النقدي والتحليلي. من خلال طرح قضايا أخلاقية واجتماعية وفكرية في النصوص الأدبية، ويدفع الأدب القارئ إلى مُراجعة أفكاره وتوجهاته الشخصية».
ثانياً: «(المشاركة في الحياة الثقافية): إذ يمكن للأدباء والمثقفين تنظيم الندوات والفعاليات الأدبية التي تسهم في تشجيع الحوار الثقافي، وتعزيز الاِنفتاح على الأفكار والأنماط الأدبية المختلفة».
وخلص إلى القول: «بالمُجمل، من شأن الذّكاء الاِصطناعي أن يُعيد تشكيل معالم الأدب، ويمنح الأدباء والقُرّاء أدوات جديدة تُمكنهم من التفاعل مع الأدب بطُرق مختلفة، ما يُؤدي إلى تنوع أكبر في الأشكال الأدبية وطُرق سرد القصص».

* الأكاديمي والناقد والمترجم محمّد داود
اختراع إنساني يمكن من تطوير بنيات السرد ومستويات اللغة
يؤكد الناقد والأكاديمي والمُترجم الدكتور محمّد داود أنه: «في البداية لا بدّ من التذكير أنّ الذّكاء الاِصطناعي هو وسيلة من الوسائل التكنولوجية التي اِبتكرها الإنسان لحل بعض المشاكل التي تعترضه في حياته اليومية سواء تعلق الأمر بالقضايا العلمية أو الثّقافيّة أو السياسية أو الاِقتصادية والاِجتماعية، أو غيرها من المسائل التي قد لا تخطر على البال».
مُضيفاً في ذات النقطة: «ومثلما اِبتكر الإنسان عِدة وسائل للعيش في راحة تامة والاِستمتاع بالحياة نذكر منها الطباعة والهاتف والمذياع والتلفاز والوسائل التكنولوجية الحديثة والسيارة والطائرة، يُواصل في اِبتكاراته واِنجازاته الجديدة مثلما يعرف حاليًا بالذّكاء الاِصطناعي، وهو في مجال الكتابة الأدبية قد يُوفر إمكانيات كبيرة للأديب في صياغة نصوصه وتطوير البنيات السردية لرواياته وتحسين مستوياتها اللغوية والرمزية، مع توليد مضامين ومحتويات جديدة لتلك النصوص». لكن ما يُعاب على الذّكاء الاِصطناعي -حسب الدكتور داود- هو أنّه يميلُ إلى السهولة في تلك العمليات التي قد ينزلق بالأديب إلى الاِحتيال وسرقة بطريقة «ذكية» للمجهودات التي قام بها الآخرون من الكُتّاب في مجال الإبداع. وهو الأمر الّذي -كما يضيف- يقتضي مستوى معينا من الأخلاقيات واحترام الأعراف الأدبية التي تقتضي التفرد والأصالة في الإبداع، لا التقليد الأعمى والسرقة الموصوفة. ثم يستدرك قائلاً: «ومن هنا السؤال المركزي حول هذه التقنية الجديدة التي غزت وتغزو العالم بإنتاجها للملايير من الكلمات والصور والفيديوهات وغيرها من الأدوات الترفيهية والتثقيفية، هل سيندثر الإبداع البشري ويحل محله الذّكاء الاِصطناعي؟ عِلمًا أنّ هذا الأخير هو آلة من الآلات التي تشتغل وفق برامج ذكية وخوارزميات، لكنها لا تملك ما يملكه الأديب من حساسية وسعة الخيال وقدرته على الاِشتغال على اللّغة بشكلٍ مُبهر».
ويضيف مُتسائلاً: «بمعنى آخر: فهل يُهدّد الذّكاء الاِصطناعي الكتابة الأدبية أو بالعكس فإنّه يُساعد على تبلور نهضة أدبية جديدة تسهم في تنشيط الحياة الثّقافيّة وتعطيها ديناميكية مُتميزة».
ويُواصل في ذات السّياق: «الجدير بالذِكر أنّ الأدب كان منذ القِدم إلى الآن أكبر حيز للتساؤلات الفلسفية المُرتبطة بالمراحل التّاريخيّة المُتعاقبة وبالسّياقات السّياسيّة والاِجتماعيّة المُتباينة، مِمَّا يجعلنا نتساءل عن أهمية هذا الذّكاء الاِصطناعي في التحوّلات الكُبرى التي تعرفها البشرية».
ثم أردف مستطرداً: «فمثلما أحدثت الطباعة ثورة في عالم الكُتُب والصحافة واستطاعت أن تسهم في اِنتشارهما بشكلٍ واسع في بداية النهضة الأوروبية، وقد اِنتقلت إلى العالم العربي وحفزت الكُتّاب والصحافيين على نشر ما جادت به قرائحهم وما توصلوا إليه من تحاليل واستقصاءات، لكي يكون ذلك في متناول القُرّاء الباحثين عن المعرفة الأدبية والأخبار المتنوعة، فيما سُمِيَ آنذاك «بثورة قوتنبرق» التي كانت مقدمة لثورات علمية وثقافية وفكرية أخرى قادت العالم نحو التطوّر والاِزدهار منذ القرن الخامس عشر إلى الآن».
وهنا خلص إلى القول: «في هذا الاِتجاه يُمكننا أن نقول أنّ الذّكاء الاِصطناعي سيلعب ربّما دورًا في تجديد التعامل مع الكتابة الأدبية، وسيقدم دعمًا قويًا لاِنتشار النصوص الأدبية، هذا مع العلم أنّ الذّكاء الاِصطناعي لا يعوض الجهد الإبداعي للأديب وإن قَدَمَ له بعض التسهيلات وساعده في حل بعض المشاكل الخاصة بالكتابة».

* الناقد والباحث الأكاديمي محمّد الأمين لعلاونة
الأدب كظاهرة إنسانية في خطر فعلا
يقول الناقد والباحث الأكاديمي، الدكتور محمّد الأمين لعلاونة «إذا أردنا أن نتساءل هل أَثَرَ الذّكاء الاِصطناعي على الأدب فإنّنا سنجيب بالتأكيد بنعم، لأنّ الذَّكاء الاِصطناعي لم يُؤثر على الأدب فقط؛ بل أثر على جميع مناحي الحياة البشرية التي يُعد الأدب جزءاً منها، فبرامج مثل chatgpt وOpen AI أصبحت اليوم قادرة على إنتاج خطابات ونصوص خالية من الأخطاء النحوية والتركيبية».
ومُستدركاً أضاف: «بل ذهبت أبعد من ذلك عندما اِستطاعت إنتاج نصوص جمالية وروايات كاملة وهو ما نجده مثلاً في رواية (الطريق) (1 the Road) التي حاول الذّكاء الاِصطناعي أن يُحاكي فيها رواية (جاك كيرواك)، ما يجعل الأدب في خطر فعلاً حسب تيزفيان تودوروف، ذلك أنّ الأدب ظاهرة إنسانية تتداخل فيها المشاعر والأحاسيس والتجارب وهي العناصر التي لا نجدها في الذّكاء الاِصطناعي الّذي يعتمد على الخوارزميات وفقط».
ثم أردف: «إذا تحدثنا على مساهمة الذّكاء الاِصطناعي في اِنتشار الأدب، فإنّنا سنتحدث عن مجموعة هائلة من الخوارزميات المُتعلقة بالقُرّاء من جهة، وبطبيعة الأعمال الرائجة من جهة أخرى، فعالم اليوم هو عالم الخوارزميات بلا شك، وهو الأمر الّذي يجعل الذّكاء الاِصطناعي أكثر فاعلية في عرض الأعمال الأدبية على قُرّاء بعينهم وفق نتائج البحث المختلفة لأولئك القُرّاء وهو ما نشاهده مثلاً على مواقع التواصل الاِجتماعي».
وفي ذات الفكرة، أضاف: «إذ أنّك وبمجرّد البحث عن منتج مُعين إلاّ وستجد أنَّ إعلاناً مُتعلقًا بِمَّا تبحث عنه قد أُدرج في فيديو أنت بصدد مشاهدته ما يجعلك تتساءل عن كيفية قراءة الفايس بوك لأفكارك، ليتضح مُؤخراً أنَّ إدارة الفايس بوك تقوم بالتجسس على خصوصيات المُشتركين بعرضها في شكل خوارزميات وهو ما جعل عديد المهندسين التابعين للفايسبوك أو لغوغل يستقيلون من مناصبهم لاِعتقادهم أنّ ما يقومون به مناف للأخلاق، إذًا فالذِّكاء الاِصطناعي لا ينظر إلى الأدب أو إلى الكتاب كشيء معنوي أو جمالي بقدر ما يراه سلعة يمكن أن يعرضها على متلقٍ/ مستهلك في إطار ربحي وفقط».
وهنا قال مؤكداً: «يمكن أن يفتح الذّكاء الاِصطناعي آفاقاً جديدة للأدب عن طريق ما يُسمى بالأدب التفاعلي الّذي يُمَكِن القارئ من التفاعل مع عديد النصوص الرقمية التي تعتمد على نظام الواحد والصفر Binary System كما أنّ الذّكاء الاِصطناعي وسيلة فعّالة لترجمة النصوص الأدبية إلى مختلف اللغات، إضافةً إلى تمكنه من تحويلها إلى مقاطع صوتية يمكن أن تُساعد المكفوفين من ذوي الهمم وتوصل إليهم النص بطريقة سلسة وسهلة».
هذا بالإضافة -حسب ذات المتحدث- إلى اِستطاعته رقمنة النصوص الأدبية القديمة وإخراجها للقارئ بطريقة تختصر الكثير من الوقت والجهد، كما أنه مُسوقٌ بارع للكُتُب الأدبية المُتنوعة عن طريق اِعتماده على الخوارزميات، وهو ما يجعل من الذّكاء الاِصطناعي -حسب رأيه- وسيلة مُساعدة للعملية الأدبية، غير أنّه يبقى الحذر من مستقبله ومن نُسخه المُعدلة التي يمكن أن تُنافس الأدب كظاهرة إنسانية خالصة.
المُتحدّث، يُؤكد من جهة أخرى، أنّه (نعم) يمكن أن يفتح الذَّكاء الاِصطناعي آفاقا جديدة للأدب من خلال النصوص التفاعلية التي يمكن أن يتشارك فيها المُؤلف مع الذَّكاء الاِصطناعي، وبالتالي إنتاج نص هجين يسمح بإعادة تعريف الظاهرة الأدبية ككلّ.
كما أنّه -كما يقول- يمكن أن يُساهم في هجرة الآداب عن طريق الترجمات الفورية للنصوص وتقديم أشكال سردية جديدة تتماشى وعصر العولمة الّذي نعيش فيه، كما أنّه يُمَكِّنُ القارئ من معرفة خصوصية كلّ جنس أدبي ومن صاحب النص في لمح البصر.
ليبقى الذَّكاء الاِصطناعي -كما أشار في الأخير- «سلاحاً ذا حدين، يمكن أن يُساعد الأدب كما يمكن أن يُعرضه للخطر، وهذا ما نخشاه خاصةً وما تقوم به شركات الذَّكاء الاِصطناعي من تطويرات رهيبة تُهدِدُ الإنسان وفُرصه في العمل والإبداع».

* الباحثة الأكاديمية منى صريفق
لا يمكن دحض القيمة الفعلية التي يقدمها الذّكاء الاِصطناعي للأدب
من جهتها الناقدة والباحثة الأكاديمية الدكتورة منى صريفق، تقول: «إنّ فكرة الذَّكاء الاِصطناعي قد حولت المُجتمع الّذي نعيشه إلى مجتمعات جديدة كليًا، بالاِعتماد على عنصر السرعة القصوى التي يتبناها هذا العصر؛ إذ نجده اِستحدث أو لنقل خلق أُطراً جديدة كليًا بل ومُمكنات لم تكن تخطر على بال الأجيال السابقة. فنجده قد غَيَرَ العديد من المفاهيم المُتعلقة بالكتابة الإبداعية، الكاتب والنص الأدبي وما هو المؤلف الإبداعي؟ وكيف يمكن أن نقيس مدى أصالة التجربة الكتابية سواء إبداعيًا أم أخلاقيًا. والكثير من الأسئلة التي لا يمكن حصرها في هذا المقام».
مؤكدةً في هذا الجانب، أنّ الوضع أصبح غير قابل للقياس أو حتى التفكير فيه، فالحسم في هذه الفترة متعلق كثيرا بمدى تحكمنا بهذه الآليات الجديدة عنا كليًا، وعن مدى مقاربتنا لتلك السرعة التي تنشأ عنها فلسفات جديدة مختلفة عما سبقها بفاصل زمني قصير للغاية.
ثم أردفت: «وأنا في هذا السّياق لا يمكنني دحض القيمة الفعلية التي يقدمها الذّكاء الاِصطناعي للأدب، ولن أجد نفسي ضمن جمهور الرافضين له بتاتًا، بل أنا مع فكرة ضرورة التحكم في عوالم وممكنات هذه المعطيات التي تنتج عن الذّكاء الاِصطناعي، وأن نقرر اِعترافنا كونه حقيقة دامغة تجبرنا على التخلي عن كلّ المعايير والأنماط الكلاسيكية في مقاربتنا للمفاهيم في عالم الأدب الذكي. ذلك أنه اِستطاع الدخول إلى عالم الأديب بسرعة قصوى ففتح آفاقًا جديدة للإبداع الأدبي، من خلال توليد نصوص وأنماط سردية مبتكرة».
وفي ذات الفكرة تُواصل: «كما نجد أنّه ساعد الكُتّاب على اِستكشاف أفكار جديدة، وتجريب أساليب كتابة مختلفة، وتوسيع حدود الخيال المتعلق بالمواضيع التي يقومون بكتابتها. كما نجده فعّالاً للغاية في فكرة تطوير معطيات الحوار بين شخوص اِفتراضيين؛ من خلال اِقتراح الكلمات والعبارات، وتوليد الأفكار، وتطوير الشخصيات، وتحسين الأسلوب».
وهنا تُضيف المتحدثة: «هذه الأدوات يمكن أن تزيد من إنتاجية الكُتّاب وتساعدهم على تقديم أعمال أدبية أكثر جودة. وأتذكر في هذا السّياق إقرار الكاتبة اليابانية (ري كودان) الحائزة على أرقى جائزة أدبية في اليابان أنّ برنامج الذّكاء الاِصطناعي التوليدي (تشات جي بي تي) تولّى كتابة بعض فقرات روايتها ذات المناخ المستقبلي، معتبرةً أنه ساعدها في إظهار قدراتها في مجال التأليف. وحصلت رواية كودان الأخيرة (برج الرحمة في طوكيو)، على جائزة أكوتاغاوا الأدبية نصف السنوية، وقد رأت لجنة التحكيم أنّها (تبلغ درجة من الكمال يصعب معها العثور على أي خلل فيها)».
وفي ذات المعطى، تواصل الدكتورة صريفق: «أنّ هذه المعطيات تخلق أمامنا مجموعة من التحديات، أوّلها على مستوى الأصالة والإبداع: فنجدنا نطرح التساؤل التالي: هل يمكن اِعتبار النصوص التي يولّدها الذّكاء الاِصطناعي أعمالًا أدبية أصلية؟ هل يمكن للذّكاء الاِصطناعي أن يمتلك حقًا القدرة على الإبداع؟»
ثانيها الملكية الفكرية، إذ يطرح -حسب المُتحدثة- اِستخدام الذّكاء الاِصطناعي في الأدب قضايا مُعقدة تتعلق بالملكية الفكرية. فمن يملك حقوق الملكية الفكرية للنصوص التي يُولّدها الذّكاء الاِصطناعي؟ هل هي للمبرمجين الذين طوروا الذّكاء الاِصطناعي، أم للكُتّاب الذين اِستخدموه، أم للذّكاء الاِصطناعي نفسه؟
ثالثها هو دور الكاتب البشري: إذ يُثير اِستخدام الذّكاء الاِصطناعي في الأدب -حسب رأيها- تساؤلات حول دور الكاتب البشري في المستقبل. فهل سيحل الذّكاء الاِصطناعي محل الكُتّاب البشر؟ وهل سيصبح الكُتّاب الآدميون مجرّد مساعدين للذّكاء الاِصطناعي؟
أمّا عن رابعها فهو -كما تشير- أهم سؤال بالنسبة لها ألا وهو المعايير الأدبية: لأنه قد يتطلب اِستخدام الذّكاء الاِصطناعي في الأدب إعادة النظر في المعايير الأدبية وتقييم الأعمال الأدبية.
وخلصت إلى القول: «في هذه الحال هل يجب أن تخضع النصوص التي يولّدها الذّكاء الاِصطناعي لنفس المعايير التي تخضع لها النصوص التي يكتبها البشر؟ إنّها الأسئلة التي نشأت عن الواقع الجديد بحضور الذّكاء الاِصطناعي، وشخصيًا أعتقد أنها من أهم التساؤلات التي يجب أن نجيب عنها أكاديميًا وثقافيًا بأقصى سرعة لأن الزمن الذكي لا يرحم، والمفهوم الّذي يتم الترويج له اليوم قد يموت بعد ساعات قليلة من ظهوره».

* الناقد والأكاديمي عبد الحميد ختالة
سيمكّن من تفعيل المخزون البلاغي للّغة
يقول الناقد والأكاديمي الدكتور عبد الحميد ختالة: «طُبعت النفس البشرية على أن لا تتعايش مع الجهل ولا مع الفشل، إذن فمن الطبيعي جدًا أن تجد العقل البشري يسعى دومًا إلى تجاوز المحدود إلى الممدود، مُتوسلاً في ذلك كلّ ما هو مُتاح إن على مستوى الفكرة أو على مستوى ما تُوفره التقنية، حيثُ أضاف الإنسان عقلاً إلى عقله. إذ لم تعد التقنية محصورة في مجرّد الآلة بل صارت منظومة معرفية تتطوّر آليًا فتجاوزت الراهن والمُمكن المأمول والمعهود، وقد اِنخرط الذّكاء الاِصطناعي مؤخراً في عملية هدم وبناء مستمر لجملة من الحقائق كانت تبدو جامدة».
والحال هذه، -يضيف المتحدث- «صار بإمكان الذّكاء الاِصطناعي أن يُحقّق رهانات نظرية الأدب، وأحسبه من الطبيعي والقريب جداً إلى العقل أن يتجسّم لنا ما كان مُتخيلاً من صورة ربة الشِّعر عند الإغريق وشيطان الشِّعر عند العرب، فإذا كانت اِستأنست نظرية الأدب بما قدمته مخيلة الإنسان في غيبية القوّة المُنتجة للإبداع عند الإنسان فإنّه من باب أولى أن تقبل الذّكاء الاِصطناعي مُنتجاً للشِّعر والسرد والفن جميعًا».
ثم أردف: «سيقدم الذّكاء الاِصطناعي عدداً غير منته من طرائق السرد واحتمالات الكتابة وأنماط اِستخدام أدوات التوكيد وحروف الجرّ والصور الشِّعرية، وأتصوّر أنّه بعد مرحلة تجريبية، سوف لن تطول، ستضيق رفوف الرواية بِمَا يُنتجه الذّكاء الاِصطناعي بعد أن يتمكن من (اِستعارة العالم) مرةً أخرى مثل ما حدث من قبل في كُتُب البلاغة والفكر، وسيتدثر المكان بدقة تخييلية لم يتطرق لها غاستون باشلار في جمالية المكان».
مُضيفاً في ذات السّياق: «إنّ الّذي نتكئ عليه في تصورنا هذا، هو أنّ الأدبَ مذ كان الأدبُ قد قَبِل مبدأ التجريب، قَبِله على مستوى الشكل والآلية والتصوّر والمُتخيل وكلّ مُتعلقات العملية الإبداعية، إذ لا خطر يتهدّد الأدب وهو يتوسل منظومة إدراكية وإبداعية جديدة».
وانطلاقًا من هذه القناعة -حسب رأيه- بدور الذّكاء الاِصطناعي في جعل غير المُمكن مُمكنًا تقوم التحديات الأدبية للذّكاء الاِصطناعي، مِمّا قد يسهم في أن يبلغ الأدب مراتب جديدة من مستويات الخطاب، يقدمها مبدأ الاِحتمالية الّذي تتوسع مدركاته في عوالم الحاسوب والتقنية.
واختتم بقوله: «سيتمكن الذّكاء الاِصطناعي من تفعيل كلّ المخزون البلاغي للغة وسيستحضر بمنتهى السهولة والدقة مختلف الاِستعارات القديمة والجديدة، بل سيتعداها إلى توليد جملة من التراكيب والمعاني مُتجاوزاً حدود الفهم التي قدمها تشومسكي، فإذا كنا قد اِتفقنا فيما مضى بأنّ الأدب اِبن البيئة، ثم ذهب الدرس النقدي أعمق من ذلك عندما فكك البيئة إلى أنساق وجعلها هي المنتجة للأدب حتى وإن بقيت مضمرة غير ظاهرة فيه، فكيف الأمر مع تفكك الأنساق إلى عدد غير منته من اِحتمالات السرد والبلاغة».

كسبت عروض المهرجان الثقافي الوطني للإنتاج المسرحي النسوي بعنابة، رضا الجمهور الذي استمتع منذ انطلاق الحدث بقصص ولوحات فنية من صميم وعمق المجتمع الجزائري، قدمها مبدعون ومبدعات من مختلف المسارح الجهوية، حيث كان دور المرأة بارزا بمواقفها الثورية، وتزيت نساء الركح بألبسة ذات طابع تقليدي، وتقمصن دور الأم، والحبيبة، والأخت، والزوجة، و المجاهدة طوال عمر التظاهرة المسرحية.
وميزت عروض المرأة فعاليات الختام التي جرت أمس، على ركح المسرح الجهوي عز الدين مجوبي بعنابة، وكان للمسرحيات التي تحكي عن الثورة وصناعها نصيب هام من أجندة اليوم الأخير، والتي لم تختلف كثيرا عن برنامج التظاهرة ككل، حيث تم الاحتفاء بسيدات الركح وإبراز دورهن الكبير في إعادة سرد القصص المجتمعية على اختلافها، بما في ذلك قصص نضال المرأة ومسيرتها ضد المستعمر.
ورحلت مسرحية «حلم الحياة» للمخرجة سهام كفي، بالجمهور إلى أجواء مشحونة بالعاطفة والإبداع، إذ جسد العمل واقع المرأة وصراعها من أجل تحقيق ذاتها وسط التحديات، و صورت المسرحية جانبا من مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار الفرنسي، من خلال قصة عائلة متواضعة تسكن حي القصبة العتيق، يساهم أبناؤها في العمل الثوري بأشكال مختلفة، وعلى رأسهم الأب الذي يبدي اهتماما كبيرا بما يجري في الساحة الوطنية والدولية، حاثا أبناءه على ضرورة قراءة ومعرفة تاريخ الأجداد لاستخلاص العبر منه.
كما تبرز المسرحية كذلك، مدى تغلغل الثورة في الأوساط الشعبية واحتضانها لمختلف الفئات.
من جهتها روت مسرحية «الكليبة 48» للمخرج إبراهيم نفناف، جانبا من حقيقة مشاركة الجزائر في الحرب العالمية الثانية، حيث جسد القصة الثنائي عبد الوهاب سليم شندري، وبوسعد سعيدي، وذلك من خلال شخصيتي «صالح السمينة قاهر لالمان» و«العربي»، وكان لكل منهما موقف مختلف من القضية، فالأول كان مؤمنا بضرورة المشاركة في حرب فرنسا الاستعمارية ضد النازية لأجل تحقيق وعد استقلال الجزائر، أما الثاني فكان موقنا أن فرنسا لن تفي بوعودها وبالتالي رافضا للمشاركة في حرب لا ناقة للجزائريين فيها ولا جمل.
وقد تميزت المسرحية بتحول عميق في شخصية «صالح السمينة»، ففي بداية المسرحية كانت شخصية مرحة، قدمت للجمهور دورا كوميديا، لكن بعد وفاة شقيقه واصطدامه بواقع الحرب تحول صالح، إلى شخص غير متزن، تأثر كثيرا بالحرب التي لم تحقق أية مكاسب للجزائر.
واعتمدت مسرحية الكليبة 48، بشكل كبير على قوة النص الذي مزج بين الكوميديا والتراجيديا، واستعمل لعرض التحول الجذري للشخصيات بسبب عنصر خارجي هو الاستدمار الفرنسي، واستغلاله للأفارقة في حروبه القذرة.
ودائما ضمن الأحداث الثورية، عرضت مسرحية «الساقية العظماء لا يموتون»، إخراج سامية بوناب، والتي دخلت ضمن المنافسة الرسمية على جائزة «كلثوم».
العمل من إنتاج المسرح الجهوي لسوق أهراس، يدور حول أحداث ساقية سيدي يوسف، حيث تسلط المسرحية الضوء على مصير «ربيحة»، وهي أرملة شهيد تواجه قسوة الحرب وألم فقدان ابنها «خليفة»، الذي التحق بصفوف الثورة، بينما تنضم ابنتها «حورية» إلى صفوف الهلال الأحمر التونسي.
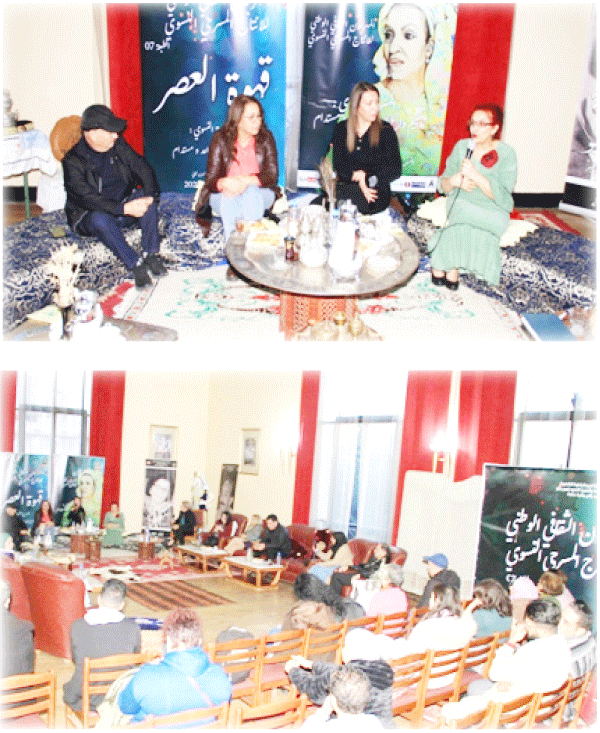
وتظهر إلى جانب هذه الشخصيات، شخصية الممرضة التونسية التي قدمتها الفنانة سالي، وبرعت في إبراز دور التضامن بين الشعبين التونسي والجزائري لمواجهة المحن، أين اختلط دم الشعبين في هذه الأحداث. وبالحضور الكبير للشخوص النسوية، أبرزت المسرحية الدور المركزي الذي لعبته المرأة في المقاومة والحفاظ على الذاكرة الجماعية.
كما جاء الديكور منسجما مع أحداث المسرحية، وكانت صور المنزل العائلي، و القرية، والمناطق الجبلية حيث يتمركز المجاهدون، وكذا البيئة الحدودية بين الجزائر وتونس، متناسقة مما يبرز البعد الجغرافي للأحداث، حيث نجح المخرج في محاكاة أجواء من التوتر والقمع والمقاومة بشكل درامي وعاطفي.
وخارج ركح المسرح ساهمت الندوات والمحاضرات التي نشطتها الأستاذة حسينة بوشيخ، مع أساتذة مختصين في المسرح وكذا ضيوف من بينهم مدراء مسارح جهوية، في إثراء النقاشات حول مواضيع مختلفة تهم المسرح النسوي الجزائري بشكل عام، وكذا المآلات والتحديات المستقبلية للمرأة المسرحية.
وأبرز الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحميد ختالة، من جامعة خنشلة، في محاضرة حول واقع المسرح النسوي، تطور هذه المؤسسة في الجزائر، قائلا: «لا يوجد تراجع لدور المرأة في المسرح، وقد كسرت الكاتبة زهور ونيسي النمطية التي تسوق لتحجيم هذا الدور في المشهد الثقافي من خلال كتاباتها، حيث قدمت عبرها تصورات جديدة تخدم المسرح النسوي». وشدد ختالة، على ضرورة رقمنة أرشيف المسارح الجهوية، ومختلف الأعمال والأنشطة الفنية، معتبرا فضاء قهوة العاصر المستحدث في هذه الطبعة، حدثا بارزا أنعش مستوى النقاش، وقال إنه جهد يستدعي التوثيق و التسجيل.
نفس الرأي شاطرته المخرجة فوزية آيت الحاج، موضحة الحاجة إلى رقمنة الأرشيف للحصول على قاعدة بيانات للجامعة، ومرجعية للباحثين. كما عرض في نفس الجلسة مدير المسرح الجهوي لوهران، تجربة رقمنة جميع الوسائط بمؤسسته، دعيا باقي المسارح للاقتداء بهذه التجربة، مع استعداده لتمرير الخبرة عبر القيام باتفاقيات تعاون.
وقد ساهم الحضور الهام للجمهور ومحبي المسرح والمختصين، في إثراء النقاش الذي مزج بين التراث والمسرح، وزينت «السينيات» النحاسية والحلويات التقليدية والقهوة والشاي، الجلسات التي تخللتها عروض غنائية تراثية ونقاشات مختلفة، منها التأليف الموسيقي والغناء في العرض المسرحي، والشعر، والفنون التشكيلية وغيرها من المواضيع.
حسين دريدح
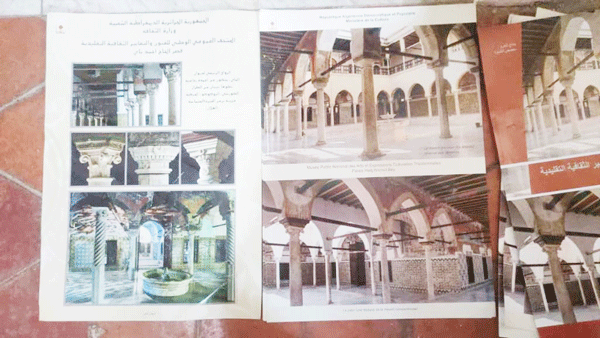
يصدر متحف الفنون والتعابير الثقافية بقسنطينة، قصر الحاج أحمد باي مجموعة من الكتب والمجلات التي تسلط الضوء على جوانب مختلفة من تاريخ وثقافة البلاد، وتهدف لحماية التراث الثقافي المحلي والوطني عموما، كما توفر مصادر موثوقة للباحثين والمجتمع الأكاديمي، لتشكل المطبوعات على اختلافها مكتبة مهمة لحفظ التراث ونقله للأجيال القادمة.
وحسب مديرة قصر الحاج أحمد باي، السيدة مريم قبايلية، فإن الإصدارات التي يقدمها المتحف تشمل مجموعة متنوعة من الكتب والمجلات والكتالوجات والكتيبات، تصدر بشكل دوري كل سنة أو سنتين، يتم إعدادها كما أوضحت، تحت إشراف قسم البحث والتوثيق الذي يضم جملة من الباحثين المتخصصين، بمن فيهم محافظو التراث وملحقو الحفظ والترميم.
وأوضحت المتحدثة، بأنهم ركزوا في الأعداد الأولى للإصدارات العلمية، على الهندسة المعمارية لقصر الحاج أحمد باي، و تناولوا بالتفصيل العناصر المعمارية المميزة مثل الزليج، والرخام، والمجموعات الخشبية التي تتضمن النوافذ والأبواب الفريدة في القصر.
وأضافت قبايلية، أن من بين هذه الإصدارات، مجلة «بوليكرومي»، التي تُعتبر مرآة للنشاطات العلمية والثقافية للمتحف، و تصدر كل سنتين وقد وصلت إلى عددها الخامس السنة الماضية، كما يخصص كل عدد منها لموضوع محدد يعكس جوانب من التراث الثقافي.
وأضافت المديرة، أنه يتم التحضير حاليا لإصدار العدد السادس من المجلة، الذي سيغطي مختلف النشاطات العلمية والثقافية للمتحف، مؤكدة في ذات السياق، أن هذا العدد سيتضمن توثيقا للمحاضرات التي يقدمها أساتذة وباحثون جامعيون تتم دعوتهم بشكل دوري لتسليط الضوء على موضوعات تتعلق بالتراث الثقافي الجزائري، سواء كان ماديا أو غير مادي.
وتطرقت قبايلية، إلى آخر إصدار قدمه المتحف، وهو كتاب يوثق رحلة الحاج أحمد باي إلى البقاع المقدسة، استند تحضيره إلى معطيات الجدارية الموجودة حاليا في المتحف، باعتبارها شاهدا ماديا هاما على تلك الرحلة، التي توثق لمختلف الحواضر التي زارها الباي، مضيفة أن المؤرخين والباحثين قد استدلوا بهذه الجدارية لدراسة تفاصيل الرحلة.
إصدار جديد قبل نهاية السنة
وأشارت المتحدثة، إلى أن المتحف أصدر في ديسمبر 2024 كتابا صغيرا عن «التلحيفة» والملحفة في الجزائر، موضحة أن العمل تناول الطابع الوطني الشامل للمتحف، الذي يعكس تراث كل مناطق الوطن وليس منطقة الشرق فقط.
كما سلط الكتاب الضوء على كيفية اختلاف أشكال التلحيفة والملحفة بين الشرق، الغرب، الجنوب، والوسط، مع دراسة تفصيلية لقماشها، وألوانها، وطريقة ارتدائها في كل منطقة.
وأكدت قبايلية، أن الهدف الأساسي من هذه الإصدارات يتمثل في التوثيق والتثقيف والترويج للتراث، إضافة إلى التدوين والحفظ للأجيال القادمة، معتبرة أن هذا العمل يمثل رصيدا ثقافيا مهما يسهم في صون الهوية الوطنية والحفاظ على الموروث الثقافي الجزائري.
وأوضحت قبايلية، أن المتحف يقوم بزيارات منتظمة إلى المؤسسات التربوية، حيث تقدم هذه الإصدارات كهبات لدعم المعرفة والتوعية بالتراث الثقافي.
وتشمل المبادرات أيضا، تقديم الكتب كهدايا إلى مؤسسات إعادة التأهيل، وتوفيرها خلال المعارض التي يشارك فيها المتحف سواء داخل قسنطينة أو خارجها.
مضيفة، أن بعض الإصدارات تطرح للبيع بهدف توثيق التراث والترويج له وحمايته، ناهيك عن مساعدة الباحثين والأكاديميين الذين يعملون على إعداد أطروحات أو دراسات علمية، حيث يوفر المتحف لهم مصادر ومراجع موثوقة تساهم في دعم أبحاثهم وإثراء دراساتهم.
مراجع تثري البنك الوطني للمعلومات
وأشارت قبايلية، إلى أن اختيار مواضيع الإصدارات يتم بعناية فائقة حيث يركز الباحثون في كل مرة على جانب مهم من التراث، بهدف تسليط الضوء عليه وحفظه للأجيال القادمة.
وأوضحت، أن الجمهور المستهدف يشمل شرائح متنوعة من المجتمع، بداية بالباحثين والأكاديميين، مرورا إلى الجمهور العام والأطفال، ووصولا إلى مراكز البحث والمجتمع المدني، وحتى الزوار الأجانب من خارج الوطن.
وأكدت، أن المتحف أصبح وجهة رئيسية في مدينة قسنطينة، بفضل تنوع نشاطاته وإصداراته التي تقدم في شكل مكتوب وبأكثر من لغة، مشيرة في سياق منفصل، إلى أنه يتم تعزيز هذه الإصدارات بصور قديمة وحديثة، إلى جانب مخططات توضيحية وقوائم المصادر والمراجع، مما يجعلها مرجعا غنيا بالمعلومات.

وأضافت المديرة، أن المتحف يوفر إمكانية الحصول على هذه الإصدارات بطرق متعددة، حيث يتم تقديم بعضها كهبات، بينما تباع الأخرى عن طريق منافذ متخصصة.
كما تتيح مكتبة المتحف للزوار فرصة الإطلاع عليها والاستفادة منها مجانا، مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي ونشر المعرفة بين مختلف فئات المجتمع.
بين الترويج الرقمي ودعم ملفات التصنيف العالمي للتراث
وأكدت قبايلية، أن المتحف يعمل على الترويج لإصداراته بطرق متنوعة تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي الخاص به، وكذا من خلال المعارض التي يشارك فيها، حيث تعرض بحسبها جميع الإصدارات أمام الجمهور، مما يعزز من انتشارها ويزيد من وعي الناس بأهميتها.
وأضافت المتحدثة، أن المتحف يعمل حاليا على توفير نسخ إلكترونية من إصداراته، تماشيا مع استراتيجية الرقمنة الوطنية التي تهدف إلى رقمنة القطاع الثقافي، مثلما هو الحال في قطاعات أخرى، كما أشارت إلى وجود خطط لتطوير الإصدارات المستقبلية، سواء من خلال توسيع المواضيع التي تتناولها أو تقديمها بشكل جديد يخدم أهداف المتحف العلمية والثقافية.
وأوضحت، أن فريق العمل يواجه أحيانا صعوبات في العثور على المصادر والمراجع الكافية، ما يتطلب بذل جهد إضافي في البحث والتعمق، وهو ما قد يستغرق وقتا أطول لإتمام بعض الإصدارات، مع ذلك يظل هذا الجهد ضروريا لضمان تقديم مادة علمية دقيقة وموثوقة.
وأكدت، أن المتحف لا يسلط الضوء فقط على التراث المعروض داخله، بل يتناول مختلف جوانب التراث الجزائري بشقيه المادي وغير المادي. كما يولي اهتماما خاصا لمدينة قسنطينة، من خلال التركيز على إبراز عاداتها وتقاليدها المتجذرة، مثل عادة «التقطير» التي لا تزال العائلات القسنطينية تحافظ عليها، فضلا عن التوثيق الجيد للمطبخ المحلي بمختلف وصفاته التقليدية، ناهيك عن الاهتمام بكل ما يرمز للهوية الثقافية للمدينة.
وأشارت، إلى إصدار سابق حول مؤسس قصر الحاج أحمد باي، تحدث عن حاكم بايلك الشرق الجزائري أحمد بن محمد الشريف، كونه آخر حكام الشرق الجزائري.
وأضافت المديرة، أن هذه الإصدارات لها دور بالغ الأهمية في ملفات تصنيف التراث الجزائري ضمن قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، خصوصا وأن المنظمة تشترط وجود جرد وطني دقيق وشامل للتراث، وهو ما يعد جزءا من مهمة المتحف كمؤسسة وطنية تعمل تحت وصاية الدولة.
وبالتالي فإن المتحف يقوم بتزويد البنك الوطني للمعطيات، بوثائق متنوعة تشمل مواد سمعية ومكتوبة وبصرية، كما ينتج شرائط وثائقية سنوية تبرز جوانب مختلفة من التراث، أبرزها شريط وثائقي عن «السراوي»، وهو لون من الغناء الشعبي الجزائري، إلى جانب إعداد ملفات تهدف إلى تسجيله ضمن قائمة التراث العالمي.
لينة دلول
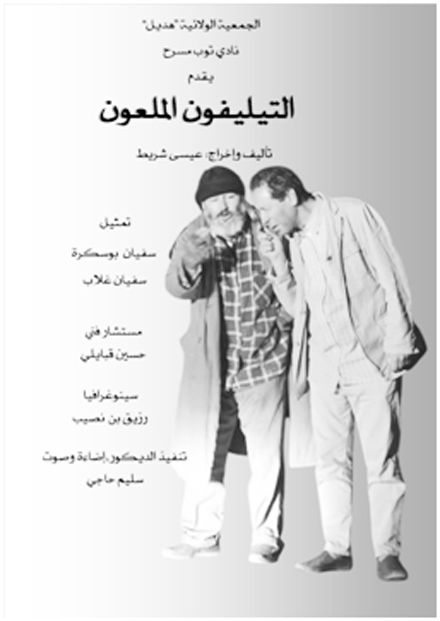
يعرض قريبا، على ركح برج بوعريريج، عمل جديد للمؤلف و المخرج عيسى شريط، بعنوان «التيليفون الملعون» تمثيل سفيان بوسكرة، وسفيان غلاب، وسينوغرافيا رزيق نصيب.
المسرحية كوميدية تراجيدية، مدتها 60 دقيقة، وتجري أحداثها حسب مخرجها، في محطة قطار قديمة، أين ينتظر «التهامي» مكالمة هاتفية مهمة قد تَزفّ إليه بشرى الحكم في قضية زوجته «زوينة» التي توفيّت إثر حادث، لكنّه ظلّ ينتظر مدّة ثلاثين سنة، ولم ترد المكالمة، فباع كل شيء لردّ الاعتبار لزوجته، وانتهى به المطاف حبيس المحطة طوال مدّة الانتظار، ليتحوّل إلى شخص منعزل بلا مأوى ولا عنوان.
بينما هو على هذه الحال، ينزل أحد المسافرين بنفس المحطة، وكان ينتظر أيضا مكالمة من الهاتف العمومي في المكان، وقد تميز عن الآخرين بحقيبة تبدو مهمة بالنسبة إليه لا يُهملها لحظة واحدة.
تنشبُ بين التهامي والغريب خلافات حول كابينة الهاتف، فكلاهما ينتظرُ مكالمة مهمة، ونكتشفُ تدريجيا عبر أحداث المسرحية أنّ هذا الغريب قد تحمّلَ نفس المعاناة، حيث قضى عقوبة امتدت ثلاثين سنة داخل قبو الأرشيف، فقرر الانتقام ممن عاقبه، وقد أعدّ ملفّا يورط الجميع يحتفظ به في الحقيبة العجيبة، ونكتشفُ أيضا حسب المخرج عيسى شريط، أنّ الملف يتعلق بقضية «زوينة» زوجة التهامي.وبعد مدٍّ وجزرٍ بينهما، يتّفقان في النهاية على التعاون لحلّ قضية «زوينة» بعيدا عن نزعة الانتقام،و خلال الأحداث تتطرّق المسرحية إلى جملة من الظواهر الاجتماعية والبيئية.
يقترحُ نص «التيليفون الملعون» كما كشف عنه المخرج، جملة من المواقف، والحالات، والأحداث التي تبدو في ظاهرها أنها نتيجة لوجود مشكلات حقيقيّة وعميقة، لكنّها في الحقيقة تحدث بفعل مشكلات مزيّفة لا مبرر لوجودها في الأساس، وهو العامل الذي يفجّر صراعات بين الناس ويفسد طبيعة العيش. وقصة «التهامي» المأساوية كما يوضح شريط، جاءت نتيجة لحادث فرضته بروتوكولات لا معنى ولا ضرورة لوجودها، وكذلك مأساة «الغريب» التي حدثت نتيجة معاقبته على موقفه المعارض لمشكلة كان يراها مزيفة، أما القضايا الفرعية التي يقترحها النص كنظافة المحيط، ونفاق التواصل، واعتماد نهج ميكيافيلي لتحقيق المنافع وغيرها، فمواضيع من وحي المجتمع تعكر صفو وجودة الحياة.
وهذا الصراع المزيّف كما قال المخرج : «دفع إلى اعتماد رؤية إخراجية تستّند على العبثية ومنها السخرية، فالمشكلة المزيّفة لا يمكن معالجتها بشكل جادٍ، بل تستدعي المقاربة الساخرة، واعتمدنا فضلا عن ذلك مقاربة تبدو صادمة للوهلة الأولى بالنسبة للمتفرج، وهي الانتقال السريع من الدرامي إلى الكوميدي في نفس الموقف، وفي نفس الجملة أحيانا ذلك ما جعلنا نصنّف المسرحية ضمن نوع «كوميدية تراجيدية» تتكلم عن الفرد، وعن المجتمع في آن واحد»وأكد المتحدث، أن الجمهور سيعيش من خلال المسرحة و أحداثها ساعة من الزمن ثريّة بالفكاهة، والابتسامة والدراما أيضا.
ع.بوعبدالله

يبدو من العسير تصنيف المفكر الجزائري الزواوي بغورة فلسفيا، وهو الذي اغترف من مشارب فكرية وإيديولوجية كثيرة، ولم يعد أسير فكر ميشيل فوكو رغم أنه كان منطلقه وكاد يكون الناطق باسمه في الثقافة العربية المعاصرة، حيث ظل منذ نهاية التسعينيات حريصا على أن يعدد مشارب المعرفة الفكرية والفلسفية ومناهج البحث ويخضع فكره لقراءات نقدية تخلصه من بعض القيود الإيديولوجية التي قد تكون تلبست به في فترة من فترات العمر العلمي، وهذا ما انعكس إيجابيا على إنتاجه الفلسفي والعلمي الذي تعدد بتعد الحقول العلمية التي ارتادها والمدارس الفكرية التي طرق أبوابها.
عبد الرحمن خلفة
فصدرت له عشرات الكتب والمقالات والمحاضرات والحوارات بشكل غزير طاف بها أو طافت به في فضاءات الثقافة والاجتماع والنفس والسياسة والحكم واللغة والدين، بعقلية منفتحة على المجال الغربي ومتفتحة على المجال الشرقي العربي الإسلامي قديمه وحديثه، ولم يكن ثمة رابط بين هذه الفضاءات سوى جسر الفلسفة الذي جعله حلقة وصل ومخبر تفكيك وتحليل ونقد لشتى مقولات تلك المعارف والعلوم والفضاءات، فقد انتقل بدراساته من فوكو إلى فلسفة اللغة وعلاقة هذه بالسلطة، ومن الفلسفة السياسية في الحقل الثقافي الغربي والحقل الثقافي الإسلامي، مترجما ومؤلفا، قارئا وناقدا، قبل أن يحط الرحال في الفلسفة الاجتماعية، سواء من خلاله مؤلفه سنة 2012'اعتراف: من أجل مفهوم جديد للعدل دراسة في الفلسفة الاجتماعية'، أو كتابه الأخير 'السياسة الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعية' (2022) منتقلا من الكلاسيكية إلى الحداثة وما بعد الحداثة والتنوير، بحثا عن الهوية، ورسوه في هذا المرفأ الفلسفي لم يكن اعتباطا أو ترفا بل لأنه اقتنع بأن مستقبل الفلسفة ليس في جانبها النظري الميثافيزيقي بل في فلسفتها التطبيقية، والفلسفة الاجتماعية تنتمي إلى هذا الجانب من الفلسفة.
المفكر الفيلسوف بغورة وفي لقاء له مع نخبة من المثقفين والأساتذة الجامعيين من ولايات جزائرية بداية هذا الأسبوع بمدينة سكيكدة بمناسبة العدد 14 للقاء المعرفة الذي يشرف عليه الأستاذ الدكتور مصطفى كيحل، اعترف أن موضوع الفلسفة السياسية الاجتماعية، الذي انتهى به المطاف للتأليف فيها، لا يدرّس إلا في الجامعات الألمانية كاشفا في السياق ذاته عن وجود موقفين منها: الموقف الأول في السياق الفلسفي الفرنسي الذي يرى أن الفلسفة الاجتماعية تنتمي إلى فترة زمنية ماضية لم يكن علم الاجتماع فيها مستقلا عن الفلسفة، وكما تظهر في بعض كتابات فلاسفتها دليل على الصورة التقليدية للفلسفة السياسية وأن ما تقوم به لا يتعدى الدور الإيديولوجي المسوغ للنظام القائم، بينما يعترف أصحاب الموقف الثاني بهذه الفلسفة الاجتماعية ويعطونها مبرر وجود علمي وواقعي، ويرى بغورة أن ما يخلص إليه فرانك فيشباخ في كتابه 'بيان من أجل الفلسفة الاجتماعية' الذي أكد فيه على جملة من الخصائص التي تميز الفلسفة الاجتماعية مقارنة بالفلسفة السياسية ومنها على وجه التحديد:الاعتراف باستقلالية المجتمع والحياة الاجتماعية وفي الوقت نفسه الاعتراف بالإكراهات والقواعد الاجتماعية، والفلسفة الاجتماعية فلسفة تطبيقية أو عملية لأنها معنية بالتحولات الاجتماعية، ويكمن دور هذا المجال الفلسفي في تشخيص ونقد كل ما هو مرضي وما هو معوج وما هو موجه مستعينا بذلك بالتراث الكانطي وبخاصة ما بينه كانط في نص ما التنوير، وترتبط الفلسفة الاجتماعية بأفق التقدم والانعتاق وتعتبر نفسها منحازة لجهة المظلومين، ويستنتج بغورة أن هذه الخصائص تبيّن من جهة صلة الفلسفة الاجتماعية بالماركسية وبمدرسة فرانكفورت ومن جهة أخرى التأكيد على البعد الأخلاقي.
ويقول الفيلسوف بغورة أن مؤسس نظرية الاعتراف الفيلسوف الألماني أكسل هونت يرى في كتابه 'الصراع من أجل الاعتراف' أن الفلسفة الاجتماعية الحديثة قد ظهرت في اللحظة التي بدأنا ندرك فيها أن الحياة في المجتمع تقوم على أساس الصراع من أجل الوجود، كما أكد ميكافيلي أن الأفراد يتعارضون ويتنافسون فيما بينهم وذلك دفاعا عن مصالحهم، كما جعل طوماس هوبز الصراع على المصالح أساس نظريته في العقد الاجتماعي.
ويعبر هذا الفهم عن التحول الذي أصاب العلاقات الاجتماعية مقارنة بالعصور القديمة كما يشكل منطلقا لتمييز الفلسفة الاجتماعية عن الفلسفة السياسية الكلاسيكية، وذلك بحكم أن الفلسفة الاجتماعية تقوم على مبدأين هما: أن الإنسان كائن اجتماعي لا يمكن أن يحقق طبيعته إلا ضمن جماعة سياسية وأخلاقية، وثانيا أن الفلسفة السياسية الكلاسيكية كانت تبحث فيما يجب أن يكون، وفي إمكانية قيام حياة خيرية وعادلة، ولكن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي أصابت بعض المجتمعات الأوروبية منذ عصر النهضة قد أدت إلى تغير في عناصر التصور الكلاسيكي للتصور السياسي، وأثارت انتباه مؤسس الفلسفة السياسية الحديثة نيقولا ميكيافيلي الذي كان معاصرا لهذه التحولات وعبر عنها في كتاباته السياسية وبخاصة ما أشار إليه من أن الإنسان أناني بالطبع ومن أن الاجتماع السياسي يقوم على مبدأ الصراع الدائم.
على نهج كبار الفلاسفة: نداء من أجل الاعتراف
على غرار الكثير من الفلاسفة تبنى بغورة نظرية الاعتراف لاسيما في مفهومه المسوّق من قبل الفيلسوف الألماني أكسل هونت الذي قدم قراءات نقدية لمفهوم الاعتراف في السياق الفرنسي وفي السياق الإنجليزي قبل أن يعرض فلسفته ونظريته فيه، وقد أخذ بغورة مثال قيمة 'العدل' ليشرح وجهة نظره ومبرر تبنيه لمفهوم معين في نظرية الاعتراف، فيقول كمثال على ذلك الفلسفة الاجتماعية لا تنتصر للمفهوم النفعي للعدل فقط، وإنما تشدد في الوقت ذاته على المنحى الأخلاقي والرمزي للعدل المتمثل في الاعتراف، وبتعبير آخر فإن الفلسفة الاجتماعية لم تعد تنادي بالعدل الاجتماعي في صورته التوزيعية للخيرات، وإنما أصبحت تنادي بضرورة استكمال العدل التوزيعي بالاعتراف بالعدل الأخلاقي والرمزي، حيث توصلت الفلسفة الاجتماعية إلى تحقيق مسائل أخلاقية وثقافية كالاستقلال والكرامة والاحترام والتقدير، دون الاقتصار على حفظ أو تنمية المصلحة الاقتصادية، والاعتراف الرمزي هنا يقترب أو يتماهى إلى حد بعيد في مفهومه مع مفهوم المصطلح القانوني 'رد الاعتبار'
فالفلسفة الاجتماعية كما يرى تتميز بمقاربتها الأخلاقية للمسألة الاجتماعية وعلى رأس هذه المقاربات موضوع العدل في علاقته بأشكال الظلم، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو الجماعات أو المؤسسات، وإن ما يشكل مدار اهتمام هذه الفلسفة هو الصراعات الاجتماعية وبخاصة صراع الفئات المهمشة والمقصية والمستبعدة ومختلف الجماعات التي تعتبر قاصرة وتباعة وتبحث عن حياة اجتماعية كريمة.
فالاعتراف الذي تبناه بغورة وغيره من الفلاسفة المحدثين والمعاصرين لم يعد ذاك الاعتراف الأوغسطيني -وإن ظهرت له بعض آثار عند بعض كتاب الاعترافات المحدثين-الذي يجعله واجب الأنا أمام الأنا الأعلى، بل اعتراف الأنا الأعلى في حق الأنا، وليس بالضرورة أن يكون الأنا فردا بل قد يكون فردا أو جماعة أو أقلية، والأنا الأعلى قد تكون سلطة أو مجتمعا.
وقد ناقش بغورة في كتابه "السياسة الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعية الصادر عن دار سؤال"، 2022 مواضيع ذات صلة مهمة بها وهي: الجسد والمرض والعنصرية، في مقارباتها الفكرية وعلاقتها بالسلطة والمجتمع والمؤسسات والأفراد. وقد سبق هذا الكتاب كما أشرنا سابقا كتابه "الاعتراف، دراسة في الفلسفة الاجتماعية" (2012). الذي نقلنا عنه الكثير من مقولاته السابقة؛ حيث قارب فيه الفلسفة الاجتماعية من خلال قيمة العدل، وفي كتاب السياسة الحيوية سيعرض بغورة مدلول "السياسة الحيوية" من منظور ميشيل فوكو، ويرى بعض الباحثين هنا أن هذا الموضوع يطرح نفسه بقوّة في الفكر السياسي والاجتماعي المُعاصر، ويجري توظيفه في مجالات متعدّدة "منها: الصحّة، الأمراض، السكّان، الإنتاج الزراعي والاقتصادي، البحث الطبي، ومختلف وسائل تحسين شروط الحياة، ومنها التكنولوجيا الحيوية... إلخ"، ثم يعرج على مدلول السياسة الحيوية ومعانيها في المدارس الفلسفية الغربية.
ولئن رأى أن هذه الموضوعات ذات صلة عضوية مع الفلسفة السياسية فإن المؤكد أنها ستجد لها امتدادات في فلسفات أخرى لاسيما في علاقتها بالسلطة والقانون؛ على غرار الفلسفة السياسية وفلسفة حقوق الإنسان، بل قد تستقل مع الوقت هذه الفلسفة الأخيرة بمثل هكذا موضوعات إن نحت منحى الفلسفة التطبيقية في ظل تطور أجيال حقوق الإنسان وانتقالها التدريجي من الحقوق الإلهية إلى الحقوق الطبيعية فالحقوق المدنية التي لم تعد تتسع بنطاقها القديم للحقوق الجديدة في عالم البيئة والتكنولوجية والرقمنة.
كان يفترض أن يشرح بغورة المجتمع الجزائري ويكشف عن بعض أمراضه الاجتماعية لاسيما وأنه درس موضوع المرض الاجتماعي من منظور فلسفي؛ لكنه أبى لأن ذلك في رأيه يحتاج لدراسات علمية ميدانية استبيانية يفتقر إليها حاليا، بيد أنه تساءل مثلا هل يشعر الجزائري بالسعادة في مدينته؟ ليؤكد أن المدينة ليست مجرد عمران بل هي أيضا محيط اجتماعي وبيئي يسهم في تحقيق طمأنينة الساكن فيها وسعادته، متسائلا أيضا عن علاقة المواطن بالإدارة، قبل أن يعترف أن مالك بن نبي يعد أول جزائري يتحدث عن المرض الاجتماعي سنة 1962 في كتابه 'ميلاد مجتمع، شبكة العلاقات الاجتماعية' ورأى أن أكبر مشكلة هي الأنا، ونفى بغورة أن يكون التدين مرضا اجتماعيا بل قال بالعكس إن الدين مطلوب؛ لكن ما يرفض هو التطرف، بشتى أبعاده؛ سواء كان تطرفا دينيا أو سلطويا أو غيرهما.
بغورة اعترف أن الفلسفة لم تفده في شيء بل اكتشف في مراحل معينة أن الكثير مما قرأه لم يكن له جدوى واقعية، وقال إنه قام لاسيما بعد استقراره منذ أزيد من عشرين سنة بالمشرق بمراجعات عميقة ونقد ذاتي رصين أفضى به للتخلص من الكثير من القناعات والأفكار لاسيما ما تعلق منه بالجانب الإيديولوجي، وأضحى أكثر انفتاحا على مختلف الثقافات والمناهج، ولهذا دعا إلى قراءات نقدية في الإنتاج الفكري والمعرفي لبعض الرموز، متسائلا لماذا ما زلنا رهائن ترجمات عبد الصبور شاهين لمؤلفات مالك بن نبي، ومتى يتم نشر مؤلفاته باللغة الفرنسية التي كتبها بها.
وعلى الرغم من الانفتاح الكبير الذي اشتغل عليه بغورة إلا أن شبح ميشيل فوكو ما يزال مخيما على فكره، لأن فكر فوكو كما يرى بيير بورديو (استكشاف طويل للانتهاك، وتجاوز الحدود الاجتماعية المرتبط دومًا بالمعرفة والقوة)، ويبدو أن بغورة ماض في الاستكشاف الطويل.

الفيلسوف الجزائري الزواوي بغورة في سطور
الزواوي بغورة مفكر وباحث ومترجم جزائري، ولد في برج بوعريريج يعمل أستاذاً للفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة في جامعة الكويت وقد تخصص في فلسفة ميشيل فوكو، ويعد أحد أعمدة الفلسفة في العالم العربي، درس الفلسفة عبر مراحل الليسانس والماجيستير والدكتوراة بجامعة قسنطينة حيث تحصل على الدكتوراة سنة 1996م حول مفهوم الخطاب في فلسفة فوكو، وهي أول دكتوراة تناقش في قسم الفلسفة بجامعة قسنطينة، وقد اشتغل أستاذا بذات الجامعة قبل انتقاله إلى الكويت.
صدرت له أزيد من 100 مقالة علمية محكمة في مجلات ودوريات عالمية ترجمة وتأليفا وقراءة، وله العديد من الكتب المنشورة منها:
- مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو (2000)
- الخطاب الفكري في الجزائر بين النقد والتأسيس (2003)
- الفلسفة واللغة: نقد "المنعطف اللغوي" في الفلسفة المعاصرة (2005)
- ما بعد الحداثة والتنوير: موقف الأنطولوجيا التاريخية (2009)
- اعتراف: من أجل مفهوم جديد للعدل دراسة في الفلسفة الاجتماعية (2012)
- مدخل إلى فلسفة ميشيل فوكو (2013)
- ما التنوير؟ موقف ميشيل فوكو (2014)
- ميشيل فوكو في الفكر العربي المعاصر (2014)
- الهوية والتاريخ: دراسات فلسفية في الثقافة الجزائرية والعربية (2015)
- اللغة والسلطة: أبحاث نقدية في تدبير الاختلاف وتحقيق الإنصاف (2017)
- الشمولية والحرية: دراسات في الفلسفة السياسية والاجتماعية المعاصرة (2018)
- الإسلام والحكم: دراسات في المسألة السياسية في الفكر الإسلامي المعاصر (2019)
- الخطاب: بحث في بنيته وعلاقاته ومنزلته في فلسفة ميشيل فوكو (2021)
- السياسة الحيوية من منظور الفلسفة الاجتماعية (2022)
وفي الترجمة:
- يجب الدفاع عن المجتمع، ميشيل فوكو (2003)
- تأويل الذات، ميشيل فوكو (2011)
- معجم ميشيل فوكو (جوديت روفال) (2018)
- مدخل إلى الفلسفة المعاصرة (مارك لوني) (2020)
- شجاعة الحقيقة: حكم الذات وحكم الآخرين (2022)

اتخذ طلبة فلسطينيون متواجدون في الجزائر، وجها آخر لمقاومة الاحتلال الصهيوني، من خلال الترويج لثقافة بلدهم وحماية موروثهم عبر إطلاق مشروع يحمل اسم «جفرا»، يرمي للحفاظ على تراثهم الذي يحاول المحتل سلبه بالتلاعب بأوراق التاريخ وإعادة صياغته، لترسيخ حق كاذب عن ملكيته لأرض فلسطين، وإثبات سردية مدعومة بقوة السلاح، وذعر المجازر والإبادات الجماعية التي تُنفذ ضد شعب أعزل.
إيناس كبير
ويحمل شباب من فلسطين هم بلدهم في قلوبهم، فيعبرون بطريقتهم عن الويلات التي يعاني منها شعبهم، كما يدركون ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم، وبالأخص في جانب دحض مزاعم الكيان الصهيوني وما يحاول تزييفه حول التاريخ والهوية الفلسطينية، إثباتا لأوهامه.
وقد خرجت أنشطة عديدة من مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقها لاجئون فلسطينيون في مختلف البلدان العربية إلى أرض الواقع، وذلك لتقريب القضية من عقول ووجدان كل العالم، على غرار جمع التبرعات، وإقامة الفعاليات الثقافية للحديث عن الجذور التاريخية والثقافية للقضية الفلسطينية.
مشروع «جفرا» الذي ينشط في الجزائر ويقوم عليه طلبة فلسطينيون، يعتبر من بين أبرز نماذج المقاومة الثقافية، كما يؤكد الطلبة القائمون عليه و يفصل فيه ممثل المجموعة الطالب جهاد مرعي، الذي قابلته النصر، مؤخرا، على هامش معرض للحرف، احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور بقسنطينة، أين أشرف على جناح للمنتجات الفلسطينية، مثل اللباس النسوي التقليدي، والكوفية، وهدايا تراثية تحمل رموزا فلسطينية، مشيرا إلى أن هدفهم من المشروع هو تأكيد هوية هذه القطع والحفاظ عليها من محاولات سرقتها ونسبها إلى غير أهلها.
قطع بسيطة برمزية كبيرة
ووفقا لجهاد، فإن «جفرا» هو مشروع شبابي بدأ في أوساط طلبة فلسطينيين يدرسون في جامعات ولاية قسنطينة، يختص في التعريف بالتراث الثقافي لدولة فلسطين والترويج له، وأردف محدثنا، بأن الأوضاع التي تعاني منها فلسطين وبالتحديد قطاع غزة من قتل وتهجير، وتعد على الهوية الوطنية لهذا الشعب، جعلتهم يتوصلون إلى أنه أصبح من الضروري التدخل للتصدي لمحاولات تزييف التاريخ ومحو الأثر الثقافي للفرد الفلسطيني من طرف العصابات الصهيونية التي تستهدف إبادة الإنسان و الحضارة معا.
ويعتمد القائمون على المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للتراث الفلسطيني، يضيف الطالب، وكذا المشاركة في مختلف الفعاليات، سواء في ولاية قسنطينة أو ولايات أخرى من الجزائر، كما يسلطون الضوء أيضا على المجازر المرتكبة في قطاع غزة، وتأثيرها على الشعب الفلسطيني.
ويحمل اسم المشروع في حد ذاته رمزية تاريخية وفنية، وقد أوضح محدثنا، أن «جفرا» جزء من الذاكرة الفلسطينية، يرمز إلى الفلكلور الذي يُقام احتفالا بالأعراس، أي أنه نوع من أنواع الرقص الشعبي على أنغام الجفرة التي شبهها جهاد بفن الراي في الجزائر.
كما يحمل المعنى ثورة على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، حيث أخبرنا أن الاسم، يحفظ أيضا ذكرى اغتيال شهيدة فلسطينية اسمها «جفرا» خلال اجتياح بيروت سنة 1982، في غارة إسرائيلية، وقد نعاها الشاعر الفلسطيني عز الدين المناصرة، في قصيدته الشهيرة «جفرا الوطن المسبي»، التي عبرت عن معاني مختلفة من تناقضات الحالة الفلسطينية بين التراث والشهادة، وذكر محدثنا أبرز أبياتها وهو»جفرا أمي إن غابت أمي، جفراء الوطن المسبي». ومع بداية الحرب الغاشمة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة منذ 400 يوم، لفت جهاد، إلى أنهم كطلبة كثفوا نشاطاتهم من خلال المشاركة في فعاليات ثقافية أُقيمت في ولايات جزائرية عديدة، وقد تفاعل معها الجزائريون وأبدوا اهتماما كبيرا بها.
حرب على التاريخ والهوية الفلسطينية
وذكر جهاد مرعي الناشط ضمن فريق مشروع «جفرا»، أن التراث الفلسطيني يُعرف بالأزياء والمأكولات التقليدية، والغناء، وفن الجزل الفلسطيني.
أما عن أهم القطع التراثية التي يتميز بها، فأشار إلى الثوب الفلسطيني النسوي، الذي يملك خصوصية، وشرح محدثنا، أن كل مدينة تتميز بطرز وألوان معينة، فمثلا نجد الألوان الفاتحة، كالأزرق والأخضر في مدن الساحل، أما الثوب الذي ترتديه نساء الأرياف فيكون بسيطا تعبيرا عن وقوف المرأة الفلسطينية إلى جانب عائلتها ومساعدة الرجال في زراعة الأرض.
ووفقا للمتحدث ذاته، فإنهن لم يكن لديهن الوقت الكافي للاهتمام بطرز أثوابهن، عكس نساء الحضر، اللائي اهتممن بالدقة في التطريز و كثافة التفاصيل.
وكشف الطالب، أن المحتل الصهيوني لا يتوقف عن محاولات الاستيلاء على الثوب الفلسطيني وتسجيله كتراث خاص به، حيث تعرضت هذه القطعة لعدة حملات ممنهجة، حسبه، آخرها ما قامت به شركة طيران صهيونية منذ ثلاث سنوات، عندما جعلت مضيفاتها يرتدينها، زاعمة أنها جزء من ثقافتهن.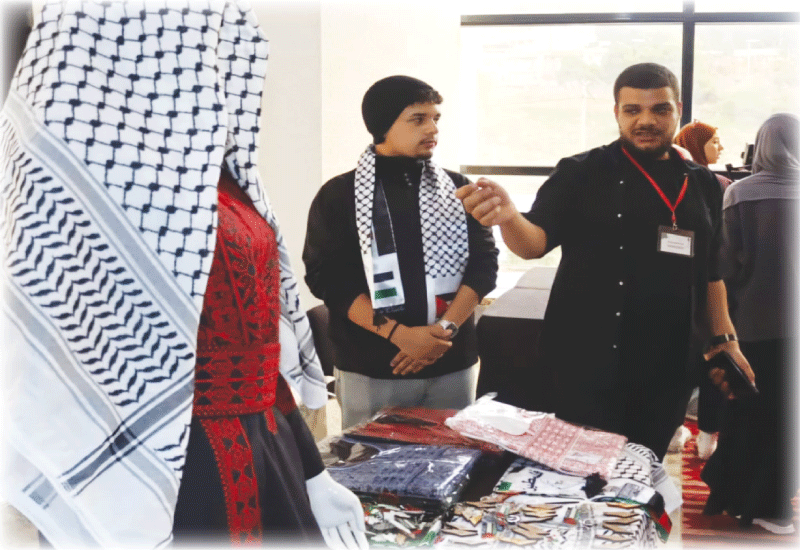
وطوال عقدين من الزمن، أصيب الاحتلال الصهيوني بحمى نسب كل ما هو فلسطيني إليه، باحثا عن منافذ لتحقيق دعم لرواية مجهولة النسب، بأنه «جاء إلى أرض بلا شعب، ليعطيها إلى شعب بلا أرض»، وعقب جهاد، في ذلك إنكار لكل ما يحمل روحا فلسطينية على غرار الأطباق التقليدية وغيرها.
وأضاف الطالب، أن هذه الحملات المتكالبة على فلسطين شعبا وتاريخا وثقافة، تدفع للاستنتاج أن حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني هي جزء من حرب الهوية، وأتبع قائلا «هي ليست حرب حدود ولا أرض فقط، إنما هي حرب وجود».
لذلك يرى، أن المقاومة من خلال التاريخ في هذه الظروف، أصبحت ضرورية بكل أشكالها، حفاظا على الهوية والذاكرة الشعبية، مثلما هو الحال مع المقاومة المسلحة، والمقاومة السياسية، والشعبية، كما دعا عضو مشروع «جفرا» الشباب الفلسطيني وكل الشباب العربي المهتم بالقضية الفلسطينية، إلى المساهمة في النشر عن كل ما هو فلسطيني، والمشاركة في التصدي للمزاعم الصهيونية.
عز الدين المناصرة.. شاعر جفرا
وبين جفرا التراث وجفرا الحقيقية قصص عن الاغتراب ولوعة الحنين إلى الوطن، تحولت إلى رمز فلسطيني وعربي وعالمي عندما نشر الشاعر عزالدين المناصرة، قصيدته «جفرا الوطن المسبي» عام 1976 في الصحف اللبنانية، وقد جاء في أبياتها «جفرا أُمّي إنْ غابتْ أُمّي.. ﻓﻲ شاطئ عكّا.. البيضاءِ الدورْ.. وأنا لعيونكِ يا جفرا، سأغنّي.. لفلسطينَ الخضراء… أُغنّي. «
تُرجمت قصيدة الشاعر إلى أكثر من عشرين لغة أجنبية، كما غناها من لبنان مارسيل خليفة، وخالد الهبر، وتحولت إلى فيلم يوغوسلافي تضمن الأغنية بصوت مارسيل خليفة، عُرض في مهرجان موسكو السينمائي الدولي عام 1980.
وتحولت أيضا إلى رقصة على ألحان خليفة في مدينة «برنو» السلوفاكية، وأنشدها أحد نجوم المسرح الفرنسي بالفرنسية في مسرح موليير في باريس عام 1997، بعد أن ألقاها المناصرة بالعربية، بحضور فدوى طوقان، ومحمود درويش، وبحضور الفيلسوف الفرنسي «جاك دريدا» الذي وصفها بقوله «كأنها السحر بعينه، « وخُلدت «جفرا» في أسماء فرق شعبية، ومراكز مؤسسات ثقافية وإعلامية، بل وظهرت روايات وقصص وقصائد ومدوّنات تحت اسم هذا الاسم الرمزي. إ.ك

تحتل الآثار الفينيقية حيزا بارزا في متحف سيرتا بمدينة قسنطينة، لتروي لزائريها بصمتها العميقة التي تعجز كتب التاريخ عن توثيقها بالكامل، هي آثار خطتها أيادي الفينيقيين الذين مروا على الجزائر، تاركين إرثا ثقافيا وحضاريا أبى أن يندثر رغم تعاقب الحضارات ومحاولات الاستعمار الفرنسي طمس الهوية بمزيج طبقاتها المتداخلة والمنسجمة، فالشواهد الموجودة بالمتحف العريق ليست مجرد مقتنيات صامتة، بل حية تحكي عن الفينيقيين، وعاداتهم، ومعتقداتهم.
لينة دلول
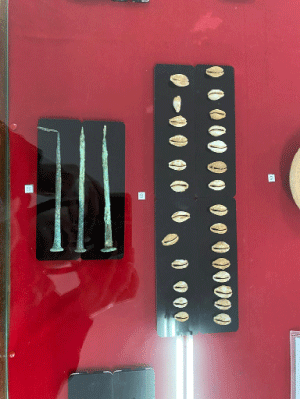
سرد مشوق لحكايات الماضي
على أعتاب قاعة النوميدوبونية في متحف سيرتا، يبدأ الزائر رحلة زمنية حيث تتعانق آثار الحضارات النوميدية، والفينيقية، والبونية في سرد مشوق لحكايات الماضي، حيث تخفي الواجهات الزجاجية لهذه القاعة بتصميمها الهادئ وأجوائها المهيبة، قطعا أثرية تتحدث عن تاريخ ممتد. تستقبلنا أولا عند ولوج المكان، الأواني الفخارية السوداء التي أبدع الفينيقيون في صناعتها باستخدام مادة "كومبانيا" الشهيرة، و نحتوها بدقة لا يزال العلماء ينبهرون بها، إلى جانبها تقف الخوابي ذات القاع المدبب، والتي كانت تستخدم لنقل السوائل في رحلات التجارة البحرية، حيث تسهل ثباتها على الرمل أو داخل السفن، في شهادة على عبقرية الفينيقيين في مواجهة تحديات السفر.

أما الحلي والقواقع، فتروي قصص الجمال في تلك الحقبة، حيث تعكس قواقع "الودعة" التي تزينت بها النساء، واللآلئ الزجاجية التي صنعت منها الجواهر والسلاسل، عناية الفينيقيين بالتفاصيل الدقيقة، بينما تثير المصابيح الزيتية الفضول ببساطة تصميمها ودورها في إنارة عالمهم القديم.
كل قطعة أثرية هنا تحمل توقيع الحضارة التي اعتقدت بالحياة الأخرى، فدفنت مع موتاها الأواني وبقايا الطعام، كالسمك والتراب، في طقوس تعبر عن إيمانهم بعودة الحياة بعد الموت.
وحسب ما لحظناه خلال زيارتنا إلى القاعة، فإنه يتم عرض هذه اللقى في المتحف بأسلوب يضمن قيمتها التاريخية، تحت إشراف فريق تقني متخصص يضمن حمايتها من عوامل التدهور، بحفظها داخل واجهات زجاجية معدة بعناية فائقة.
زاد ومتاع للحياة الأخرى..
صرحت كنزة مسواكي، رئيسة مصلحة الحفظ والجرد بمتحف سيرتا، أن أغلب الآثار الفينيقية الموجودة في المتحف تعود إلى "القرن الثاني والثالث قبل الميلاد".مؤكدة أن هذه القطع تمثل جزءا من الأثاث الجنائزي الذي تم العثور عليه في منطقة "الرابطة" بجيجل وتشمل هذه القطع بحسبها، أوان متنوعة الأشكال، وبقايا أطعمة كالسمك والتراب، حيث كان الفينيقيون في تلك الفترة يعتقدون بالحياة الأخرى..
ووفقا لمعتقداتهم، فإن الشخص الذي يموت يمكن أن يعود إلى الحياة مجددا ويستفيد من هذه الأواني والمعدات المدفونة معه.
وقالت المتحدثة، بأنه تم العثور في الأثاث الجنائزي الذي يعود إلى الفترة الفينيقية، على قواقع تعرف باسم "الودعة"، والتي كانت تستخدم كحلي وزينة، كما عثر على لآلئ تستخدم في صناعة الجواهر والسلاسل، وكانت مصنوعة من مادة الزجاج.
من بين المكتشفات أيضا، تضيف المتحدثة، مسامير وأحجار صغيرة مصنوعة من الرصاص، كانت تُستخدم في ترميم الأواني الفخارية، كما تشمل المكتشفات مصابيح زيتية مصنوعة من الفخار، ذات تصميم بسيط. هذه المصابيح حسبما أوضحت، تحتوي على فوهتين الأولى في الوسط تستخدم لسكب الزيت، والثانية أمامية لوضع فتيل الشمعة لإضاءة المكان
وأضافت سواكي، أن الفينيقيين كانوا بارعين في صناعة الفخار، حيث استخدموا مادة تُسمى "كومبانيا"، تعرف بجودتها العالية ولونها الأسود المميز، فتظهر أوانيهم دقة وإتقانا كبيرين في صناعتها.
أما الخوابي، فأوضحت المسؤولة بأنها كانت تستخدم لنقل السوائل كصلصة الزيت في الرحلات البحرية، وعثر عليها هي الأخرى في جيجل، وقد تميزت بقاعدتها المدببة، مما يسهل تثبيتها على الرمل أو في السفن أثناء النقل.
أهمية جيجل كمركز تجاري

أوضحت مسواكي، أن أغلب اللقى الفينيقية تم اكتشافها في جيجل، كونها كانت مركزا هاما للمبادلات التجارية التي اعتمد عليها الفينيقيون، هذا المركز الاستراتيجي، جعلها محطة رئيسية لربط مختلف المناطق وتبادل السلع.
وأكدت المتحدثة، أنه يتم عرض الآثار الفينيقية في قاعة النوميدوبونية، وذلك لأن الحضارات النوميدية، الفينيقية، والبونية تعايشت مع بعضها البعض وحدث بينها نوع من التزاوج الحضاري.
وكشفت مسواكي، أنه تم اكتشاف هذه اللقى الأثرية خلال الحفريات التي جرت في فترة الاستعمار الفرنسي، ما يبرز أهمية الجهود الأثرية التي كرست للكشف عن تاريخ الحضارة الفينيقية.
كما أكدت، أن فريقا تقنيا متخصصا يعمل على حماية هذه القطع الأثرية من التدهور أو التلف، ويتم ذلك من خلال وضع القطع داخل واجهات زجاجية مصممة وفق معايير خاصة تحافظ على المعروضات لفترات طويلة، ما يضمن بقاءها سليمة للأجيال القادمة.
موضحة، أن المتحف يشهد إقبالا كبيرا من المهتمين بالحضارة الفينيقية، من بينهم دارسو علم الآثار، والباحثون، والسفراء وغيرهم. كما تتوفر قاعات مخصصة لعرض آثار الحضارات الأخرى، ما يجعل المتحف مقصدا ثقافيا وعلميا هاما.
المراكز الفينيقية في الجزائر
وكشفت مسواكي، عن تاريخ الفينيقيين كأمة سامية تعود أصولها إلى كنعان بن عليق بن لاون، بن سام، بن نوح عليه السلام، مؤكدة أن الفينيقيين عاشوا كغيرهم من الكنعانيين، في الجزيرة العربية قبل أن ينتقلوا إلى مناطق الشام ليستقروا في ما يعرف اليوم بـ"فينيقيا" التي تضم لبنان حاليا وأجزاء من سوريا وفلسطين.
وأشارت، إلى أن القرطاجيين، وهم امتداد للفينيقيين، لعبوا دورا محوريا في احتكار التجارة الداخلية والخارجية عبر سواحل البحر الأبيض المتوسط، وأسسوا موانئ ومحطات تجارية، كان أبرزها مدينة قرطاجنة التي أنشئت عام 814 قبل الميلاد على الساحل التونسي.
ومع مرور الوقت، امتدت تجارتهم إلى السواحل الجزائرية، حيث أسسوا مراكز تجارية حيوية شملت بجاية، وتنس، وشرشال، وعنابة (هيبون)، وجيجل، ووهران.وأكدت، أن الفينيقيين تواجدوا في الجزائر قديما، لكن لا يمكن تحديد الفترة الزمنية الدقيقة لاستيطانهم ولا الطرق التي سلكوها للوصول إليها.
ومع ذلك، فإن تواجدهم التجاري والثقافي في الجزائر موثق، ويتجلى في المراكز الفينيقية التي شملت تيبازة ،"إيول" شرشال حاليا، "كارتينا" ، قورايا، كارتينا تنس حاليا، وصلاي وهي بجاية،إضافة إلى روس غونية أو برج البحري، وروسبيكاري وهي مرسى الحجاج، إيجيجلي وهي جيجل، وشولو وهي القل، فضلا عن روسيكادا وهي سكيكدة، وهيبو ريجيوس وهي عنابة حاليا. واعتبرت مسواكي، أن الفينيقيين تركوا بصمتهم على الساحل الجزائري سواء في التجارة أو الثقافة، وقد أسهمت هذه المدن في بناء شبكة تجارية متينة، حيث كانت المحطات التجارية الفينيقية بمثابة جسر يربط البحر الأبيض المتوسط بشمال إفريقيا. مشيرة، إلى أن هذه الحقائق التاريخية التي يبرزها متحف سيرتا ليست مجرد روايات، بل هي انعكاس لإرث حضارة عريقة استوطنت السواحل الجزائرية وصاغت معالمها عبر قرون من النشاط التجاري والتفاعل الثقافي.
مراد وليد رئيس مصلحة النشاطات بالمتحف
نصب معبد الحفرة.. أسرار الحضارة البونية والفينيقية
استوقفتنا خلال جولتنا في قاعة النوميدوبونية، مجموعة من الأنصاب النذرية التي تروي جانبا خفيا من تاريخ الحضارتين الفينيقية والبونية. حيث أوضح لنا وليد مدور، رئيس مصلحة النشاطات بالمتحف، أن هذه الأنصاب تعود إلى ما يعرف بـمعبد الحفرة، وهو معبد يعتقد أنه كان موجودا خلال الفترتين البونية والفينيقية اللتين تعاصرتا وتداخلتا في الزمان والمكان.وأشار مدور، إلى أن التنقيبات في معبد الحفرة التي تمت من طرف الباحثين "بيرتي و رونيه شارلي" وتمت بجنان الزيتون، كشفت عن وجود حوالي ألف نصب نذري، يعرض منها متحف سيرتا 800 نصب في حين أن 130 نصبا آخر معروضة بمتحف اللوفر بباريس. كانت هذه الأنصاب بحسب المتحدث، تستخدم في طقوس دينية مرتبطة بعبادة الآلهة القرطاجية، وعلى رأسها الإله بعل حامون والإلهة تانيت تاموت ، اللذين يمثلان رمزين رئيسيين في المعتقدات القرطاجية. 
وأكد المتحدث، أن الأنصاب النذرية تمثل توثيقا ماديا شاملا للحياة الاجتماعية والاقتصادية في سيرتا القديمة، فقد جسدت مختلف المهن والأعمال التي كانت تمارس في تلك الفترة، مما يوفر رؤى دقيقة عن طبيعة المجتمع في تلك الفترة، ويمنحنا فهما عميقا لتفاصيل الحياة اليومية لسكان المنطقة.
وقال المتحدث، بأن النقوش التي زينت بها الأنصاب النذرية تميزت بتنوع لغوي فريد، إذ كتبت بـأربع لغات هي البونية القديمة، التي كانت لغة الفينيقيين، والبونية الحديثة، التي تطورت مع التفاعل الثقافي بين الفينيقيين والشعوب المحلية، واللاتينية التي تعكس تأثير الحضارة الرومانية اللاحقة على المنطقة، وأخيرا الإغريقية، التي تشير إلى التأثير الهلنستي نتيجة الاتصال بالحضارة اليونانية. ل.د