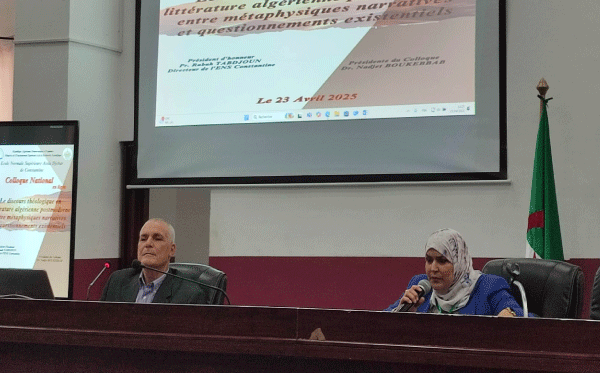
دعا أمس، باحثون في الأدب والبيداغوجيا بقسنطينة إلى إدراج نصوص أدبية جديدة في المناهج الدراسية، حيث اعتبرت مختصة أن إضافة نصوص جزائرية مترجمة من العربية في مقررات اللغات الأجنبية سيكون أمرا جيدا، في حين ناقش متدخلون الخطاب الديني في المتن الأدبي الجزائري ما بعد المعاصر.
ونظمت المدرسة العليا للأساتذة، آسيا جبار، بقسنطينة، ملتقى وطنيا بعنوان “الخطاب الديني في الأدب الجزائري ما بعد المعاصر بين الميتافيزيقا السردية والتساؤلات الوجودية”، حيث أوضحت رئيسة الملتقى، الدكتورة نجاة بوكباب، في تصريح للنصر، أن موضوع الفعالية انبثق من واقع الجزائر، إذ شرحت أن الخطاب الديني يؤدي دورا مهما في حياة الفرد لأنه يعتبر من بين مقومات الهوية الوطنية، على غرار اللغة وغيرها، فضلا عن أنها منصوص عليها في النصوص الرسمية، على رأسها الدستور، في حين نبهت بأن التفكير في موضوع الملتقى انطلق من هذه الملاحظات، واعتبرت أن الأدب ينقل الواقع إلى النصوص.
ولفتت محدثتنا إلى أن الفعالية تشمل مناقشة النصوص الأدبية التي تتطرق لموضوع الدين في المقررات الدراسية بحكم تخصص المدرسة العليا للأساتذة في تكوين المكونين، حيث قالت إن التلميذ يعتبر مواطن المستقبل، “ما يجعل من الحرص على تكوينه بشكل سليم اجتماعيا وأدبيا وأيديولوجيا، ضامنا لأن يكون إنسانا سويا في المستقبل ويحرص على الحفاظ على مقومات الهوية الوطنية”، مثلما قالت. ونبهت الدكتورة أن اختيار دعائم التكوين الديني والهوياتي في المدرسة ينبغي أن يكون دقيقا، إذ لا يمكن إدراج أي دعائم بيداغوجية من النصوص الأدبية في المقررات، بحسبها، بينما اعتبرت أن اختيار مقطع للكاتبة طاووس عمروش، التي ولدت في أسرة تعتنق المسيحية، حول المولد النبوي الشريف في مقرر السنة الرابعة ابتدائي طريقة لتثمين الطقوس الدينية، بما يمنح التلميذ فهما راسخا بأن بيئته الاجتماعية موسومة بطابع ثقافي ديني لا يمكن التخلي عنه، كما أضافت أن هذا العامل يساهم في تكوين هوياتي متوازن ويساهم في الحفاظ على الهوية الوطنية والأسس والمبادئ.
وردت الدكتورة حول سؤالنا عن طريقة تعامل النصوص الأدبية في المتن الجزائري مع مسألة الدين بالقول إن الدين في المتن الأدبي الجزائري ما بعد الحداثي ليس موضوعا بحد ذاته، في حين يمثل الجانب الديني فيه حلقة وصل للتعاطي مع المشاكل الاجتماعية. وضربت المتحدثة المثال بأدب الاستعجال الذي كتب في مرحلة العشرية السوداء مُصورا المعاناة الاجتماعية المصاحبة لها، حيث قدمت هذه النصوص المعطى الديني على أنه مُحوّر عن طبيعته لرسم حالة تحول أشخاص عاديين إلى الفكر المتطرف، بينما الدين في أصله بعيد عن هذه الأشياء، ما جعل الدين في هذه النصوص حلقة وصل للتحدث إلى القارئ حول المشاكل الاجتماعية لتلك المرحلة.
يجب ضمان جودة الترجمة في نقل نصوص جزائرية إلى مقررات اللغات الأجنبية
وشددت محدثتنا على ضرورة مراجعة الدعائم البيداغوجية من النصوص الأدبية المدرجة في المقررات المدرسية، حيث أوضحت أنه ينبغي إضافة نصوص تعمل على توعية المواطن بخطورة تحوير الخطاب الديني الذي لا يمكن تأويله أو تحليله من قبل أي كان. وسألنا الدكتورة عن رأيها في تأثير القراءات السطحية والمشحونة للنصوص الأدبية، خصوصا في ظل التأثير الجماهيري لشبكات التواصل الاجتماعي، على غرار ما سجل في تلقي رواية “هوارية” للكاتبة إنعام بيوض، حيث أوضحت أن النص الأدبي ينبغي أن يؤخذ كفنّ قبل كل شيء، فضلا عن أنه يعكس الحياة الاجتماعية التي تنطوي على جوانب سلبية وآفات، يُسلّط عليها الضوء لدراستها وتحليلها من منظورات مختلفة، مثلما قالت.
وأضافت المتحدثة أن الانتقادات المشحونة للرواية المذكورة بناء على ما يرد فيها على لسان بعض الشخوص نابعة من جهل بقيمة النص الأدبي، فالرواية عمل خيالي وليست مقالا صحفيا لنقل وقائع حقيقية أو تقريرا، كما قالت إن منح صوت كاذب للشخصية في الرواية يقدم صورة خاطئة عن المجتمع ويقود إلى تغليط القارئ وتزييف الواقع. وشددت المتحدثة أن النصوص الأدبية لأدب الاستعجال التي ساءلت استعمال الخطاب الديني لأغراض أيديولوجية وسياسية ينبغي أن تدرج في المناهج التعليمية حتى يتشكل لدى المتعلم وعيٌ بخطر التجنيد الأيديولوجي انطلاقا من الخطاب.
أما بخصوص إدراج نصوص أدبية جزائرية مترجمة من العربية في مناهج اللغات الأجنبية أو العكس، فقد اعتبرت بأن هذا الأمر يطرح بعض التحفظات المتعلقة بعملية الترجمة، مشيرة إلى أن إضافة دعائم مترجمة بجودة عالية لا يطرح مشكلة، في حين قد تطرح إشكاليات عندما لا تترجم النصوص بشكل جيد ما يؤدي إلى ضياع روح النص، سواء من ناحية قيمته الجمالية أو غايته الأيديولوجية. وقالت الدكتورة إنها ليست ضد الأمر بشكل مطلق، لكن ينبغي أن تنجز هذه العملية بشكل جيد، كما أضافت أن الأدب الجزائري المكتوب باللغة العربية ثري ومتنوع، و”سيكون إدراج نصوص مترجمة منه في المناهج المدرسية اللغة الفرنسية أمرا رائعا”، مثلما أضافت.
تدريس النصوص الأدبية لا يتعلق بتلقين التربية الدينية
من جهته، تطرق الأستاذ بلقاسم يخلف من المدرسة العليا للأساتذة والمختص في علم النفس وعلوم التربية، في المداخلة التي قدمها في الملتقى إلى كيفية تدريس النص الأدبي الذي يحمل في طياته أفكار دينية، حيث صرح لنا أن الأمر لا يتعلق بتدريس التربية الدينية، وإنما يدور حول كيفية تدريس هذه النصوص الأدبية مع مراعاة المرحلة العمرية والفكرية، خصوصا في الطور الثانوي. وأضاف المتحدث أن الغرض من هذه النصوص لا يتمثل في تدريس الدين، وإنما في تلقين الثقافة التي استعملها الكاتب في نصه، على غرار الدلالات الرمزية وطبيعة النص الذي اختاره الكاتب مثل النصوص السردية أو التحليلية، ما يطرح التساؤل حول الطريقة التي يجب على الأستاذ أن يتعامل بها مع هذه النصوص.
واعتبر المتحدث أن الأدب الجزائري يتسم بخصائص تميزه عن غيره فيما يتعلق بأسئلته وإشكالياته والموضوع الأساسي الذي يطرح في كل مرحلة، في حين ضرب محدثنا المثال خلال تدخله في فقرة النقاش للجلسة الصباحية برواية “الأمير الصغير” لسانت إكزوبيري التي كانت تدرس قديما في المقررات الخاصة بمختلف الأطوار، لكن بمنظور مختلف في كل طور واحد منها بحسب تطور القدرات الفكرية لدى التلميذ. أما الدكتور محمد ياسين بلّال من المدرسة العليا للأساتذة، مسعود زغار، بولاية سطيف، فقد أوضح أن الكاتب يمكن أن يتنبأ في النص الأدبي بأحداث قد تحدث فعليا في المجتمع الحقيقي انطلاقا من المجتمع الخيالي في النص، مشيرا إلى أن هذه “النظرة المركبة من عدة شظايا” ستكون لها آثار على القارئ، بحيث سيكون لها أثر مرجعي وواقعي وتحفيزي لمعرفة الواقع، فضلا عن أثرها النفسي والأيديولوجي، والتحفيزي أيضا، الذي يدعو القارئ إلى المشاركة في نقد المجتمع من أجل التحسين، كما نبه إلى الأثر الاستشرافي لهذه النظرة المركبة الذي سيكون له دور إصلاحي، بما يسمح للفرد بتحضير نفسه للمستقبل. واعتبر المتحدث أن هذه العناصر موجودة في النص الأدبي بشكل مشفر لأن الأيديولوجيا في الأدب مادة رمزية ولا تبرز بشكل صريح. واعتمد الدكتور في تقديم مداخلته مداخلة على المادة الروائية للكاتب جمال علي خوجة، حيث تبرز فيها شخصية المثقف الجزائري لما بعد حرب التحرير، الذي يبحث عن موقعه في المجتمع ويلجأ للمادة الدينية في هذا البحث، مشيرا إلى أنه حلّل هذا الجانب من خلال تطبيق مفهوم “النظرة المركبة من عدة شظايا” لاستخراج الآثار لدى القارئ. ونبه المتحدث بأن المادة الأدبية ليست ترفيهية وليست وثيقة تاريخية، وإنما تحمل في لبها أيديولوجيا مشفرة، قد تكون فردية إصلاحية خاصة بالكاتب، أو أيديولوجيا جماعية خاصة بالمجتمع.
سامي .ح