
عبد القادر رابحي
- 1 -
هل يُمكننا التساؤل، في ضوء ما تشي به الأبحاث العلمية الأكثر تعلقًا بمصير الإنسان وبمستقبله، عن إمكانية ما يمكن أن يتركه تحميل الذاكرة البشرية وإمكانية تنزيل محتوياتها السابقة من العقل الإنساني إلى العقل الرقمي -أي نقل كلّ معايشات الإنسان ومكابداته من رأسهِ المُحْكَمَة التشفير ظاهرًا إلى ذاكرة الحاسوب- من أثر دامغ على ثقافات الشعوب وعلى تاريخها وعلى مستقبلها؟ وكيف سيكون مصيرُ هذه الثقافات –في حال تحقّق هذا المشروع بعد تحقّق مشروع زرع الشريحة الإلكترونية في الجسد البشري- عندما تصبح عرضةَ للتحميل وللتنزيل، بِمَا تُخبئه من أسرار وبِمَا تدسّه من مفاجآت، في حاوياتِ معلوماتٍ رقمية؟ ولأي منهج علميّ ستخضع، على غرار ما خضعت له في مرحلة التعرية الكولونيالية المُتزامنة مع الاِكتشافات العلمية والثورة الصناعية الغربية، وهي تتلقى اللقاحات المشكوك في فعاليتها ضدّ المُتحوّر الثقافي مثلما كان الحال في السابق اللقاح ضد الكوليرا والجُدري والبوحمرون؟ وبأيّ تصوّرٍ عارفٍ بحقيقة الواقع الثقافيّ الّذي صنعته الأنظمة السّياسيّة للدويلات المُستعمَرة سابقًا، يمكن للمُثقف الطامح إلى تحقيق اِختراق ثقافيّ في سمك القناعات الفكرية الغربية المُدجّجة بالأسلاك الإيديولوجية المؤنسنة، أن يُواجه ما يمكن أن تتركه إمكانيةُ تحميل الذاكرة الإنسانية في مستوعبات غير بشرية من أثر على قناعاته التقليدية، بِمَا فيها المُنغلقة أو المُحافِظة أو المُتفتحة، بالنظر إلى ما يمكن أن تُتيحه إمكانية الاِشتغال على تاريخية معلوماتها بوصفها معطى رقميٍّا بحتًا بعيدًا عن كلّ محاولة اِستغلال مصلحيّ ظاهر أو خفيّ يتم من خلالها صناعة محتوى على المقاس يخدم غرضًا مُعينًا، أو يُضيف بُعدًا لم يكن موجودًا، أو يمحو حقائق ليس من مصلحة المُستعمِل إخراجها إلى العلن؟ وإلى أي حدّ يمكن التلاعب بالذاكرة لأجل مصلحة سياسية أو ثقافية هدفها أسْطَرة الطارئ أو نزع القداسة عن الثابت أو ترسيخ المُتغير في صيرورة النسق الجاهز بتعمّد تغيير إحداثيات الذاكرة أو تحويل مساراتها أو تزييف صورتها أو اِستبدال مكوناتها الأساسية بمكونات أخرى دخيلة؟
- 2 -
ثلاثة أحداث/ معالم هي من صميم الفعل الكولونيالي الشنيع جديرةٌ بأن تدلّنا بوضوح على خطورة ما يمكن أن تتعرض له الذاكرة الجمعية لأمة من الأُمم على يد مُستعمر حاول أن يمحق فيها أثر الإنسان ويسطو على تاريخه ويطمس ثقافته وهي: نفي الإنسان الجزائري إلى كاليدونيا الجديدة، ووضع جماجمه في متحف باريسيّ، وحرق مكتبة جامعتِه التي تحوي مئات المخطوطات وعشرات الآلاف من الكُتُب.
ثلاثةُ أحداثٍ هي رموزٌ حقيقية تُحيلنا إلى الطريقة التي يتحوّل فيها المُمكن العلمي، بوصفه إنجازًا تنويريًا مُؤثرًا في الواقع الاِجتماعي، إلى أداة تقويض منهجية لكلّ إمكانيةٍ للتحرّر من الأسر الثقافي الّذي تعرضت له الشعوب المُستعمَرَة، ليصبح بذلك عائقًا حقيقيًا في وجه التحديث. كيف يمكن لنا، والحال هذه، أن نتصور العلاقة التي ستربط الذاكرة بالثقافة؟ وإلى أيّ حدّ يمكن لِمَا تعرضّ له المكوّنُ الثقافيّ من محْقٍ أن يُؤثر في صناعة التاريخ أو في توجيه سياقاته إلى وجهات غير التي يريد الوصول إليها؟ وكيف يمكن لمثقف ينتمي إلى شعب عاش هذه الأحداث أن يبني تصوّرًا مُتوازنًا يربط رمزية هذه الأحداث الثلاثة بالراهن الثقافي في نسخته الملحمية المُهيمنة، ويبني على ذلك تصوّره لثقافته ولذاكرته ولتاريخه؟
تطرح هذه الأحداث الثلاثة التي جرت في الجزائر في بداية الاِستعمار وأثناءه وفي نهايته، فكرةً جوهرية في خضم التناسي المُتعمّد للمرجعيات التي تُؤسس للحوار المُتبصر في الراهن الثقافي المأزوم، وتتمثل في ما كان يسعى إليه الاِستعمار من تأسيس ضمني -مُتواتر في سياقاته الزمنية وثابت في ما تحمله أنساقه من عُنف رمزي- لفعل النسيان في مقابل فعل التذكّر، ومن ترسيخٍ لفعل الإبادة في مقابل فعل السيرورة، ومن تقديسٍ «بيرومانيٍّ» لفعل المحو في مقابل فِعل الكتابة. وهو بذلك يسعى إلى تعميم «آمنيزيا» الإنسان المُستعمَر في ما يُشبهُ ما يقترحه مشروع تحميل الذاكرة البشرية اليوم وإفراغ هذا الإنسان من نسْغِه الوجودي ومن محتواه الثقافي لنزع قدرته على المقاومة. ولعله لنفس سبب ترسيخ مبدأ فقدان الذاكرة، يتم اِختيار رموزٍ ثقافيةٍ مُعيّنة لتسييد فكرة من الأفكار أو مرحلة من المراحل أو شخصيّة من الشخصيات، لتُمثّل رؤية سياسية أو إيديولوجية معيّنة في ما تصبو إلى الوصول إليه من أهداف، مع التحايل المفهومي على ما يمكن أن تُمثّله ردّةُ فِعل التصوّرات الثّقافيّة المُتعالية للمثقفين الكولونياليين وهي تُلاحظ إمكانية التلاعب بمحتوى الذاكرة لأجل صناعة تاريخ مُتعجّل يخدم أغراضاً طارئة ذات طرْح إمبريالي أو ذات رؤية دوغمائية من دون أن يدرج هؤلاء المثقفون خطورة فِعل المحق ضمن الاِشتغال الفكري أو الفلسفي أو الأنتروبولوجي الّذي طالما أصروا على أهميته في أعمالهم المرجعية السابقة أو اللاحقة؟
هل يمكن لهيرودوت، أبو الرواية التّاريخية المُتحيّزة، أو لاِبن خلدون، صاحب نظرية العمران والخراب، أن يرْكَنا معًا، على الرغم من عدم تلاقيهما المبدئي، إلى ما تُحيل إليه الذاكرة المُفْرغة من محتواها بِمَا يتركُه فيها الفاعل العلمي المُستجد ومُتحوّراتُه الثّقافية من أثرٍ بالغ في صناعة أساطير جديدة ومُقنَّعة وقابلة للتداول في خضم المعركة المصيرية التي لا يزال يخوضها الإنسان المحض مع أعدائه الطبيعيين: الجهل والمرض والأمية والتخلف والاِستبداد؟
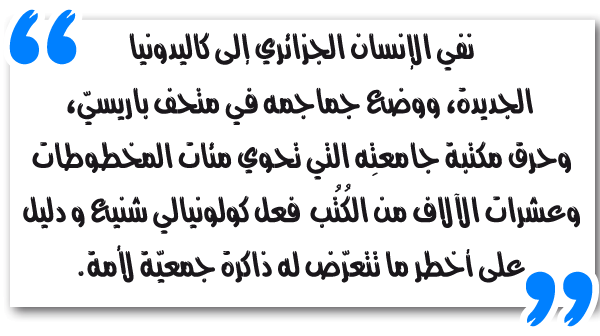
وهل ستستمر عملية النّفي والحرق والتعميد المُحتفى به كديانة جديدة ووجه آخر لتحقيق الإخضاع في صورته الثّقافية، لأجل توكيد «أمنيزيا الفقدان» في الواقع الثقافي للشعوب المُستعمَرة ثقافيًا وللتلاعب بمصيرها، بِمَا يمكن أن يُوفره العِلم بوصفه مرتكزًا للحداثة ومُحقِّقا لتطبيقاتها على أرض الواقع وسلاحًا لإحكام قبضة الهيمنة، لكي تزداد الثقافة المُهيمِنة في غيّها العقلاني بالعبث بالثقافة المُهَيمَن عليها من خلال تحويل الذاكرة الثقافية للشعوب المُستعمرة ثقافيًا من مواطنها الأصلية إلى الأقاصي المقطوعة عن التواتر الثقافي كما هو الحال بالنسبة لنفي الجزائريين إلى كاليدونيا الجديدة، أو إلى تعميدها في المُتحف الباريسي كما هو الحال بالنسبة لجماجم الشهداء الجزائريين، أو إلى المحو النهائي للأثر اللامادّي من رفوف الذاكرة الثقافية الجزائرية كما هو الحال بالنسبة لحرق مكتبة جامعة الجزائر.
ما الجدوى إذن من حجز مكان لائق للإنسانِ المُستعمَر ثقافيًا في المتحف الاِفتراضي للموقع الإنساني المُعَوْلَم لتتفرج عليه مخلوقات النسخةُ الجديدة من الاِستشراق الرقمي وهو يتضوّر من شدّة حضور التاريخ داخل فضاءات أكثر حداثة مِمَّا كانت عليه المتاحف الاِستعمارية القديمة وهي تضع تاريخ الإنسان المُستعْمَر وجماجمه المنهكة من شدّة المعاناة والتمرّد في حاوياتٍ شفّافة بالقرب من حاويات الخنافس والأفاعي والخفافيش والجرذان المحنّطة وبعضٍ من فراشات مجّففة ذات ألوان زاهية تُذكّر المتفرّج الغربيّ ببشاعة الإنسان المُستعمَر وبجمال الأمكنة التي لا يستحق أن يعيش فيها! ومتى يتوقف ديوجين الكلبي عن الترويج للفلسفة العمَلية في الوقت الّذي يدّعي فيه البحثَ بحكمةٍ عن الإنسان الحرّ تحت ضوء مصباحٍ مشحون بزيت النفط العربي؟
- 3 -
كيف يمكن للفكر الإنساني الحامل لقيم الحرية والتطور والتحديث، ناهيك عن قيم التسامح والعيش المشترك، بكلّ ما يمكن أن تحمله تنظيراته الفلسفية وتنويعاته الجمالية في الفكر والأدب والفن والثقافة، أن يقبل بأن تُوضع جماجمُ رجال رفضوا شرطهم الوجودي وثاروا ضد المستعمر الفرنسي، فَقُتِلوا ومُثّل بأجساد الكثير منهم ومُحِقَت حقيقةُ اِستشهادهم ونُقِلت أجسادُ آخرين منهم إلى «الميتروبول» ليُعرَضَ بعضُها في ما كان يُمثّل بالنسبة لفرنسا أوْجَ التحضّر والتقدم وهو المعرض العالمي (L’exposition universelle)، ثم تُودع جماجمُهم تحت أرقام مُشفّرة تدلّ على أسمائهم وقصص اِستشهادهم المؤرشفة، مثلهم مثل جماجم الحيوانات النادرة وعظام الديناصورات المنقرضة في متحفٍ هو رمز للحفاظ على الذاكرة واستعادة التاريخ، في باريس، عاصمة الأنوار، ليتفرّج عليها الإنسان الغربي المتعلم وهو في كامل أناقته التنويرية، وليشهد بعظمة ما يمثله المحق الكولونيالي المبنيّ على تقويض ذاكرة الإنسان الثقافية والحضارية من خلال تقديمه في الصورة الأشدّ وحشيةً والأكثر بشاعة؟
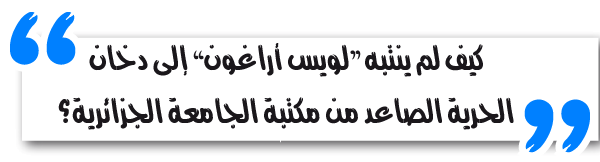
هل كانت فرنسا التنوير والحداثة والقيم الإنسانية المصكوكة بشعارات الحرية والعدالة والمواساة على عِلم بما يجري؟ وهل كان مثقفو فرنسا المبجّلون -مالئوا الدنيا وشاغلو النّاس، من رامبو إلى هيجو إلى فولتير-، يعرفون ما كان يفعل جنودُهم، في الجزائر وفي غيرها من المستعمرات، من جرائم بشعة في حق شعوب المصيف الكولونيالي المُمتدّ عبر القارات الخمس؟ وكيف لجُلّ فلاسفة فرنسا وأدبائها الكبار، بكلّ توجهاتهم الفكرية وقناعاتهم الإيديولوجية ومناهجهم الباحثة في ما يحسبُه ممثلو التنوير اليوم في الدول المستعمَرَة سابقًا رموزًا للحرية والحداثة والتطوّر نماذجَ غربيةً للاِقتداء بطريق خروج الشرق من التخلّف، ألاّ ينتبهوا لبشاعة الفِعل الإنساني المُتمثل في وضع جماجم لمجاهدين مدافعين عن أوطانهم في مزاد العين الرائية لكلّ عابري التاريخ وشُذّاذ آفاقِه المنتشين بالاِنتصارات الوهمية؟
وكيف يمكن أن نتفهم اِتهام «إميل زولا» الشهير على أنه تحقيقٌ متفرّد للشجاعة الفكرية الطامحة للدفاع عن المظلومين من خلال تخليص الضابط «دريفوس» من ظلم عدالة المؤسسات الرسمية، ولا نسمع الاِتهام نفسه من مثقفين فرنسيين آخرين لتخليص المجاهد «أحمد زبانا» من حبل المشنقة الكولونيالية؟ وكيف يصبح الاِتهام حجية ذات اِتجاه واحد في يد المثقفين المتعجلين من دون أن يتم تعميم حمولته التنويرية على حقول الظل المتروكة للنهش الانتروبولوجي؟ ولماذا يصبح هذا الاِتهام بالذات تعلّة ترجيحية مُملّة عند العديد من المثقفين في المجتمعات المستعمرَة ثقافيًا يرفعونها في وجه الواقع المُتردي للمُمارسة الفكرية في العالم المُتخلف، في حين لا يرفعونها في وجه المُمارسات الفكرية والفلسفية للعالم المُتحضر التي تتغاضى عمّا جرى ويجري في فلسطين من جرائم ضد الإنسانية لا يمكن تصنيفها إلاّ خارج تصنيف سلّم البشاعة؟
كيف لم ينتبه «لويس أراغون» إلى دخان الحرية الصاعد من مكتبة الجامعة الجزائرية وهو الّذي كان قال: «إذا كنت قد كتبتُ كثيرًا، فلأنّني قرأتُ كثيرا» ! وهل ثمّة من صورة سيميائية جارحة لهذه الجماجم هيَ مِنَ التخفّي في عمق السردية الكولونيالية بحيث لم يتفطن إليها كورتاس وغريماس ورواد مدرسة باريس وهم ‘يتشيّخون’ في التنظير للسيميائيات السردية على مسامع العديد من تلاميذ العالم السفلي المبهورين بالاِستماع إلى الدرس المنهجي باِهتمام وشغف كبيرين؟ وهل كان ينقصها التدليل على صدق النظرية بما لا تزال تحمله صورةُ الجماجم من نزيفٍ متواصلٍ نابعٍ من عمق السردية الكولونيالية وهي تتلذذ بالتعذيب البَعْديّ لذاكرة أجساد الشعوب المستعمَرَة وعظام جماجمها المليئة بالشغور الإنساني الموحِش؟ وهل يمكن لفيلسوف مثل كلود ليفي سْتراوس الّذي وجد الوقت ووافِرَ القراءة والتأمل للتجوّل في أدغال غابات الأمازون للتدليل على أهمية ثقافة (النيّئ والطازج) في الدعوة إلى الحفاظ على ذاكرة إنسان الأمازون من الاِندثار، ألاَّ ينتبه إلى مضمرات البنيات الأنتروبولوجية لـ(الفكر الغربي المتوحش) فيما تحويه متاحفُ باريس، غير البعيدة عن مدرّجات جامعاتٍ ومعاهدَ كان يُحاضر فيها، من تناقضات بنيوية تُخفي نزقًا ثقافيّا يقوّض سلطة ما تحمله رمزيةُ مأساة جماجم الشهداء الجزائريين -التي تدخل في مجال ما يمكن عرضُه ولا يمكن مضْغُه- وهي ترزح تحت نيْر الاِستعمار الثقافي، وكذا في ما تعجّ به كتاباتُ مثقفيها الكبار من مُسبقاتٍ جاهزة لا تنفكّ تنظر إلى ثقافة الآخر بتعالٍ معرفيٍّ وباِستهزاء تاريخيّ، وهي التصورات نفسها التي طالما دعا إلى اِحترامها في كتاباته؟
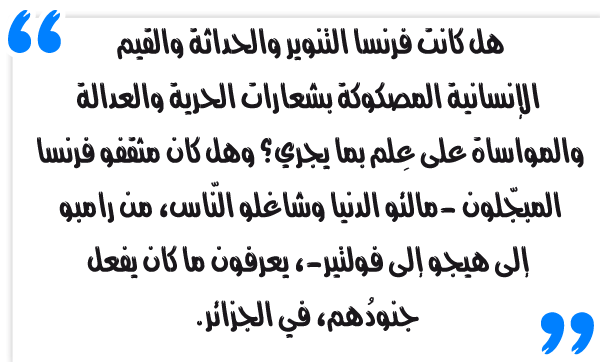
وهل كان لمشيال فوكو أن يُراجع عنعنة جينيالوجيا الخطابات السلطوية في ما تحمله (حفرياتُ المعرفة) الكولونيالية من تسيُّدٍ وهيمنةٍ على الخصوصيات الثقافية للشعوب المستعمَرة، ويستذكر، بناءً على نتائج اِشتغاله الأكاديمي الصارم، بعضَ ما مرّ عليه من فضائحَ في ما كان قد عايشه في مرحلته التونسية، لعله يستعيد الوعي بخطورة جريمة إجبار الإنسان المستعمَر على التّعري تحت سلطة الريشة في لوحات الاِستشراق الفني، أو تحت سلطة الاِستنطاق العسكري في مخافر القوّات الخاصة، أو تحت سلطة الاِغتصاب القسْري بالتسخير والإغراء والإرغام؟ وكيف يمكن لفيلسوفِ الاِختلاف جاك دريدا، وليد الجزائر والشّاهد العابر الّذي يبدو أنه لم ير شيئا من مآسي شعبها، ألاَّ يحرص على اِحترام صوت الآخر ويُشير إلى تناقضات الثقافة الأوربية المتخمة بالمدّ العنصري فيما كانت تكدّسه الثقافة الفرنسية خاصّةً في كتاباتها وفي متاحفها من أدلّة إجرامٍ ثقافيّ بشعة في حق الذاكرة الجزائرية والتاريخ الجزائري وفي حقّ ثقافات جميع الشعوب المستعمرة؟ وكيف له ألاّ يرفع عندئذٍ كلَّ هذه المقولات الثقافية المليئة بالتناقضات في نظرتها للآخر المختلف دليلاً وحجّةً وهو يُجهِد العقل في التنظير (للكتابة والاِختلاف)؟ وكيف يمكن لألبير كامو، صاحب رواية (الغريب)، وليد الجزائر هو كذلك، والمفتون الأبدي بشواطئها وبزرقة سمائها، ألاّ يُصيخ بنظَرِهِ مرّةً واحدةً إلى الأرض ليُلاحظ مأساةَ الإنسان الجزائري المقتول جسديًا وثقافيًا والمطروح جثّةً هامدةً على الشاطئ المُمتد في أغلفة روايته الموّزعة بملايين النسخ والقابلة للتحميل مجانًا لتمكين مثقفي الهامش مزدوجي الهوية من تكملة الحُلم الكاموي والفوز بجوائز لا ترقى إلى جائزته النوبليّة.
وهلْ كانَ لكِتابِ جون بول سارتر(عارُنا في الجزائر) أن يخفي كلّ هذه المأساة الاِستعمارية المغلّفةِ بما حملته ثقافة المستعمر الفرنسي من ذرائعيةٍ ليس أخطرَ ما فيها تبريرُ الأطروحات الثقافية الجاهزة التي تتبنّى أكاذيب تحديث الشعوب المستعمَرةَ وتطويرها، والمشُوبةِ بآثارِ مِسْطرةِ تزييفِ التاريخ وتغيير الذاكرة، وأن يمحوَ بعضًا من بشاعةِ التصورات الثقافية التي طالما رماها المثقفون الكولونياليون طوقَ نجدةٍ وقاربَ نجاةٍ في أعناق مثقفي الشعوب المستعمَرَة الغارقة في لًجَجٍ من الجهل والمرض والتخلّف؟ وهل كان الجنرال أوزاريس هو وحده المسؤول عن كلّ هذه المآسي لكثرة ما كان ينظر إلى ضحاياه بعين واحدة؟
- 4 -
لقد حرص الدرس الأنتروبولوجي الغربي خلال فترة الاِستعمار على ترسيخ سردية الاِستعلاء الثقافي، بِمَا مكّنتْهُ به تصوراتُه النظرية ومُسنداتُها العملية، من أجل توطين القيم الثّقافيّة الاِستعمارية داخل النسق الثقافي لِمَا كان ولا يزالُ يسمّيه بالثقافات المحلية للشعوب المستعمرة سابقًا. كما لعب هذا الدرس، في فترة ما بعد الاِستعمار، دورَ ترسيخ القيم الثّقافية الكولونيالية لأجل صناعة محتوى ذاكرةٍ على المقاس ليتلاءم مع أطروحات الهيمنة الثّقافية التي تُناسب متغيراتِ مرحلةِ ما بعد اِستعمار الأراضي، ويُعيد، من ثمة، كتابةَ تاريخٍ ما بعد كولونياليٍّ للدول المستعمَرَة سابقًا، لا يخرج، في جميع اِحتمالاته المُهادِنة منها والثورية، عن دائرة الأُفق الاِستعماري الحريص على إِحْكامِ القبضة الثّقافية على الأجيال الجديدة من أبناء شعوب هذه الدول، وذلك عن طريق ترسيخ لغة المستعمِر في صلب المحتوى الثقافي الّذي تحلم به تطلّعاتُ الأجيال الجديدة من خلال توطيد المُمارسة الألسنية، وريثة الاِستعمار، داخل النسق الألسني الطبيعي وتحويلها، مع الوقت، إلى جزءٍ لا يتجزأ من الذاكرة الجمعية للشعوب وصفحة أخرى من تاريخها الحديث، وذلك كلّه تحت غطاء المُمارسة العقلانية للقيم الفلسفية المُعولمة وللثقافة في بُعدها الكوني المتسم بالتسامح والاِنفتاح والعيش المشترك، لتخلق المبرر المنطقي للأجيال الجديدة من المثقفين في المجتمعات المستعمَرة ثقافيًا بتبنّي مبادئ الدفاع عن التعدّديّة اللغوية وترسيم جوائز أدبية وإبداعية كفيلة بضمان اِستمرار الفاعل العلمي المستجد ومتحوّراته الثقافية في ترسيخ المحمولات الثقافية والألسنية الفرنسية داخل الوعي الجمعي للأجيال الجديدة بعد توطينها من طرف الاِستعمار التقليدي على حساب ما تتعرض له الثقافة الوطنية ولُغاتها المنسية من محو وتغييب نسيان واِزدراء.
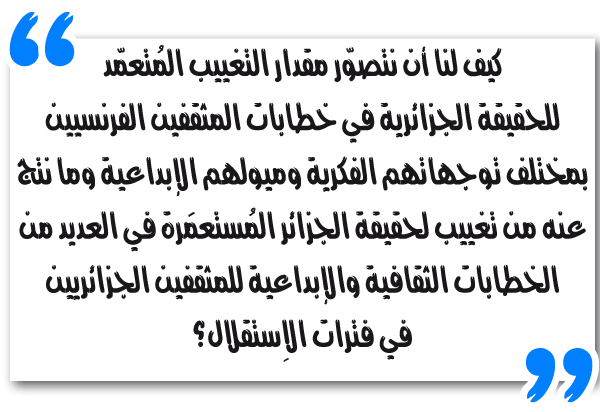
هل من زيف معرفيّ إذن أخطر من التزييف المُتعمد لحقائق التاريخ؟ وهل من ذرائعيةٍ أحدّ في تأثيرها في التلاعب بإحداثيات المساقات الحضارية لأمة من الأُمم أو لشعبٍ من الشعوب من خلال تعمّد أسْطَرَة العابر المُتحوّل ونزع القداسة عن الثابت المُتجذّر؟ وكيف لنا أن نتصوّر مقدار التغييب المُتعمّد للحقيقة الجزائرية في خطابات المثقفين الفرنسيين بمختلف توجهاتهم الفكرية وميولهم الإبداعية وما نتج عنه من تغييب لحقيقة الجزائر المُستعمَرة في العديد من الخطابات الثقافية والإبداعية للمثقفين الجزائريين في فترات الاِستقلال؟ ولماذا تحوّلت الذاكرة من مشروع إسمنت موحِّد للثقافة الوطنية بمختلف خصائصها الثقافية واللغوية إلى عنصر مفرّق لهذه التصورات وداعمٍ لجلب الأداة الكولونيالية الأكثر سطوةً من بين كلّ الكولونياليات إلى راهن الثقافة الجزائرية وجعْلِها عنصرا مفارقًا في حضوره المُتعالي ومُحَكِّمًا لخلافاتِ المثقفين حول الهوية والتاريخ والمصير؟ وهل المُثقف ما بعد الكولونيالي تلميذ غبيّ لا يمكنه أن يفهم الدرس بصورة نهائية تمكّنه من إحداث قطيعة معرفية مع جذور التسرّب الثقافي الكولونيالي في عُمق أنساق الثقافة الجزائرية ليتمكن بعدها من النظر إلى العالم بعيون مُتحرّرة من عوالق المحق الثقافي الكولونيالي، ومن بؤس المشاريع الفكرية والفلسفية النظرية، ومن مُحددات الإكراهات السياسية الضاغطة؟ ولماذا تُبادر التصورات الثقافية الفرنسية إلى القبول بتسليم خرائط الطريق الألسنية والتربوية بحجة تطوير التعليم وتجديد برامجه من خلال تنقيحها من القيم المتأصلة في الموروث الثقافي والحضاري الجزائري، ونجدها تضع كلّ العراقيل السياسية والتاريخية في وجه تسليم الخرائط الدقيقة للأمكنة المُشعّة باليورانيوم جرّاء التفجيرات الناتجة عن عمليات اليربوع الأزرق النووية التي لا تزال آثارها بارزة في أجساد أجيال متعاقبة من الجزائريين إلى يومنا هذا؟
- 5 -
لم تكن فكرة صناعة المحتوى مجرّد فكرة عابرة تجُول في رأس مثقّف عمليّ لم يضيّع وقتًا طويلاً في التعمق في المقولات النظرية لنيل الشهادات من الجامعات الكُبرى. لقد تحوّل المحتوى من رؤية شبقية عالقة ببنات أفكار الفلاسفة المُنشغلين بالنظر إلى عين القمر الزرقاء وما تحويه من طفح إنسانيّ معولم، إلى مكاتب شركات «السْتارتْ آب» (Start-up) في ما ترمز إليه «السيليكون فالي»(Silicon Valley) من حيوية إنتاجية تدفع بالمعنى الفلسفي إلى تخوم ما يمكن أن يحمله المتحوّل الثقافي العابر للأوطان من ممكناتِ تغييرٍ في البنيات العميقة للثقافات الأكثر تحصينًا والأشد اِنغلاقًا، ولم يعد هناك مِن إمكانيةٍ للنظر إلى الذاكرة بوصفها مستودعًا آمنًا للأسرار في ظل ما يمكن أن تُمثله الثورة الرقمية من إمكانات تغيير رهيبة في الأُسس التي بُنيت عليها فكرة الثقافة وعلاقتها بالذاكرة الجمعية للشعوب. كما لم تعد هناك فرص كثيرة للحديث عمّا كانت تصرّ عليه الخطاباتُ الثقافية المناضلة لمثقفي ما بعد الكولونيالية من إمكانية تحصين الثغور الثقافية مِمّا كانت تتعرض له من اِختراقات منهجية نتيجة عدم اِكتراث النخب المثقفة في البلاد المستعمرة سابقًا بفكرة الأمن الثقافي وما تتطلبه من تأكيد على تحصين الذاكرة الثقافية للشعوب من خطورة ترك كل الأبواب مُشْرعَةً في وجه صناعة محتوى ثقافيّ جديد تصبح فيه العناصر الدخيلة جزءًا لا يتجزأ من الثقافات الأصلية للشعوب بدعوى ما يحمله المدّ العولمي من تشتيت لثقافات الشعوب الضعيفة سياسيًا واقتصاديًا، ومن ذوبان في السائل الثقافي المُعولم من دون ضمان الحدّ الأساسيّ الأدنى الّذي يُمَكِّن هذه الشعوب من الحفاظ على نسْغها الثقافي المكوّن لذاكرتها الجمعية في ظل اِنمحاء الحدود الثقافية بين الدول وتلاشي الهويات والخصوصيات المقاوِمة في مُجَمّع الخِيار الثقافي الغربي المُتمركز، ويجعلها تستفيد، بذلك، من المشترك الثقافي الّذي تُنتجه ثقافات العالم ككلّ من دون فرض تصورات إيديولوجية أو الاِتكاء على بلاغات ألسنية تنتهي عادةً بخسارتين فادحتين: عدم القدرة على تقليد ما هو أصيل في مشية الآخر، وتضييع ما هو أصيل في مشية الذات.
- 6 -
هل كلّ دفاعٍ عن الذات هو اِنغلاقٌ يؤدي بها إلى الموت الحتميّ؟ وهل كلّ مُنافحة تروم الاِحتفاظ بحق المُشاركة في صناعة التصور العام للثقافة الكونية هو اِنكفاء على الرُؤى الهوياتية المأزومة؟ وهل كلّ محاولة لاِستعادة لسان الحال هي تنكرّ للمشترك الثقافي والحضاري العام ونقضٌ للعهد المقطوع مع الحداثة والتنوير والتطوّر؟ وهل يمكننا أن ننتظر مِمَّن يسعى إلى ترسيخ لغته وثقافتها في مجالنا الجغرافي أن يُدافع عن ثقافتنا ولغتنا وهما في عقر دارهما؟ وهل الأطروحات الثقافية التي تتبنى التحديث والتنوير والتطوير وكأنها ملكية خاصة بها لوحدها، هي أطروحات مُخَطِّئَة إلى هذه الدرجة بِمَا تُحاول الإصرار عليه من أن كلّ دفاع عن الذات هو اِنكفاء ونكوصٌ أمام التاريخ، وأنّ كلّ رجوع إلى الذاكرة أو محاولة لاِستعادتها هو اِنغلاقٌ واِنتكاسٌ وتأزّمٌ، وأنّ كلّ محاولة تأصيلٍ للثقافة الوطنية ولتاريخها هو تراجعٌ وتخلّفٌ يخفيان عنفًا دفينًا لا يمكن من خلاله تحقيقُ مقدارٍ قليلٍ من مُمكناتِ التفاهم حول الأهداف وقواعد التأسيس العقلاني الهادئ على الثوابت المشتركة؟ وهل الحداثة خيانةٌ أصلاً؟ وهل المثقفون الحداثيون هم الفرقة الناجية من جحيم التخلّف؟ ولماذا تحولت الحداثة -بِمَا راكمته عليها الأجيال الجديدة من المثقفين في المجتمعات المستعمرة ثقافيًا من تصورات نظرية منفصلة عن الواقع الاِجتماعي الّذي يعيشون فيه- إلى جدار نظريّ عملاق يقف حاجزًا في وجه كلّ أُفق للتوقع ويعوق كلّ محاولة للتحديث تسعى إلى جمع التصورات المشتركة بين ما يراه التحديثيون تحديثًا وبين ما يراه التأصيليّون تأصيلاً للخروج من متاهة الاِنغلاق على المفاهيم المتمركزة للتحديث والتأصيل بعيدًا عمّا تعودت عليه النخب الثقافية من اِصطفاف وتخندق وتكوْثُرٌ داخل المحميات الإيديولوجية المعتزّة بِمَا تعتقد أنّه الطريق الوحيد لخلاص الشعوب المستعمرة من الهيمنة الثقافية؟ وهل سيصبح هذا الأمر، لو كان كذلك فعلاً، طريقًا سريعة معبّدة لرجوع الحضارة الغربية نفسها إلى عصر الظلامية المشبعة بالمحدّدات القروسطية التي سبق لها أن عاشتها وجربت تبعاتها التاريخية والحضارية.
- 7 -
ليس ثمة من شكّ في أنّ الاِعتراف بعالمية الثقافة في ظل ما يُوفره الفعل التواصلي من سرعة الاِرتباط بالمنتوج الثقافي حتى قبل اِكتماله، وربّما المُشاركة الاِفتراضية في صناعته وتطويره، هو أمرٌ حتمي وضرورة حضارية لا يختلف فيهما اِثنان. كما أنّه من غير المُمكن أن نتصور إمكانيةَ اِنغلاق الذات على نفسها وعلى الهوية وعلى المرجعيات بالصورة وبالطريقة اللتين تصوّرهما بها الأطروحات المنجذبة نحو الاِنفتاح الكُلي على الخيارات الثقافية المهيمنَة، إذ لا يمكن، عندئذ، تصوّر طريقة مُثلى تكون محلَّ إجماعٍ ووثيقةَ اِتفاق لحماية الذات من الذوبان النهائي في السائل الثقافي المُعولم بدعوى الخروج من أزمات الهوية والدين والتاريخ. كما لا يمكننا تصوّر التخلي الكلّي للثقافة الغربية المهيمنة عن الأُسس والدعائم والمرجعيات التي جعلت منها ثقافة مهيمِنة بكل هذه البساطة التي يُريد بها بعض مثقفي المجتمعات المستعمرة سابقًا التخلي عن ثقافة مجتمعاتهم لأنّها تُشكل عائقًا أمام تحديث هذه المجتمعات.سيكون من غير المنطقيّ وغير المعقول، بالنسبة للمُثقف الفرنسي الّذي ينظر إلى العالم من عين الثور المُتعالية في القصور المعرفية المهيمِنة، أن يتم التخلّي عن اللّغة الفرنسية لحساب لغة أخرى حتى ولو كانت شقيقة كالإنجليزية مثلاً بدعوى قوة نفوذها العلمي وشساعة اِنتشارها. سيكون الأمر عندئذ من الخطورة بحيث يصبح التخلّي عن اللّغة الفرنسية تهديدًا للكيان الثقافي الفرنسي وتحييدًا لعناصرِ قوته الناعمة التي طالما تغنّى بها ودعَمها المثقفون الفرنسيون. وستتحوّل اللّغة الفرنسية، في هذه الحالة، إلى خط أحمر لا يمكن تجاوزه نظرًا لِمَا تُمثله اللّغة الفرنسية من رمزية للخصوصية الثقافية وللتاريخ الفرنسي، ولِمَا تحفظه الذاكرة الجمعية للأمة الفرنسية من مُمكنات حياةٍ لا يمكنها أن تستمر إلاّ باللّغة الفرنسية ومن خلالها وليس بغيرها ومن خلال غيرها. وهي ستتوقف عن الحياة، لا محالة، بتوقفها نظرًا لِمَا مثّلته ولا تزال تُمثله من أداة هيمنة وسلاح فعَّال في يد ساستها ومثقفيها لترسيخ التوسع الإمبريالي للكولونيالية الفرنسية، وكذلك نظرًا لِمَا ترمز إليه من تأثير وقوّة اِختراق الثقافة الفرنسية للمجالات الثقافية ضعيفة المناعة بِمَا يُنتجه مثقفوها من إبداعات في مُختلف التخصصات.
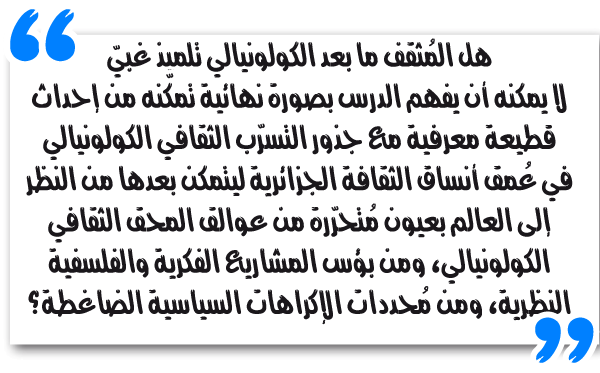
كيف لنا إذن أن نقبل بالتصوّر الإمبريالي الغربي الحريص على حماية ثقافته ولغته وتدعيمهما وتشجيعهما لحماية الذاكرة والتاريخ الفرنسيين، ولا نقبل بمن يُدافع عن وجهة النظر نفسها عندما يتعلّق الأمر بدفاع الجزائريين عن ثقافتهم وعن تاريخهم وعن لغتهم؟ وهل هذا معقول ومنطقيٌّ أصلاً؟ وهل هذا يعني أنك عندما تُدافع عن لغتك وثقافتك أنت، ستصبح ضد الثقافات واللُغات الأخرى بالضرورة؟ وكيف يمكن أن نتصوّر قبول اِستضافة ثقافة أخرى بِمَا يفرضه أساس الاِنفتاح على ثقافات العالم في عصر الثورة الرقمية، ولا يكون هذا القبول إلاّ على حساب ثقافتك ولغتك؟ وهل هذا الشرط كفيلٌ لوحده بتحقيق التطوّر والخروج، من ثمة، من التخلف والاِنغلاق والاِنتصار على الأنظمة الدكتاتورية التي تتغذى من ترسيخ الاِزدواجيات المُتصارعة والرُؤى المُتناقضة التي أنتجتها النخب المُثقفة في المجتمعات المستعمرة سابقًا، بِمَا اِنتهت إليه من تحوّل إلى تصوّر نافذ في عمق الواقع الثقافي الّذي لا يزعج النخب السياسية التي تعودت على البقاء في السلطة لأجل البقاء في السلطة، وذلك من خلال سعيها المستميت إلى تجديد جِلدها بعد أن تكون عذاباتُ المثقفين المتصارعين حول مشروع المجتمع قد وفرت لها ‹عشبةَ الخلود› لتجديد ثوبها في كلّ مرّة يتحرك التاريخ في اِتجاه نصرة الشعوب الزاحفة نحو تحقيق التحرّر النهائي من عوالق الكولونيالية ومن مضمراتها الثقافية من جهة، ومن التخلص النهائي من الأنظمة السياسية التي لم تستطع تحقيق مشروع حضاري يشترط المشاركة الأصيلة في الفعل العولمي بما تتيحه إمكاناتُه وبِمَا يُوفره عمقُ ثقافته من إضافة العناصر الأكثر أصالة والأكثر اِندراجًا ومشاركةً في نسج ثوب العالم الّذي طالما نقضت غزْله الأطروحاتُ المتصارعة للمثقفين الواقفين عند باب خدر الأميرة.